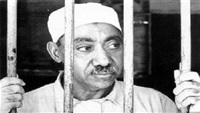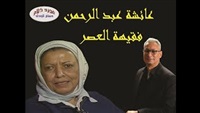داعش و"التجييش العاطفي" للحفاظ على تماسك ما تبقى من التنظيم
الجمعة 03/يناير/2025 - 12:48 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
تعكس افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ الصادرة عن تنظيم داعش واحدة من أكثر السمات تكرارًا في الخطاب الإعلامي للتنظيم: المزج بين الأيديولوجيا الدينية المتشددة والتوظيف السياسي للأحداث الميدانية. يظهر المقال كوثيقة تروج لفكرة "استمرارية الجهاد" كقدر إلهي، وتحاول في الوقت نفسه إثبات قدرة التنظيم على إعادة الانتشار رغم الهزائم المتكررة التي مُني بها خلال السنوات الماضية.
كما يعتمد الخطاب على إعادة إنتاج سردية الانتصار رغم الوقائع الميدانية التي تشير إلى انحسار نفوذ التنظيم وتراجعه. يُلاحظ أن المقال يستغل العاطفة الدينية لمخاطبة عناصر التنظيم والمتعاطفين معه، محاولًا رفع الروح المعنوية عبر التركيز على الهجمات الفردية المحدودة وتصويرها كإنجازات استراتيجية ضخمة. هذا الخطاب ليس جديدًا؛ إذ يتكرر مع كل مرحلة ضعف أو تراجع، مما يؤكد أن الآلة الإعلامية لداعش لا تزال تعتمد على "التجييش العاطفي" كوسيلة أساسية للحفاظ على تماسك ما تبقى من التنظيم.
البنية الخطابية والرسائل الأساسية
تقوم الافتتاحية على مجموعة من الرسائل الرئيسية:
1. الترويج للأيديولوجية الجهادية العالمية
تحرص افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ على ترسيخ فكرة "الجهاد العالمي" كقيمة دينية عابرة للحدود، وهي فكرة أساسية في أيديولوجيا تنظيم داعش. ينطلق المقال من تأكيد أن "الجهاد" ليس مجرد معركة عسكرية أو رد فعل على سياسات معينة، بل هو "تكليف سماوي" يتجاوز كل الحدود القومية والعرقية، ويخضع فقط لتوجيهات دينية. ويستشهد المقال بسردية دينية توحي بأن استمرار "الجهاد" أمر حتمي وإلهي لا يخضع للتقديرات البشرية. يقول الكاتب: "الجهاد قدر الله تعالى وفريضة من فرائضه وشريعة من شرائعه التي لم تُنسخ ولم تُستبدل، بل هي ماضية باقية ما بقي الصراع بين الإسلام والكفر."
تسعى هذه السردية إلى تحفيز العناصر الموالية للتنظيم من خلال التأكيد على أن كل محاولات وقف "الجهاد" ستبوء بالفشل لأنها تتحدى "إرادة الله". هذا الخطاب يستغل العاطفة الدينية ويغيب العقل النقدي، حيث يتم اختزال الصراعات المعقدة في ثنائية "الإيمان والكفر" دون النظر إلى تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي.
كما يعمد المقال إلى نزع أي سياق جغرافي أو سياسي عن العمليات التي يقوم بها التنظيم، مما يجعل أفعاله تبدو وكأنها جزء من "صراع أزلي" يمتد من صدر الإسلام إلى اليوم. هذا النوع من الخطاب يساعد على تجنيد عناصر من جنسيات مختلفة، إذ يشعر الأفراد بأنهم جزء من "أمة واحدة" لها غاية أسمى تتجاوز الحدود.
2. التسويق للانغماسيين والمهاجرين
تتكرر في الافتتاحية الإشادة بما يسميهم التنظيم "الانغماسيين" و"المهاجرين"، وتبرزهم كأيقونات للتضحية والجهاد العالمي. يستخدم المقال لغة رمزية تُضفي على هؤلاء الأفراد هالة بطولية تتجاوز حدود المنطق والواقع. يصف الكاتب هؤلاء المقاتلين قائلًا: "شنّه ثلةٌ من الانغماسيين المهاجرين وصلوا إلى ولاية الصومال من سبع دول مختلفة، ولكن جمعتهم غاية واحدة هي التوحيد، وسبيل واحد هو الجهاد."
يعكس هذا الوصف محاولة متعمدة لإبراز فكرة "الهجرة في سبيل الله"، حيث يسعى المقال إلى تصوير هؤلاء الأفراد كأبطال تجاوزوا الحدود والسدود، وواجهوا كل العقبات ليحققوا "النصر" المزعوم. من الواضح أن التنظيم يعتمد على هذه السردية لجذب عناصر جديدة من مختلف الدول، خاصة الشباب الذين يشعرون بالتهميش أو يبحثون عن هوية أو هدف لحياتهم.
3. شيطنة الخصوم
أحد المحاور الأساسية في خطاب تنظيم داعش هو "شيطنة الخصوم"، وهي استراتيجية نفسية وإعلامية تهدف إلى خلق عدو مشترك يبرر استمرار العنف. في الافتتاحية، يُصور التحالف الدولي ضد داعش بـ"الحلف الصليبي"، ويُتهم بأنه يسعى لإفشال "الإسلام الحقيقي". يقول المقال: "تزاحمت تقارير مراكز الاستخبارات الصليبية المموهة، في التحذير من خطر تنامي نشاط الدولة الإسلامية في الصومال."
هذه اللغة التي تعتمد على مصطلحات مثل "الحلف الصليبي" و"المرتدين" ليست جديدة، لكنها فعالة في تعبئة الأتباع وحشد الدعم. فالخطاب هنا لا يقدم تفسيرًا عقلانيًا للأحداث، بل يعتمد على إحياء ذاكرة تاريخية للصراعات بين المسلمين والمسيحيين، مما يساهم في تأجيج الكراهية وتعزيز الشعور بالمظلومية.
إلا أن هذا النهج يتجاهل تمامًا أن التنظيم نفسه ارتكب فظائع ضد المسلمين قبل غيرهم، وأدى إلى دمار مجتمعات بأكملها في العراق وسوريا ومناطق أخرى. فبدلًا من الاعتراف بهذه الجرائم، يُلقي المقال اللوم على "الحلف الصليبي" و"المنافقين"، وكأن التنظيم مجرد ضحية بريئة لمؤامرة عالمية.
4. إعادة إنتاج الانتصارات المزعومة
تحاول الافتتاحية تضخيم الهجمات الفردية المحدودة وتصويرها كإنجازات استراتيجية ضخمة تعكس "قوة الدولة الإسلامية". في مثال هجوم "بونتلاند"، يوصف الهجوم وكأنه ضربة محورية للحكومات المحلية والإقليمية، بل وللتحالف الدولي بأكمله. يقول المقال: "ضربة العام كانت من نصيب قوات حكومة (بونتلاند) المرتدة في الصومال، حيث تعرضت لهجوم مركّب شنّه ثلة من الانغماسيين."
هذه السردية تتجاهل تمامًا حقيقة أن مثل هذه الهجمات، رغم خطورتها، تظل مجرد عمليات متفرقة لا تعكس قوة حقيقية أو قدرة على السيطرة المكانية. فالتنظيم لم يعد قادرًا على إدارة أراضٍ شاسعة كما كان في سنوات ذروته.
التوظيف الديني لتبرير الهزائم والتراجع الميداني
يعد التوظيف الديني لتبرير الهزائم والتراجع الميداني أحد الأساليب المتكررة في الخطاب الإعلامي لتنظيم داعش. في افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ، يظهر هذا التوظيف بوضوح من خلال الربط بين النتائج العسكرية للتنظيم والإرادة الإلهية. فعندما يتعرض التنظيم لانتكاسة أو خسارة منطقة استراتيجية، لا يتم الاعتراف بأخطاء القيادة أو ضعف الاستراتيجية العسكرية، بل يُصور الأمر كـ"اختبار إلهي" أو "ابتلاء" يُمتحن من خلاله إيمان المجاهدين وصبرهم. ويؤكد المقال ذلك بوضوح حين يقول: "إن أماكن وأوقات هذه الضربات السنوية المباركة، ليست من اختيارات المجاهدين بقدر ما هي توفيق وتسديد إلهي ممّن شرع الجهاد سبحانه."
يستغل التنظيم في هذا السياق مشاعر التدين لدى أتباعه، إذ يسعى إلى خلق حالة من "الإيمان القدري" التي تجعل الأفراد يرون كل هزيمة أو خسارة كجزء من "الخطة الإلهية الكبرى". وبذلك، يتم تحييد أي نقاش حول المسؤولية القيادية أو النقد الداخلي، لأن الهزيمة تصبح جزءًا من "الاختبار الرباني" وليس نتيجة لأخطاء تكتيكية أو سوء تقدير. هذا التبرير الديني لا يُستخدم فقط للتخفيف من وطأة الهزائم، بل أيضًا لاستقطاب مزيد من الأنصار عبر تصوير الصبر والثبات في وجه الهزيمة كعمل "إيماني" يُثاب عليه الفرد.
في المقابل، عندما يحقق التنظيم نجاحًا ميدانيًا - مهما كان محدودًا أو رمزيًا - يتم تقديمه على أنه "نصر إلهي" وتوفيق من الله. هذه الازدواجية تجعل التنظيم في موقع "الرابح" في جميع الأحوال: إذا انتصر، فهو مؤيد من الله؛ وإذا هُزم، فهو يُختبر من الله. يقول المقال: "ولو خذله أهل الأرض قاطبة ولو استعانوا بالشياطين على وقفه." هذا الخطاب يحوّل المعارك من صراع عسكري ميداني إلى "معركة إيمانية"، حيث يتم نزع البعد الواقعي والمادي للصراع تمامًا.
المفارقة بين الخطاب والواقع الميداني
يعكس الخطاب الدعائي لتنظيم داعش، كما ورد في افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ، حالة من التناقض الواضح بين ما يروّج له التنظيم من انتصارات وإنجازات ميدانية، وبين الواقع الفعلي على الأرض. ففي الوقت الذي يحاول المقال تسويق هجوم "بونتلاند" في الصومال كدليل على "القدرة المستمرة على التمدد"، يتجاهل الكاتب عمدًا التراجع الكبير للتنظيم في معاقله الرئيسية السابقة في العراق وسوريا، حيث لم يعد يمتلك السيطرة المكانية التي كانت تمكّنه من فرض حكمه وإدارة موارده بشكل فعّال. هذا التباين الصارخ يثير تساؤلات حول مصداقية الدعاية الداعشية وقدرتها على عكس الواقع الميداني بدقة.
إن انتقال التركيز إلى مناطق مثل الصومال والساحل الإفريقي يكشف عن استراتيجية واضحة يتبعها التنظيم في السنوات الأخيرة، وهي استغلال "المناطق الهشة" التي تعاني من فراغ أمني وضعف في بنية الدولة المركزية. يتيح هذا النوع من البيئات للتنظيم فرصة لإعادة ترتيب صفوفه، وتنفيذ هجمات دعائية تساهم في إظهار قدرته على البقاء والتكيف مع الظروف المختلفة. في هذا السياق، يصبح هجوم محدود في منطقة نائية مثل "بونتلاند" حدثًا دعائيًا يُضخّم في وسائل إعلام التنظيم ليبدو وكأنه إنجاز استراتيجي كبير.
يُظهر التركيز على الصومال وغيرها من المناطق البعيدة محاولة واضحة لصرف الأنظار عن الخسائر الكبيرة في مناطق نفوذه السابقة. فبينما يتراجع التنظيم في العراق وسوريا ويتعرض لضربات عسكرية قاسية، يحاول من خلال الإعلام أن يوجّه البوصلة نحو "الجبهات البديلة"، ليحافظ على وهم "استمرارية الجهاد العالمي". لكن هذا التحوّل الجغرافي لا يعدو كونه هروبًا من مواجهة الحقيقة الميدانية المتمثلة في فقدان النفوذ والقدرة على الإدارة الفعلية للأراضي.
التركيز على المقاتلين الأجانب (المهاجرين)
يُبرز المقال في افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ أهمية خاصة للمقاتلين الأجانب أو ما يُطلق عليهم داخل أدبيات التنظيم "المهاجرون". يُصوَّر هؤلاء الأفراد كرموز للتضحية والفداء، وكأبطال عابرين للحدود، تخطوا العقبات الأمنية والجغرافية من أجل "نصرة الدين". هذا الخطاب ليس جديدًا على إعلام داعش، إذ سعى التنظيم منذ ظهوره إلى تعزيز فكرة "الأمة الإسلامية العابرة للحدود" التي تتجاوز الهويات الوطنية والعرقية، ليؤكد أن معركته ليست محلية بل عالمية، تستقطب مقاتلين من مختلف الجنسيات والأعراق.
التركيز على "المهاجرين" في هذه الافتتاحية يأتي في سياق تبرير محدودية حضور التنظيم في مناطق نفوذه السابقة، وتحويل الأنظار إلى بقع جغرافية جديدة مثل الصومال، حيث يمكن توظيف هؤلاء المقاتلين كأداة دعائية. يقول المقال: "وإن هؤلاء المهاجرين قد وصلوا إلى ولاية الصومال من سبع دول مختلفة، ولكن جمعتهم غاية واحدة هي التوحيد وسبيل واحد هو الجهاد." هنا يحاول التنظيم رسم صورة مثالية لعالمية مشروعه، رغم أن الواقع يشير إلى تراجع تدفق المقاتلين الأجانب إلى صفوفه بفعل الضربات الأمنية المحكمة وتضييق مسارات التجنيد والتمويل.
الأمر الأكثر تعقيدًا هو الانقسامات الداخلية داخل التنظيم نفسه. تشير تقارير عديدة إلى وجود خلافات حادة بين القيادات المحلية والمقاتلين الأجانب، خاصة في المناطق التي يواجه فيها التنظيم ضغوطًا عسكرية وأمنية. هؤلاء المقاتلون الأجانب غالبًا ما يشعرون بالتهميش أو يُنظر إليهم كـ"عبء أمني" عندما يزداد الضغط على التنظيم. في هذا السياق، يصبح الحديث عن "أبطال المهاجرين" في إعلام التنظيم مجرد محاولة لإنعاش صورة متهالكة وإعادة إحياء وهم القدرة على جذب الدعم العالمي.
في النهاية، يُعد التركيز على المهاجرين في المقال محاولة واضحة لتغطية نقاط الضعف الهيكلية في التنظيم، واستثمار رمزية هؤلاء الأفراد في تعزيز صورة "التنظيم العالمي" الذي يتجاوز الحدود. إلا أن هذه الرواية الدعائية تتجاهل الحقائق الميدانية، والتي تؤكد أن تنظيم داعش لم يعد يمتلك الشبكات اللوجستية القوية التي تمكّنه من تجنيد واستقطاب مقاتلين أجانب بكفاءة كما كان الحال في ذروة قوته.
الاستخدام المكثف للمظلومية التاريخية
يعتمد المقال الافتتاحي في العدد (476) من صحيفة النبأ على توظيف سردية "المظلومية التاريخية" كأحد الأعمدة الرئيسية في الخطاب الدعائي لتنظيم داعش. تُصور هذه السردية الصراع على أنه حرب عالمية "صليبية" تستهدف الإسلام والمسلمين، وتُصوّر التنظيم على أنه القوة الوحيدة التي تقف في وجه هذه "المؤامرة الكونية". يقول المقال: "إن الجهاد قدر الله تعالى وفريضة من فرائضه وشريعة من شرائعه التي لم تُنسخ ولم تُستبدل، بل هي ماضية باقية ما بقي الصراع بين الإسلام والكفر." هذا الطرح لا يخلو من التحريض والاستعطاف في آنٍ واحد، حيث يسعى إلى استغلال مشاعر الإحباط واليأس لدى بعض الفئات وتوجيهها نحو تبني أيديولوجية التنظيم العنيفة.
تهدف هذه السردية إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول هو إضفاء الشرعية الدينية على أعمال العنف والإرهاب التي يقوم بها التنظيم، والثاني هو استقطاب مجندين جدد من خلال إقناعهم بأنهم جزء من "معركة مقدسة" ضد "قوى عالمية متآمرة". يتعمد المقال تصوير أي عمل عسكري ضد التنظيم على أنه جزء من هذه "المؤامرة"، ويتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن أغلب هذه العمليات العسكرية جاءت كرد فعل على الجرائم الوحشية التي ارتكبها التنظيم ضد المدنيين في العراق وسوريا وأماكن أخرى.
المفارقة أن التنظيم، الذي يدّعي الدفاع عن الإسلام والمسلمين، تسبب بأفعاله في تشويه صورة الإسلام عالميًا وتعميق الأزمات الطائفية والعرقية في البلدان التي نشط فيها. بدلًا من أن يكون "مدافعًا عن الأمة"، كما يدّعي، أصبح سببًا رئيسيًا في تفاقم معاناة المجتمعات المسلمة. لكن المقال الدعائي يتجاهل هذه الحقائق تمامًا، بل يحاول قلبها من خلال تسويق صورة مظلومية زائفة تبرر كل انتهاك وكل جريمة يرتكبها التنظيم.
تناقض السردية الداعشية
تعاني السردية المطروحة في افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ من تناقض جوهري يكشف حالة الضعف التي يعيشها تنظيم داعش حاليًا. فمن جهة، يسعى المقال إلى تصوير بعض العمليات المحدودة، مثل هجوم "بونتلاند"، كإنجازات استراتيجية كبرى تُثبت "قوة التنظيم وحيويته"، ومن جهة أخرى، يتحدث الخطاب عن "توفيق وتسديد إلهي" في تفسير أي نجاح جزئي، ما يعكس غيابًا واضحًا لأي إنجازات ملموسة على المستوى العملياتي أو الاستراتيجي. هذا التناقض ليس مجرد خلل دعائي، بل هو انعكاس دقيق للوضع الميداني المتدهور للتنظيم.
يحاول المقال تجاوز هذا التناقض من خلال توظيف اللغة الدينية والرمزية، فيصور النجاحات المحدودة على أنها جزء من "اختبار إلهي" يُعد التنظيم لمراحل أكثر "عظمة". لكن في الواقع، عندما يضطر التنظيم إلى تضخيم هجمات صغيرة أو هجمات نفذها أفراد محدودون باعتبارها "نصرًا عظيمًا"، فهذا مؤشر واضح على تراجع قدرته على تنفيذ عمليات كبيرة كتلك التي شهدناها في سنوات ذروته. كما أن التركيز المفرط على مهاجمة أهداف سهلة أو مناطق نائية يعكس انكفاء التنظيم على ذاته وفقدانه للقدرة على العمل الميداني المنظم في المناطق ذات الثقل الاستراتيجي.
التناقض يتضح أيضًا في المزج بين تصوير التنظيم كقوة "عالمية ذات نفوذ واسع" وبين تصوير أفراده كـ"ثلة من المؤمنين الصادقين الذين يواجهون تحالفًا عالميًا". فالخطاب ينتقل بشكل متكرر بين هذين النقيضين؛ تارة يتم تصوير داعش كتنظيم عالمي قادر على التأثير وتغيير موازين القوى، وتارة أخرى يتم تصويره كـ"مجموعة قليلة صابرة محتسبة" تواجه قوى هائلة تفوقها في العدد والعدة. هذا التباين لا يمكن تفسيره إلا في سياق محاولة التنظيم التكيف مع واقعه الهش من خلال خطاب مزدوج يستهدف شرائح مختلفة من جمهوره.
في النهاية، يكشف هذا التناقض بين الادعاءات الدعائية والواقع الميداني عن أزمة داخلية عميقة في بنية الخطاب الداعشي. فالتنظيم الذي كان يومًا ما يُروّج لنفسه كـ"دولة" قادرة على إدارة مناطق مترامية الأطراف، أصبح يعتمد على هجمات متفرقة وغير مركزية كدليل على بقائه. هذا التناقض لا يقتصر على الخطاب الإعلامي فقط، بل ينعكس أيضًا على الأداء الميداني للتنظيم، الذي لم يعد قادرًا على تحقيق إنجازات ملموسة تتجاوز العناوين الرنانة التي تُطلقها أذرعه الإعلامية.
الاستخدام السياسي للدين
يعتمد تنظيم داعش في خطابه الدعائي على الاستخدام المكثف للنصوص الدينية وتوظيفها بشكل انتقائي لخدمة أهدافه السياسية والعسكرية. في افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ، يستند المقال إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية لإضفاء شرعية دينية على أفعال التنظيم وعملياته العنيفة. يتم انتقاء النصوص بشكل مجتزأ بعيدًا عن سياقاتها الفقهية والتاريخية، مما يفرغها من معانيها الحقيقية ويعيد تأويلها بما يتناسب مع السردية الداعشية. على سبيل المثال، يستخدم المقال آيات تتحدث عن "الجهاد" و"النصر الإلهي" لتبرير عمليات قتل وتفجير تستهدف مدنيين أو قوات محلية لا علاقة لها بما يدّعيه التنظيم من "جهاد إسلامي مشروع".
هذا التوظيف للنصوص لا يقتصر فقط على التبرير، بل يمتد إلى خلق منظومة فكرية مغلقة تُجبر الأتباع على الطاعة العمياء تحت مظلة "التكليف الإلهي". فعندما يُصوّر التنظيم أفعاله على أنها "قدر إلهي" أو "تسديد سماوي"، فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للنقد أو التشكيك من الداخل. يُقدّم هذا الخطاب رؤية أحادية مطلقة لا تحتمل أي خلاف فقهي أو حتى مناقشة عقلانية، ويجعل من أي خروج عن مسار التنظيم بمثابة "خيانة للدين" أو "ردة". هذه الرؤية تسهّل على قيادة التنظيم إحكام سيطرتها على الأتباع وتوجيههم نحو أهدافها السياسية والعسكرية دون أدنى مقاومة فكرية.
لكن الواقع يُظهر بوضوح التناقض بين النصوص الدينية التي يستشهد بها المقال والممارسات العملية للتنظيم. الإسلام دين يحرّم قتل الأبرياء ويؤكد على حرمة دماء المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في أمان، كما جاء في الحديث الشريف: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة." ومع ذلك، نجد أن داعش ارتكب مجازر بشعة بحق المدنيين، واستهدف المسلمين في المساجد والأسواق، ودمّر البنية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي سيطر عليها. هذا التناقض بين النصوص والممارسات يكشف زيف الشرعية التي يحاول التنظيم ادعاءها، ويؤكد أن الهدف الحقيقي هو تحقيق مكاسب سياسية من خلال التلاعب بالدين.
إن استخدام الدين كأداة لتحقيق أهداف سياسية ليس مجرد انحراف عن المبادئ الإسلامية، بل هو تدمير متعمد لصورة الإسلام في العالم. لقد أسهمت أفعال داعش وخطابه الدعائي في تشويه صورة الإسلام والمسلمين على المستوى العالمي، وربط الدين بالعنف والتطرف. هذا الضرر يمتد ليشمل المجتمعات المسلمة نفسها، التي أصبحت تعاني من تبعات هذا التشويه سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية الداخلية أو على مستوى تعامل العالم الخارجي معها. في نهاية المطاف، يظهر أن الهدف الأساسي من هذا الاستخدام السياسي للدين ليس نشر قيم الإسلام، بل استخدامه كغطاء أيديولوجي يبرر تحقيق مصالح مادية وسياسية للتنظيم وقياداته.
خاتمة: بين الدعاية والواقع
تعكس افتتاحية العدد (476) من صحيفة النبأ نموذجًا واضحًا للدعاية الأيديولوجية التي يتبناها تنظيم داعش، حيث يتم توظيف النصوص الدينية بشكل انتقائي، وتضخيم النجاحات الميدانية المحدودة، مع تجاهل التحديات الكبرى التي تواجه التنظيم. يقدّم المقال صورة مشوهة للواقع، محاولًا إقناع الأتباع والمتعاطفين بأن التنظيم لا يزال قويًا ومؤثرًا، رغم التراجع الميداني الملحوظ وخسارته لمراكز نفوذه الرئيسية في العراق وسوريا.
على الرغم من محاولات التنظيم إعادة تقديم نفسه كحركة جهادية عالمية قادرة على تجاوز الحدود والقيود الأمنية، إلا أن الواقع يشير إلى تقلص قدراته العملياتية وفشله في تحقيق أي سيطرة فعلية طويلة الأمد على الأرض. تُظهر الهجمات المحدودة التي يروّج لها المقال—مثل هجوم "بونتلاند"—أن التنظيم أصبح يعتمد على عمليات خاطفة وغير مستدامة لتعويض الخسائر الفادحة التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.
يتضح أيضًا أن الخطاب الدعائي للتنظيم يفتقر إلى التجديد والتطوير، حيث يعتمد بشكل متكرر على نفس السرديات القديمة القائمة على فكرة "المظلومية التاريخية" و"المؤامرة الصليبية"، مع التركيز على "الانغماسيين" و"المهاجرين" كأبطال أسطوريين. هذا النمط من الخطاب قد ينجح في استقطاب قلة من المؤيدين، لكنه يفشل في مواجهة الحقائق الميدانية التي تعكس تراجع شعبية التنظيم وافتقاده للحاضنة الاجتماعية حتى في المناطق الهشة التي يحاول التمركز فيها.
في نهاية المطاف، يبقى تنظيم داعش عالقًا في أزمته البنيوية التي تتجلى في التناقض بين خطابه الدعائي وواقعه الميداني. ورغم محاولاته المستمرة للتكيف مع المتغيرات والبحث عن ملاذات جديدة، إلا أن هذه المحاولات لا تتعدى كونها محاولات يائسة لإطالة أمد وجوده. إن استمرار التنظيم مرهون بقدرته على تجديد استراتيجيته، لكن شواهد الواقع تؤكد أن التنظيم بات يعاني من أزمة عميقة، وأن خطابه الأيديولوجي لن يتمكن من إخفاء هذا التآكل طويلًا.