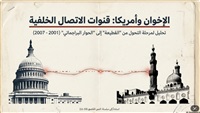منتصر حمادة وكتابه.. "الوهابية في المغرب"
الثلاثاء 21/يوليو/2015 - 04:17 م
طباعة
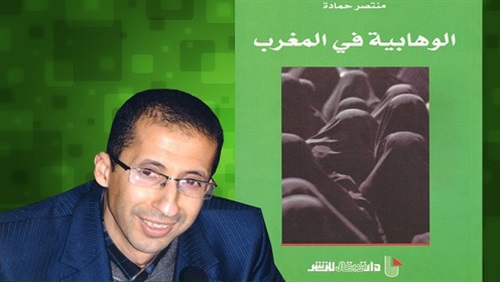
اسم الكتاب: الوهابية في المغرب
المؤلف: حمادة منتصر
دار النشر: دار توبقال للنشر 2012
المؤلف: حمادة منتصر
دار النشر: دار توبقال للنشر 2012
الصحفي والكاتب منتصر حمادة له كتاباته المتعددة والغزيرة حول ماهية البحث في موضوع الخطاب الديني سواء المتعلقة بالمغرب أو المشرق.. وذلك باستخدامه لآليات علمية رصينة يقصد منها تتبع الظاهرة الجديدة للإسلام السياسي أو ما يصطلح عليه بالإسلام الاحتجاجي أو العنيف، بمختلف أنماطه وإشكالياته الأيديولوجية والبنيوية.
ومن بين تلك الأبحاث والدراسات كتاب له بعنوان 'الوهابية في المغرب'، وقد صدر عن دار توبقال للنشر الطبعة الأولى سنة 2012، وهو من الحجم المتوسط، ويتكون الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب وفهرست للمراجع؛ حيث يسهب الكاتب في الحديث عن تاريخ الوهابية في المشرق والمغرب وبداية انتشارها في المغرب المعاصر وأصولها وتطورها، فضلًا عن التحولات التي طرأت على الخطاب التي تتبناه.

الصحفي والكاتب منتصر حمادة
واعتبر المؤلف في تمهيد الكتاب أن الفصل الرابع من الكتاب وهو تحت عنوان خلاصات أوليّة حول مستقبل السلفية الوهابية بالمغرب. عبارة عن مُساهمة نظرية وتطبيقية في تسليط الأضواء على مقدمات وتبعات صعود نجم "السلفية الوهابية" في المنطقة العربية، من خلال الاشتغال تحديدا على المجال التداولي المغربي؛ بعد أن أصبح التعامل النظري والتطبيقي مع التيار أقرب إلى الاقتراب من "فوبيا السلفية"، دفعت بالبعض لترويج خطاب الشيطنة والتدنيس مقابل ترويج البعض الآخر لخطاب التقديس والتبجيل؛ مؤكدًا أن كلا الخطابين لا يؤسسان لرؤية نقدية تُساعد المتلقي على قراءة الظاهرة، بقدر ما يُسهمان في تضليل الرؤى وتمرير المغالطات اللصيقة بنماذج تفسيرية اختزالية.
كما اعتبر المؤلف أن صدور هذا العمل يأتي كذلك في سياق انخراط العقل الإسلامي المعاصر في أسئلة اللحظة الحضارية؛ مما يتطلب تفكيك بنية العقل الإسلامي المسئول بشكل كبير عن تفريخ "محاكم التفتيش" السائدة لدى الجهاز المفاهيمي للعديد من الحركات الإسلامية المعاصرة، التي لا زالت مُجرّد أقلية صغيرة شديدة التنظيم وعالية الصوت (ظاهرة صوتية بتعبير عبد الله القصيمي) وحاملة لمشروع هلامي، لولا خطابها الفضفاض هذا، يُروج له بشكل مُكثف في أغلب الفضائيات الدينية والمواقع الإلكترونية.
وسوف نعرض هنا بعض مضامين الكتاب محاولين بشكل مقتضب الحديث عن مختلف الجوانب التي تطرق لها الكتاب دون الدخول في مناقشة مضامينه تاركين للقارئ فرصة لاكتشاف جديد هذا الكتاب.
ويجب علينا أن نشير إلى أن الكاتب ومنذ البداية نبه إلى أن هذا الكتاب هو إسهام نظري وتطبيقي؛ من أجل تسليط الضوء على المقدمات وتبعات صعود نجم الوهابية في المنطقة العربية، من خلال الاشتغال على المجال التداولي المغربي السياسي.
يمكن قراءة محاولة الكاتب منتصر حمادة قراءة هذه الظاهرة في إطار إنتاج رؤية نقدية؛ من أجل تجاوز نماذج تفسيرية اختزالية، وذلك بالبحث في معالم وجذور ومآلات النزعة السلفية الوهابية بالمغرب، وقد قصد الكاتب هنا الدخول في نوع من الاشتباك المعرفي مع اتجاه جديد، أصبح منظومة معرفية مركبة وعقدية وليست طارئة، تتنازعه جماعات وخطابات ومواقف وكتابات وبرامج وفضائيات؛ حيث الكل يدلي برأيه في الموضوع، بين من يعتبر السلفية الوهابية مذهبًا فقهيًّا أو رافدًا فكريًّا وثقافيًّا أو حركة سياسية منافسة للتدين المغربي الذي اشتهر عبر التاريخ أنه إسلام أشعري العقيدة ومالكي المذهب.
بيد أن النقاش الذي يدور حاليًا، وسيطرحه الباحث منتصر حمادة، ليس اختزالًا لأسئلة متعددة في زمن تحرير الأجوبة المسبقة والأحكام الجاهزة خلال الفعل أو أثناء الممارسة في الساحة السياسية.. في ثنائيه جدلية قديمة في الفكر والفلسفة الإسلاميين تظهر التجاذب بين أفكار ابن رشد العقلانية واجتهادات الغزالي الفكرية.. بين ثنائية المعاصرة والإسلام هو الحل للحكم، والدين لم يعد منتجًا للحقيقة اليوم.. إنها قراءة في قراءة للفكر داخل نسق قرائي يشكل حلقات للفهم والاستيعاب والتقديم والتأخير قصد الشرح والإيضاح.. اللافت للنظر أننا خلال قراءتنا لأعمال وكتابات الباحث منتصر حمادة نلامس هذا المعطى النقدي لا السردي الإنشائي.
يتوقف المؤلف في هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر، في الفصل الأول المعنون بخصوصيات التدين المغربي بالتحليل والمناقشة التدين السلفي الوافد إلى المغرب في سياق معالجته لإحداث أحداث نيويورك وواشنطن في 11 شتنبر 2011.. حيث يحاول تقديم صورة عن السلفية الوهابية بكل تلاوينها واتجاهاتها في حقل يعتبر أنه مليء بالألغام المعرفية والأيديولوجية، وما أنتجت من أزمات تلتها عدة عمليات تفجيرية خلقت أزمات على الصعيد العالمي، وجرت بسببها تفاعلات وردات فعل من هذا الطرف أو ذاك، وكان عنوان هذه التفاعلات 'الحرب على الإرهاب'؛ حيث نسبت إلى الإسلام وهو منها بريء، ونسبت إلى السلفيين وتبرءوا منها في تصريحاتهم، مقابل سلفيين آخرين تبنوا هذه الاعتداءات، وشاركوا فيها من خلال التيار السلفي الجهادي.
كل ما جرى فتح أعين الدارسين والباحثين حول البحث في تفاصيل وثنايا الأحداث المنسوبة إلى السلفيين كجماعات وتنظيمات؛ ليمتد إلى معتقداتهم لمعرفة العلاقة "التمفصلية" بين ذلك والعنف أو النموذج المجتمعي الذي يريدون تحقيقه أو هدم أسواره وأركانه.
وقد فتح الباحث منتصر حمادة باب النقد المعرفي في مواجهة ما أسفرت عنه نتائج مشروع تصدير السلفية الجهادية، مميزا له عن السلفية التقليدية؛ حيث فتح هذا النقاش في الساحة المغربية مستشهدًا بأبحاث ومؤلفات كتاب كبار وعلماء أكاديميين أمثال طارق علي وبرنارد لويس والمؤ رخ الفرنسي شارل سانت برو وغيرهم..
وقد اختار الكاتب في الفصل الأول الاشتغال على معالم الاشتباك العقدي والمذهبي بين تديّن تقليدي لدولة إسلامية مع تديّن وافد، في الحالة المغربية دون سواها، وتحديدا مع معالم "السلفية الوهابية" للعقدين الأخيرين بالمغرب، وليس معالم "السلفية الوهابية" إبان أوائل السلاطين العلويين، ابتداء من السلطان المولى سليمان، (ولد سنة 1180 هـ / 1766م، وتوفي سنة 1238 هـ / 1822م) مرورًا بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله، وانتهاء بالسلطان مولاي الحسن الأول، دون أن يعفيه ذلك من التوقف الضروري عند أهم المعالم التي مَيّزت التديّن المغربي إبان القرون الماضية، قبل التوقف عند التطورات التي ستهُبُّ على معالم هذا التديّن خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها ما يُشبه "تغلغل" النزعة السلفية الوهابية في أوساط بعض المؤسسات الدينية الرسمية والحركات الإسلامية بالمغرب.
بالنسبة للفصل الثاني، فقد خلص الكاتب إلى أن الخطاب السلفي الوهابي في المغرب، المتفرع على تياري "السلفية العلمية" و"السلفية الجهادية"، يجد جذوره في "استيراد" أدبيات فقهية مشرقية، اعتبرت دخيلة على طبائع التديّن المغربي، كما لخّصَها نُظُم ابن عاشر الشهير (في عَقْد الأشعري وفقه مالك.. وفي طريق الجُنيد السالك)، وأن معالم هذه النزعة تتجسّد بشكل جلي في أغلب أدبيات الحركات الإسلامية المغربية في حين أن سمات التشدد في الخطاب السلفي الوهابي، تتجسّد على الخصوص في أدبيات "السلفية العلمية" ومعها أدبيات "السلفية الجهادية"، بما يُؤسّس لنوع من التصلب في المواقف السلفية الوهابية عموما، وهو التصلب المعرض لمزيد من التعديل والليونة، بحكم إكراهات فرصة تاريخية تمر منها المنطقة العربية مع أحداث "الربيع الإسلامي" (انطلق منذ مطلع العام 2011)، كما تجسد ذلك بشكل جلي مثلا في تأسيس حزب "النور" السلفي في مصر.
أما الفصل الثالث، فقد خصصه المؤلف للحديث عن الفوارق الجليّة بين المرجعية العقدية والمذهبية لحركات وأحزاب "الإسلام السياسي" (أي مُجمل الحركات السياسية التي تبنت خيار المشاركة في اللعبة السياسية الشرعية، وليس الحركات الدعوية، أو الحركات "الجهادية")، وبين المرجعية العقدية والمذهبية "للإسلام الرسمي" ومعه "الإسلام الشعبي" في المجال التداولي المغربي، معتبرًا أن الساحة المغربية تشهد منذ عقود تدافعا بين خطابين بارزين يرومان تأطير وهندسة معالم التديّن المغربي، يعود الأول لمؤسسة إمارة المؤمنين والوزارة الوصية على الشأن الديني والمؤسسات التابعة لها (المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، ودار الحديث الحسنية)، والمؤسسات الدينية التابعة للقصر الملكي، كالرابطة المحمدية للعلماء، ويعود الثاني للعديد من الحركات الإسلامية، تشترك في مرجعتها العقدية والفقهية في النهل من أدبيات "سلفية وهابية"، ويُنتظر منها الاجتهاد في "توطين" هذه الأدبيات مع الخصوصيات الدينية لممارسة المغاربة، سواء عبر إدماج قياداتها وقواعدها في المؤسسات الدينية الرسمية، أو عبر التضييق الميداني على باقي الحركات الإسلامية الرافضة لخيار الإدماج.
بالنسبة للفصل الرابع والأخير، ويعتبر في الواقع أهم فصول الكتاب، فقد تضمن مجموعة من الخلاصات حول واقع ومستقبل السلفية الوهابية في المجال التداولي المغربي، وعددها 18 خلاصة بالضبط، منها مثلا أن التيار "السلفي الوهابي" في المجال التداولي الإسلامي المغربي يفرض مجموعة من التحديات العقدية والمذهبية والسلوكية على صناع القرار (حَمَلة لواء الإسلام الرسمي)، وعلى الرأي العام أو العامة (مُمثلي "الإسلام الشعبي")، بالنظر إلى خصوصية التديّن المغربي عبر التاريخ، في بلد لُقّبَ بأنه "بلد الأولياء" مقابل المشرق "بلد الأنبياء"، لولا أن الأدبيات السلفية الوهابية لا زالت تُصِرُّ على اعتبار السلوك الصوفي ضلالا والعقيدة الأشعرية أقرب إلى الشرك والمذهب المالكي في آفاقه التشريعية أقرب إلى البدعة.
وخلُص الكاتب إلى أن هناك لائحة من القواسم المشتركة بين النظام المعرفي (épistémique) للتديّن المغاربي، مقارنة مع النظام المعرفي للتديّن السلفي الوهابي الوافد من المشرق، أقلها الإيمان بحتمية اتباع "المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان قولا واعتقادا وعملا"، بتعبير الشيخ عائض القرني، لولا أن الخوض في تفاصيل هذين النظامين يُحيل المتتبع على تفرعات ميدانية تفسر اختلاف العلماء المغاربة من الذين يؤمنون أن التديّن المغربي مُؤسَّس على نُظُم ابن عاشر الشهير وبين العلماء المشارقة، من الذين يؤمنون أن الإسلام يُختزل فقط في "المرجعية السلفية"، مضيفًا أن التديّن المغربي المستقبلي في حاجة إلى معرفية إسلامية جديدة، يقوم بداية على المرجعتين المؤسستين (القرآن والسنة)، وينهل من أهم مكتسبات فقه ما بعد الحقبة النبوية، دون أن يرتهن إلى مُجمل هذه التعريفات المعرفية السائدة، وفي مقدمتها اليوم، التعريف السلفي الوهابي الذي يعرف حضورًا متزايدًا في العديد من ربوع المجالات التداولية الإسلامية، بشهادة وتزكية أهله قبل غيرهم، ولعل تفطن بعض رموز ما أصبح يُطلق عليه بتيار "الدعاة الجدد"، أو "التديّن الجديد" لهذا المأزق المعرفي، وتقديمهم لنموذج جديد ومُغاير في التديّن، يجتهد في إحداث نوع من المصالحة الوجودية بين الماضي والحاضر، بين النص والواقع، بين النقل والعقل، يُفسّر إجماع الفقيه الرسمي وفقيه الحركات الإسلامية المعتدلة (الرخوة) والمتشددة (الصلبة)، على توجيه النقد إلى هذه الرموز الدعوية؛ لأنها ترفض تبني مُجمل معالم التديّن السلفي الوهابي، ونتحدث عن بعض رموز تيار الدعاة الجدد؛ لأن غالبية هذه الرموز، لا تخرج بدورها عن النهل من المرجعية السلفية الوهابية.
ويضيف المؤلف أنه حتى مع التسليم بأن الخطاب الرسمي المغربي يعتبر أن الإسلام المغربي مُؤسس على مرجعية "في عَقْد الأشعري وفقه مالك.. وفي طريق الجُنيد السالك"، فهذا مُعْطى نظري لا يُعفي المراقب السوسيولوجي أو الأنثربولوجي من الجزم بأن إسلام المغاربة اليوم، لا يمكن اختزاله في "الإسلام التقليدي، صوفي النزعة"، حيث نجد تداخلا لإسلاميات أخرى موازية، وفي مقدمتها- إن لم يكن أهمها- إسلام التيار "السلفي الوهابي"، سواء كان مُجسّدا في أعضاء الحركات الإسلامية، أو في أعضاء التيار السلفي "العلمي/التقليدي" أو "الحركي/الجهادي"، أو حتى في دواليب مؤسسات دينية رسمية، كما أنه من المفارق أن نجد بعض المسئولين عن تدبير الشأن الديني، يختزلون بعض معالم مواجهة التيار "السلفي الوهابي" في الترويج لتصوف نخبوي أو فولكلوري، بشكل يُسيء للممارسة الصوفية، وبالتالي لطبائع التديّن المغربي، أكثر مما يخدمه؛ بل إن بعض رموز هذا التصوف، في المجال التداولي المغربي، يتبنون مبادرات سلوكية لا يمكنها إلا أن تغذي مشاريع التيار "السلفي الوهابي".
ومن خلاصات العمل أيضًا، أن مُعطيات الساحة الميدانية في المنطقة العربية تُنبئ بمستقبل زاهر للسلفية الوهابية، وتتعدد الأسباب المغذية لهذه الفورة السلفية الوهابية في المنطقة، أقلها تبعات الاستغلال الجلي للثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات والفورة المعلوماتية (NTIC)، (مواقع الإنترنت، الفضائيات، الشبكة الاجتماعية... إلخ)، موازاة مع تأطير وتنظيم ندوات ولقاءات علمية تروج للخطاب السلفي الوهابي، في إطار التدافع الاستراتيجي مع مشروع "تصدير التشيع" الإيراني، وتندرج هذه المشاريع في إطار ما وصفه رضوان السيد بـ"الصراع على الإسلام"؛ هذا على الصعيد الإقليمي أو العربي أو الإسلامي/ الدولي، أما على الصعيد الوطني/ الداخلي، وإسقاطًا لمقتضيات قاعدة "الطبيعة لا تقبل الفراغ"، فإن أي تواضع في تلبية رغبات العامة/ الشارع على "التغذية الدينية"، يُقابل بملأ تلك الفراغات عبر السائد في الساحة، سواء كانت مرجعية المعنيين بملأ هذا الفراغ، معترفا رسميا أم لا، بما يُفسر اضطرار المسئولين إلى الاستعانة بالمنتمين للحركات الإسلامية وبمُمَثلي التيارات السلفية الوهابية؛ من أجل تغذية هذا الارتفاع المتزايد على "التغذية الدينية".
ويُشبه رهان المسئولين المغاربة على تدبير الشأن الديني والأمني، بخصوص إدماج رموز "السلفية الوهابية" في المؤسسات الدينية الرسمية، من قبيل المؤسسات سالفة الذكر، رهان نفس المسئولين على بعض النتائج الميدانية التي أفرزها خيار إدماج إسلاميي "التوحيد والإصلاح" في اللعبة السياسية، أي الرهان على تليين المواقف العقدية والمذهبية لجميع هؤلاء، بحكم الانصياع لإغراءات ومقتضيات الانخراط في العمل المؤسساتي الشرعي، الذي يتطلب القبول باحترام لائحة من الثوابت الدينية.
ومن يتتبع مواقف "التوحيد والإصلاح" و"العدالة والتنمية" خلال السنين الأخيرة، يتبيّن له غلبة الهواجس السياسية والسجالات الأيديولوجية في النقاشات التي تثيرها مواقف الحركة والحزب في المنابر الإعلامية، مقابل التقزيم من الهواجس الدعوية والدينية، بالرغم من أن "المرجعية الإسلامية"، تعتبر "الرأسمال الرمزي" الأول الذي تُوظفه الحركة والحزب في اللعبة السياسية، وهو توظيف مقبول به نسبيا من قبل المسئولين، طالما يتم تحت المراقبة و"الترويض".
ومن أهم خلاصات الكتاب أيضًا، التأكيد على أن تشابك عوامل ميدانية مُتشابكة من قبيل الضغط الديمغرافي وتعليم ديني مُتأزم، والأزمة الاقتصادية، وغياب الحريات، وفشل مشاريع التنمية، وانتشار الفضائيات الدينية السلفية الوهابية، وفورة المواقع الإلكترونية المتشبعة بالمرجعية السلفية الوهابية.. لا يسع هذا "الكوكتيل" إلى أن يؤسّس لعمر مديد للحركات الإسلامية ذات النزوع السلفي الوهابي، ومن باب تحصيل حاصل، التيارات السلفية، واعتبر الكاتب في هذه الجزئية، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع التحديات العقدية والمذهبية والسلوكية التي أفرزها تغلغل الخطاب "السلفي الوهابي" في المجال التداولي المغربي، فإنه يُمكن وصف رهان بعض صانعي القرار في "الشرق" و"الغرب" على خيار "الفوضى الخلاقة" تجاه المنظومة "السلفية الوهابية"، بأنه أشبه بالحرث في الماء، من منطلق أن المواجهة الحقيقية لهذا الخطاب تتطلب الانخراط الرصين في "اشتباك" عقدي ومذهبي ومعرفي، كفيل بإحداث نحو من الزحزحة والتفكك والتأسيس لنقد ذاتي تقوم به أدبيات التيار، وما يُزكي هذا الطرح، إقرار أبناء التيار قبل غيرهم أن أدوات غالبية الناقدين الفكرية وإمكاناتهم على الأرض كالليبراليين والإصلاحيين والطائفيين لا ترقى لمقارعة السلفية المعاصرة فضلاً عن هزيمتها.
وفيما يشبه رسالة وتذكير بمسئولية المثقفين والباحثين، لاحظ المؤلف أننا إزاء عزوف مُقلق للأقلام العربية والإسلامية، بما في ذلك الأقلام الإسلامية المقيمة في المهجر، عن الخوض في "الاشتباك المعرفي" مع الأدبيات السلفية الوهابية، بالموازاة مع أوراش "الاشتباك العقدي والفقهي"، ذلك الصادر عن فقهاء "المراجعات" وفقهاء المؤسسات الدينية، والذي يُحسب له التأسيس لخطاب فقهي نقدي من مرتبة "أقل الأضرار"، ولو أنه ينطلق من نفس الأرضية الفقهية والمعرفية التي تنطلق منها التيارات السلفية الوهابية، العلمية و"الجهادية".
وتكمن أهمية هذا المعطى- كما يضيف المؤلف- في إحالته على مسئولية المفكرين والباحثين في معرض تقييم أوضاع الراهن العربي الإسلامي، سواء في حقبة تصدير المشروع السلفي الوهابي، أو في حقبة ما بعد صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن، وبدرجة أكثر دلالة، ما أفصحت عنه الثورات العربية في مطلع العام 2011 مع صعود نجم التيارات السلفية الوهابية، وهو التقييم الإجمالي الذي أعاد العقل الإسلامي إلى "الدرجة الصفر" من النهضة الإصلاحية التي طرقنا أبوابها على خجل منذ قرن ونيف، مع أعمال محمد عبده ورشيد رضا ورفاعة الطهطاوي رغم نزعتهم السلفية، ولكنها على الأقل، كانت ذات نَفَس إصلاحي حيث تجديد و"إحياء" النقاش شبه البيزنطي بخصوص توظيف الوسائل الأنفع للأنظمة والدول والأمة: الرهان على السلفية الوهابية عند من يرفع شعار "الإسلام هو الحل"، أو التسريع بإحداث "القطيعة المعرفية" مع التراث العربي والإسلامي عند من يرفع شعار "الوحي لم يعد مُنتجا للحقيقة اليوم"، أو تبني الطريق الإصلاحي الثالث والغائب اليوم: التوفيق بين كنوز التراث الإسلامي ومفاتيح التراث الغربي الحداثي.