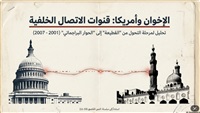التأويل مشكلة فهم الكتابة مع الواقع من الصبر إلى القتل
الثلاثاء 01/سبتمبر/2015 - 01:01 م
طباعة
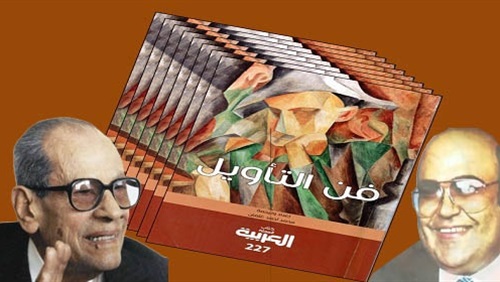
اسم الكتاب: فن التأويل
اعداد وترجمة: محمد أحمد عثمان
الناشر: كتاب المجلة العربية- السعودية سبتمبر 2015
ما يزال مفهوم (التأويل) يلقى رواجًا كبيرًا في أوساط الدارسين والمتخصصين والمثقفين عمومًا، في عالم ما بعد حداثي، وما لبثت تكتسب فيه التأويلات والتفسيرات أهمية متزايدة إلى حد تكاد أن تحل معه هذه التأويلات محل الوقائع الأصلية.
لذا ليس غريبًا أن تكرس صحيفة ثقافية فرنسية بحجم (لا كنزين ليترير) عددًا خاصًّا من أعدادها (العدد الثالث والأربعين بعد الألف، أغسطس 2011) لموضوع التأويل: مفهومه، مجالات ممارسته، أهميته واستراتيجياته وبالطبع مشكلاته! شارك في الملف طيف واسع من المتخصصين، ثمانية عشر متخصصًا تقريبًا، تراوحت تخصصاتهم بين الفلسفة وعلم اللغة والأدب والترجمة والموسيقى والرقص والرياضيات.. إلخ. وبمعدل حوار أو مقالة أو حوار لكل كاتب. وفي كتاب فن التأويل إعداد وترجمة محمد أحمد عثمان تم ترجمة عشرة مقالات من هذا الملف.
وقد رأينا في عرضنا المبسط لهذا الكتاب المهم رغم صغر حجمه 81 صفحة أن العالم العربي يعاني أيضًا مشكلة على المستوى الفكري والديني في التعامل مع فهم التأويل، سواء في التعامل مع الكتب المقدسة أو الكتب الأدبية؛ مما أدى ويؤدي إلى فهم وتفسيرات خاطئة للآيات؛ الأمر الذي يتسبب في قيام جماعات تقتل بناء على تأويل آيات. مثل فهم البعض لآيات الجهاد. أو تأويل لبعض الأعمال الأدبية يؤدي لقتل كتابها، كما حدث في محاولة قتل نجيب محفوظ لكاتبته رواية (أولاد حارتنا) وقتل فرج فودة لكتابته عددًا من المؤلفات الفكرية وغيرهما الكثير. من هنا تأتي أهمية طرح الرؤى المتعددة لفن التأويل بهذا الكتاب، وإن كان لم يتعرض بشكل مباشر للكتب الدينية، بل تعرض لمعضلة التأويل ذاته وهو مشكلتنا الكبرى في عالمنا العربي.
من الإبداع للتشويه
يبدو تعدد (التأويل) غير قابل للاختزال. فهل ينبغي- انطلاقًا من هذا- أن نتخلى فيما يتعلق بهذا المصطلح عن كل (معنى بؤري) (ندين بهذا التعبير إلى شارح أرسطو، جوين وين)؟ أن نؤول، لا يعني فقط أن نجعل الشيء مفهومًا، كما يظهر ذلك التأويل الموسيقي: ماذا يساوي عمل موسيقى دون أن تتم تأديته؟ يمتلك التأويل، بهذا المعنى، وظيفة أنطولوجية – وجودية- على نحو خاص؟ كذلك، ماذا تساوي قاعدة قانونية دونما قاض يطبقها؟ فما هو التأويل؟
التأويل هو التقاء الذاتية بموضوع: ذاتية: لا يشتمل التأويل على حل بسيط لشفرة أو لغز؛ لا نتبين حل رموز؛ ففي الموسيقى لا أتبين فك رموز حيث المؤدي لا يضع شيئًا من نفسه، وهكذا إذا كان بوسع القوانين أن تطبق ميكانيكيا فلن يكون هنالك حاجة لقضاة.
ويكون التأويل خاليًا من الموضوع عندما لا تأخذ هذه الذاتية بالحسبان شيئًا آخر غير ذاتها، منكرة دور المصادفة مثلا، أو متجاهلة ما قيل حقا؛ عندما تفرض، بأي ثمن، أساطيرها الخاصة في مكانة أعلى من الصور التي تحيط بها، فإنها تقيم مقام الموضوع الحاضر (أو في حضوره) موضوعًا متوهمًا.
في التأويل تتواجه الحرية مع موضوع واقعي، وبأسلوب أو بآخر تولد شيئاً ما. هذا الاستيفاء، المعتمد على اليقين، هو دائما مجازفة، فما من حدس بسيط أبدا.
بحسب الإسهامات المتجمعة في هذا العدد، سنرى أننا إذ نؤول، فذلك يعني أننا يمكن أن نعطي معنى، على أن يكون هذا المعنى قابلا للتشييد وإعادة الضبط دونما انقطاع، وبوسع هذا أن يكون أيضًا التلقي، في حالة الترجمة بشكل خاص ووظيفة المترجم؛ فإننا ننتج حدثًا، عندما يعطي التأويل على نحو خاص ولادة؛ قراءة ما بين السطور، عندما يتعلق الأمر بتوضيح عدة مستويات من المطالعة؛ التنقيب عما هو حقيقي، إذ إن التأويل لا يكون مجرد وجهة نظر بسيطة؛ وذلك عندما نؤول بلا مسوغ. فما يقتضيه التأويل من مسافة بين شخصين وكذلك من امتداد في مجاله، سيوضعان هما أيضًا في علاقة.
فن التأويل كما يراه "ليو شتراوس":
الحقيقة في التجربة
الخطاب التأويلي هو باستمرار الأكثر تناولًا، إما بوصفه خطابًا بلا قواعد، معروض لتعددية غير محددة في وجهات النظر أو كخطاب غير يقيني بانتظار الفحص الذي يسمح بالبت فيه وبوضع نهاية للكتابة التأويلية. الاهتمام الفكري لـ"ليوشتراوس" ينصب على الخطاب التأويلي باعتباره خطابًا يمتلك قوامًا خاصًّا ونهائيًّا، وهو في ذاته لصيق الصلة بخطاب الحقيقة كما لو كانا يمثلان كلا واحدا. ويقترح شتراوس منهجًا صارمًا لفن التأويل ذا قوانين خاصة وعقلانية.
هكذا يميز شتراوس مستويين من مستويات الفهم لنص ما: التأويل، أي محاولة معرفة ما (قال المؤلف وكيف فُهم على وجه الدقة ما يقول، وما يعبر عنه أو لم يعبر عنه صراحة من هذا الفهم)، والتفسير، وهو عمل متمم، وقوامه في حكمنا التقويمي تجاه قيمة حقيقة النص، آخذين، حينئذ، فقط، في الحسبان المعطيات الخارجية للنص. أن نؤول نصًّا، يعني أن نفهم فكرة مثلما تفهم في ذاتها. الصيغة تستحق أن نتوقف عندها: إنها تعني أنه من غير المناسب أن نكون منتبهين لما قاله مؤلف ما صراحة، لكن علينا أن نعود إلى ما هو مضمر من فكرته أو إلى إرادة القول، لديه، المضمرة في النص. إنها تحدد الحدود المشروعة لإعادة اكتشاف ما هو مضمر.(أو خفي) أن نؤول يعني أن نجيد قراءة ما كُتب بتأنٍّ بين السطور بموجب طرائق محددة، وهو ما يستلزم أن نكون على دراية بهذه الطرائق وأن نكون على علم بالسياق اللغوي لملفوظات المؤلف. إن احتراسًا كهذا يرفض كل منظور يتجاوز الحرفية والنصية كي يحيل فورًا إلى التفسير السببي لمنطوقاته (بمقتضى) اعتبارات خارجية، أي بموجب سياق الأحداث الخارجية على حرفية النص. إن احترام نص ما وفهمه، يعني عدم معالجته باعتباره نتيجة.
الكتابات المتعلقة بقراءة ما بين السطور والتي كتبت لهذه الغاية هي أبعد من أن تكون استثناءات. يوجد هنا تقليد مستتر يجتاز الفكر القديم (أفلاطون) وعصر الأنوار القروسطي (بن ميمون، ابن سيناء أو الفارابي) والذي يخص أيضًا عتبة الحداثة (إسبينوزا أو ليسنج) وحتى التقليد الفكري الحديث والمعاصر الذي يلي عصر الأنوار الألماني. إن ذلك يشكل تقريبًا كل تاريخ الفكر الذي يتصادف أن يكون موضوع الاهتمام.
بموجب هذه النصوص، فإن قراءة نص ما، يعني قراءة سطحه الأول بانتباه شديد، والسعي في الأثناء إلى فهم ما هو بالأحرى ذو مغزى، باعتبار أنه لم يتم التعبير عنه إلا نادرًا، والدعوة إلى تفكيك جديد لشفرته. والعملية الأخيرة لا تلغي الفهم الأول لكنها- بالأحرى- تعيد تشكيل الكل، متيحة في نفس الوقت موقعة الطبقة الأولى من المعنى بطريقة جديدة. القراءة الثانية لا تقول أبدا نقيض الأولى لكنها تحول اقتصاد الكل. إنها تكشف النقاب عن سطح آخر.
كتابة الحقيقة
لماذا نعمد إلى فن للتأويل كهذا، عوضًا عن قول وتفسير الأشياء بوضوح، مخاطبين في نفس الوقت عقل القارئ ومعتمدين على التقدم الاستدلالي للمحاججة، واضعين الثقة في الحجج الوحيدة للمعتقد العقلاني كما لو كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي بمقدورها تبديد الأحكام المسبقة وتبديد مغريات اليقين؟ من المناسب، مع شتراوس، أن نحدد الأشياء: الالتفاف عن هذا الدرب لا يعني إبطالا والتخلي عن مهمة تنوير عدد أكبر من الناس بكل تأكيد. الواجب الأساسي لفن التأويل يقتضي أن نأخذ بالحسبان المقاومة السياسية لخطاب الحقيقة. إن كتابة الحقيقة، وإن كانت فلسفية جدا، هي كتابة سياسية: تأخذ بالحسبان موازين القوى التي تعارض الاستماع إلى الحقيقة. وتتمثل هذه القوى أولا في- قوى سياسية على نحو مباشر – سلطة دولة الأنظمة الاستبدادية القديمة التي ما زالت مستمرة (الأنظمة التسلطية). وتلك التي تجدد نفسها (الأنظمة (الشمولية) مثال عليها). لكن شتراوس يتمسك بإيضاح أن حكوماتنا الليبرالية ومجتمعاتنا الديمقراطية تشهد على ذلك أيضًا. ما يعني أن الشرط السياسي الذي يقود إلى ضرورة الكلام الموارب هو أكثر عمومية وانتشارًا، بما أنه لا يتعلق فحسب بالاستيلاء على سلطة الدولة لكن بالاستحواذ على الرأي العام المسيطر على كل المجتمع بما هو كذلك. ومن هنا فإن على وصفة التنوير أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الاحتراس: حماية الحكماء من عامة الناس ومن المجتمع الذي يتمتع هو نفسه بنوع من الذكاء المتلهف إلى الحقائق ومن ثم، بالنتيجة، من احتمال الوقوع في سوء الفهم. إن فن الكتابة يهيئ لتقدم معقد يمر من خلال القبول بالصبر الذي يتطلبه تفكيك الشفرات..
حديث الحقيقة
إن فن الكتابة والقراءة يمثلان شرطين ملازمين لخطاب الحقيقة. والحقيقة تقدم نفسها بحيوية في حديث الحقيقة، وهي دائمة الخضوع لتجربة ما بين نصين. وهي لا تستطيع أن تقدم نفسها بالمعنى الحقيقي كما لو كانت نسيجا لنص غير مكتمل، إنما نسيجًا لنص حقيقي يتوجب نبشه، بما أن تناغمه الداخلي لا يكون كلاما، بل حياة. أن نؤول لا يعني أن نشخص ولا أن نتشخص، لكن أن نشتغل على أنفسنا دون توقف مع استبعاد افتراضاتنا الخاصة والمسبقة؛ لذا فإن ما نقوم بنشره ليس شيئا آخر غير الفلسفة، قاصدين بهذه المفردة ليس فحسب كُلا من المقترحات، من التعاليم أو حتى نظام من المعارف، لكن حياة مترعة بالحكمة، وهو ما يهرب من محيط فضاء النص.
فن التأويل، حسب شتراوس. يُشيع الشكل الاستفهامي للفكر، مانحًا إيانا بذلك حقائق. إنه يعلمنا، فيما نقرأ ونكتب، كيف نحيا؟
من أجل تأويل أفضل
في مقال مثير للاهتمام، يدافع الفيلسوف الأسترالي بول توم عن الفكرة التي بمقتضاها يمكن للمنهج التأويلي أن يتطلب تعديلا كبيرا في موضوع التأويل، دون أن يكون لذلك علاقة بانعدام النزاهة أو بنقص التركيز.
هكذا يغير المؤولون في بعض الأحيان من موضوع التأويل: إنهم يحلون محل الموضوع الأصلي موضوعا جديدا. وشرعية هذه العملية تخضع لشرطين: ينبغي للموضوع الجديد أن يقترب بقدر الإمكان من الموضوع الأصلي. أي ينبغي له أن يتوافق مع المنهج التحليلي موضوع النظر، والذي هو عبارة عن المفهوم (أو مجموعة من المفاهيم) المستخدم من قبل مؤول ما ليعطي معنى لموضوع بعينه. ويمكن لهذا الموضوع أن يكون بنفس القدر ظاهرة طبيعية، نصًّا، أو سلوكًا بشريًّا.
بالنسبة لتوم، هنالك أربعة طرائق ممكنة لـ (تغيير الموضوع):
أمثلة موضوع التأويل (idealization)
إعادة تقطيعه (Resegmentation)
إعادة اكتشافه (reconception)
إعادة العثور فيه على موضوع مستتر (recovery)
لا تتوافر الأمثلة حسب توم على أي محتوى عاطفي، إنها تذكر بالأحرى بعملية التعديل الذهني الذي يرمي، بالنسبة إلى التلميذ، إلى رؤية دائرة في مار سمه أستاذه للتو على السبورة. ويضرب توم مثلا بالأداء الذي قدمه عازف البيانو سفياتوسلافريشتر لمعزوفة لوحات المعرض لموسورجسكي. يتعلق الأمر إذن بالتأويل الذي يعطيه معلق ما للأداء: فهذا المعلق يقر بوجود عدة نواقص تسم عزف ريتشر. لكنه إذ يفعل ذلك يكون قد أحل محل هذا الأداء الواقعي أداء مثاليًّا. بما يتوافق مع المنهج التأويلي الذي يقترحه (هذا العزف المنفرد يميط اللثام عن تمثال ضخم من الأنغام ويعيد الاعتبار لعمل موسيقي مجهول). من الأهمية بمكان أن نلاحظ هنا أنه ليس بالأداء الخيالي: تنطبق الأمثلة على أداء مهيب لطخته بضعة نوتات خاطئة. الشرطان المذكوران أعلاه هما كافيان: إن الخضوع لمسار تأويلي للموضوع كما تصوره التأويل، يعني أن يفي هذا الموضوع بمتطلبات الموضوع الأصلي.
الموضوعات التي ينبغي لها أن تؤول تحت مسار محدد تتطلب أن نقوم بتقطيعها على نحو ملائم. يفترض (إعادة التقطيع) إحلال جزء محل كل. فعلى سبيل المثال، ليس من الممكن للعهد القديم – بالكتاب المقدس- أو القصة التاريخية في القرآن- أن يؤول بالكامل تحت شكل القصة التاريخية: قطع معينة منه فقط بوسعها أن تخضع لهذا الشكل.
فيما يتعلق بـ (إعادة الاكتشاف) يذكر توم هذا المثال المستمد من دونالد ديفيدسون، وهو المثال نفسه الذي يفسره مارتين مونتميني في الصفحة 7، من العدد الحالي: إنه يتعلق بإعادة تأويل مصطلح تم استخدامه على نحو غير ملائم من قبل متكلم لجعله أكثر ملاءمة للاستعمال الذي يصنعه منه هذا المتكلم.
يأخذ الإحلال التأويلي أحيانًا شكل الاكتشاف لموضوع كامن كان قد تم النظر إلى موضوعه الأصلي (الموضوع الظاهر) بوصفه تحويلًا. بالنسبة لتوم هنالك ثلاثة أنماط لإعادة الاكتشاف: نمط الأصول، نمط المقاصد، نمط الركائز (أو طبقات الأعماق).
في نمط الأصول، فإن الفكرة هي أنه ليس بوسعنا أن نؤول عملًا فنيًّا كما ينبغي إذ لم يكن هذا العمل قد حافظ على مكنوناته بما فيه الكفاية، وعليه يتوجب على تأويلنا أن ينطبق على موضوع أصلي متوارٍ.
أحيانا يصحح المؤولون النواقص التي تبينوها في أداء الحركات التي هم بصدد تأويلها. وبذلك، هم يحلون حركة مفترضة محل حركة منجزة واقعيا. إذا عدنا إلى مثال ريتشر، فإننا نجد، مع عازف بيانو بمستواه، أن المسافة بين ما أراده وبين ما أنجزه يمكنها أن تكون ضئيلة (تتكون من عدة أخطاء نوتية). وأن المستمعين، وهم مثقفون، سيحلون محل ما سمعوه الأداء الذي سيحلو لهم أن ينسبوه إلى مقاصد ريتشر.
يمكن للمؤولين أن يضعوا على عاتقهم واجب كشف ما هو مستتر. هكذا كان فرويد يفهم الأحلام. المنهج التحليلي الفرويدي يمكن صياغته هكذا: الأحلام هي إشباع للرغبات، الموضوع الظاهر هو التحويل (المتحقق – على نحو غير واعٍ – من قبل الحالم ذاته) للموضوع الباطن، الذي يتوجب على التحليل النفسي إظهاره إلى حيز الوعي. ينبغي للموضوع الباطن، هنا أيضا، إشباع الإكراهين (الشرطين) اللذين يوجهان عملية الإحلال التأويلي: التوافق مع المنهج المقترح (إشباع رغبة) والمكوث بقدر ما يكون ذلك ممكنا (داخ حدود التحويل) في الموضوع الظاهر. يبقى سؤال، يلاحظ بول توم، يتعلق بمدى ملاءمة المنهج التحليلي الفرويدي: هل الأحلام هي فعلا تتمة للرغبات؟ إذا لم يكن بوسعنا البرهنة على ذلك، فإن البناء الفرويدي يبقى تأويلا، لكن بالأحرى بمعنى الحدس أو بمعنى البناء المتخيل. (إن التسليم بشيء ما، على افتراض وجود هذا الشيء، والذي من شأنه أن يعطي معنى الموضوع ليس بالأمر ذاته عندما نمتلك الدليل على أن ما سلمنا به يوجد وجودا واقعيًّا).
بعض طرائق (تغيير الموضوع)، يستخلص توم، توجد على نحو محايث في التأويل: إعادة التقطيع وإعادة الاكتشاف. والطريقتان الأخريان هما استراتيجيتان تأويليتان واسعتا الانتشار. إنهما حتى تتمتعان بالشمولية في إطار بضعة أنماط من التأويل: إن اكتشاف ما هو مستتر هو الهدف الشامل للتأويل التاريخي كما هو بالنسبة للتحليل النفسي، على سبيل المثال.
هذا المقال القصير نسبيًّا يتركنا على جوعنا على مستوى نقطة واحدة، تمتح من عدم وضوح مفهوم (المنهج التأويلي) بما فيه الكفاية: هل لمسعى كهذا أن يباشر عمله في منهج تأويلي كالذي تحدثنا عنه، كما يلمح إلى ذلك المؤلف؟