نصر حامد أبو زيد ونقد الخطاب الديني
الأربعاء 10/يوليو/2024 - 01:30 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
اسم الكتاب: نقد الخطاب الديني
المؤلف: نصر حامد أبو زيد
إن الهجوم الذي تعرض له نصر حامد أبو زيد، والذي تركز في جزء كبير منه على ما جاء في هذا الكتاب، أثبت صحة الأطروحات والنتائج التي قدمها من خلال تحليل الخطاب الديني في مستوياته واتجاهاته المختلفة، الرسمي منها والمعارض، المعتدل والمتطرف، اليميني واليساري، والسلفي والتجديدي.
كان موقف أبو زيد دفاعاً عن حرية الفكر، والتقاليد العلمية الجامعية، في مواجهة الذين اعتبروا أن تحليلاته تشكل تهديداً للدين، وخروجاً على الملة.
في حين لم يكن هدف الذين هاجموه الدفاع عن الدين، بل هو دفاع عن المصالح والمواقع التي تنتج مكانة وزعامة وأموالاً، وهي أمور لم تكن في حسبان أبو زيد الذي كان يدافع عن منهجه النقدي، وإصراره على القيم المعرفية في التصدي للتزييف والخلط.
إن «الخطاب الديني» فرض نفسه على الفكر العربي متوازيا مع ظهور ما يصطلح عليه بـ "الإسلام السياسي"، الذي سطع نجمه مع الأفول الفكري والسياسي الذي عرفه الفكر الماركسي بعد تفكك المعسكر الاشتراكي في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.
من هذه الناحية يمكن أن يصنف نصر حامد أبو زيد في إطار «المفكرين المناضلين»، الذين يحملون التزاما فكريا واضح المعالم، ويريدون الدفاع عنه وحمايته بطريقة تنم عن اعتراف ضمني بأن الفكر هو أيضا مجال للصراع. لقد قاد هذا الموقف نصر حامد أبو زيد إلى التخصص في تفكيك الخطاب الديني من الداخل وانطلاقا من المكونات نفسها التي تعتبر مؤسسة له.

وهكذا بدأت أعماله تظهر تباعا لتعبر عن مشروعه الفكري العام الذي يدور حول مشكلة "القراءة والتأويل". فأصدر "الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة" سنة 1982، أتبعه بكتاب "فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي" سنة 1983، ثم "مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن" سنة 1990، و"الخطاب الديني، رؤية نقدية"، و"الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية" سنة 1992، و"نقد الخطاب الديني "سنة 1994، تلاه "التفكير في زمن التكفير" سنة 1995، و"العنف الأصولي"، و"النص، الحقيقة، السلطة" في نفس السنة.
إن الخيط الرابط بين هذه المؤلفات كلها يتجلى في أنها تندرج في إطار التأويل في بعده الخطابي، ومن ثم فإن نصر حامد أبو زيد كان يرى أن الثقافة العربية هي ثقافة نص بالدرجة الأولى. ولكي نصل بصددها إلى نتيجة معينة فإن علينا أن نعكف على "قراءة" هذه النصوص، مما أفضى به إلى مشكلة التأويل، على أن مجهود أبو زيد لم ينصب إلا على "تأويل التأويل" باستثناء كتابه "مفهوم النص"، ويستفاد من ذلك أنه كرس حياته العلمية لتفكيك القراءات التي أنجزت عن النصوص التأسيسية في تاريخ الفكر الإسلامي، في محاولة ظل يغذيها بالاستفادة من المناهج والنظريات العربية والغربية لإنتاج "قراءة مغايرة" وفق رؤية واضحة المعالم ترمي إلى تقديم فهم جديد للإسلام ليس باعتباره عقيدة فقط، ولكن باعتباره تاريخًا يشهد على صعود حضارة وأفولها.
يتكون كتاب «نقد الخطاب الديني» من ثلاثة فصول كُرست كلها عن آليات الخطاب الديني المعاصر، والتي تحكم منطقه الداخلي، ويفرق الكاتب بين «"الدين" و"الفكر الديني"، فالدين هو ما تمثله في الإسلام مثلا مجموعة النصوص المقدسة التي ثبتت صحتها تاريخيا (القرآن والسنة). أما الفكر الديني فهو «الاجتهادات البشرية» التي بذلت من أجل الوصول إلى فهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها.
وبما أن الاجتهادات تختلف من عصر إلى عصر ومن دارس إلى آخر نتيجة اختلاف البيئة والواقع الاجتماعي والتاريخي فإن ذلك مدعاة إلى الإقرار بشرعية تعدد القراءات، وبالتالي، فإن ما يحكم هذه القراءة أو تلك هو السياق العام لزمن القراءة، مما يسمح بالقول إن النصوص الدينية مشرعة على عدة قراءات قد تلتقي أو تختلف فيما بينها، ولكنها قابلة للنقد والتقويم.

وإذا كان هذا يمثل جوهر الفكر النهضوي الذي قاده الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده وغيرهم من رواد عصر النهضة، فإن الخطاب الديني استطاع أن يخفي «حقيقة» الاختلاف ويرسي أسس "إطلاقية" فكرية تقترب في اعتبارها ودورها في المجتمع من الدور الذي تنهض به النصوص المقدسة، وإذ يتقاطع في الخطاب الديني ما هو سياسي بما هو ديني فإن "المد الإسلامي" الذي تعرفه البلاد العربية منذ التسعينيات قائم على استغلال هذا اللبس بين الدين من جهة والخطاب الديني من جهة ثانية كي يحقق أهدافا "دنيوية" لا علاقة لها بالدين.
تعتمد دراسة نصر حامد أبو زيد في "نقد الخطاب الديني" على كل المجالات التي تشكل موضوع ذلك الخطاب، وهذا التحديد أتى على التمييز، الذي غالبا ما يلجأ إليه رجال السياسة بين إسلام سياسي متطرف وإسلام سياسي معتدل، ويوضح الكتاب كيف أن الاختلاف بين الاثنين هو اختلاف في الدرجة لا في النوع، فلا خلاف بينهما في المنطلقات الفكرية والآليات المستعملة في قراءة "النص".
ويرمي الكاتب من وراء هذه الملاحظة إلى القول إن الخطاب الديني يستعمل نفس الآليات بغض النظر عن كونه معتدلًا، أو متطرفا، ويحدد أهم تلك الآليات في الخلط بين الفكر والدين، الذي يؤدي إلى إلغاء المسافة بين الذات والموضوع، وفي تفسير كل الظواهر على اختلافها بردها إلى علة واحدة، وفي الاعتماد على السلف والتراث وقلب تراتبية المرجعيات المعتمدة بشكل يصبح فيه ما هو أساسي ثانويا وما هو ثانوي رئيسيا، وفي رفض أي خلاف فكري باعتماد القطعية في الأحكام، وفي تجاهل البعد التاريخي بالحنين والاستشهاد في جميع الأحوال بالعصر الذهبي للخلافة الراشدة.
من الصعب في تحليل الخطاب الديني أن نفصل بين آليات هذا الخطاب ومنطلقاته الفكرية، ولذلك فإن نصر حامد أبو زيد وهو يحلل تلك الآليات يبرز في نفس الوقت السمات الفكرية الغالبة على هذا النمط من التفكير، يظهر ذلك على سبيل المثال من خلال الآلية الأولى التي تتعلق بتوحيد الفكر والدين.
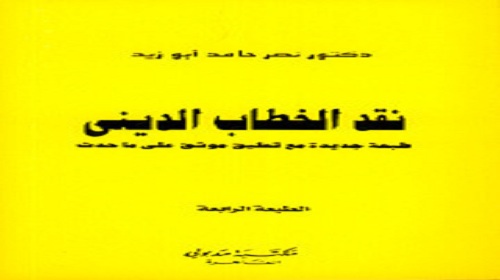
فالخطاب الديني كما سبقت الإشارة إلى ذلك يقيم نوعا من التقاطع الذي يكاد يصل إلى حد التماهي بين النصوص الدينية وبين فهم (قراءة) تلك النصوص، ويترتب عن ذلك ادعاء ضمني بالقدرة على النفاذ إلى «جوهر» النص، أي إلى تحقيق نوع من التطابق بين النص والقراءة. وهذا من الناحية النظرية والإجرائية مستحيل لاختلاف «زمن النص» عن «زمن قراءته»، ومثل ذلك الادعاء يفهم في غالب الأحيان على أن «الفقيه» يفهم ما لا يستطيع الآخرون أن يفهموه، ويرمي من وراء ذلك إلى أنه وحده من يمتلك «الحقيقة» الدينية، مما يوقع الخطاب الديني في تناقض صارخ: فهو من جهة يسلم بأن «لا رهبانية في الإسلام»، وهو من جهة أخرى يدعي امتلاك المفاتيح السحرية للقبض على «جوهر» النص الديني.
ومن شأن هذا كله أن يكرس مبدأ «القراءة» الواحدة للنص، مما يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى إلغاء العقل، ويتمثل هذا الإلغاء بالخصوص في استحضار تراث «السلف الصالح»، حيث يمارس نوعا من الانتقائية تعيد النظر في التراتبية المعروفة في الإسلام: القرآن والسنة والإجماع والقياس.. وهكذا يتشكل خطاب يقيني مبني على التجريد، الذي يقصي في كل الأحوال البعد التاريخي للنص الديني، ويتجاهل سياقه الخاص.
كما يؤكد نصر حامد أبو زيد على مجموعة من المعالم لا من وضعها في الاعتبار حال اطلاعنا أو قراءتنا للخطابات الدينية من أهمها:
ـ إن علم "تحليل الخطاب" يركز على الدلالات التي يمكن استنباطها من الأقوال، لأن تلك الدلالات تمارس تأثيرها على المتلقي سواء أكانت دلالات مقصودة أم كانت غير مقصودة.
ـ إن عملية النصب الكبرى تلك لم يكن يمكن لها أن تتحقق دون تمهيد الأرض بخطاب يكرس الأسطورة والخرافة ويقتل العقل.
ـ حسب طرحه لجوهر العلمانية- والذي قد يُختلف فيه معه-: "ليست في جوهرها سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين، وليست ما يروج له المبطلون من أنها الإلحاد الذي يفصل الدين عن الدولة والحياة.
ـ من أهم مبادي الفكر العلماني أنه لا سلطان على العقل إلا العقل.
ـ الجميع يتحدثون عن الإسلام دون أن يخامر أحدهم أدنى تردد ويدرك أن يطرح في الحقيقة فهمه هو للإسلام أو لنصوصه.

ـ إن آلية "رد الظواهر إلى مبدأ واحد" تكاد تكون آلية فاعلة في معظم جوانب الخطاب الديني.
ـ إن هذا الخطاب لا يتحمل أي خلاف جذري، وان اتسع صدره لبعض الخلافات الجزئية، وكيف يحتمل الاختلاف الجذري وهو يزعم امتلاكه للحقيقة الشاملة المطلقة ؟
• العلم الإلهي في حقيقته علم إنساني، بمعنى أنه يتحول إلى علم إنساني بالفهم والتأويل.
مقتطفات من الكتاب
ـ " إن تحليل الخطاب يهتم أساساً بالبعد التداولي للغة، أي بما تقوم به من تأثير من خلال الاتصال، وهذا ينفي عنه تماماً التفتيش في النيات والضمائر، أو الدخول في عالم قبل "القول". ولذلك يسمى نفسه "علم تحليل الخطاب" وينبو عن استخدام مصطلح "تحليل الأفكار" لأن هذا الأخير يوهم الدخول في نوايا المتكلم ويتوهم الوصول إلى المقصد الأصلي قبل الكلام، وهذا فارق هام جداً يستحق التأكيد والإبراز". صــ28
ـ"هذا هو الفارق بين "العقل الغيبي" و"العقل الديني"، في حين يجد الأول تفسيراً لكل شيء في الإيمان، يسعى الثاني للكشف عن الأسباب المباشرة للظواهر دون أن يتخلى عن "الإيمان". والواقع أن العقل الغيبي هو العقل المستريح القابل لأي تفسير يضع يافطة الإيمان. صــ36
ـ "أصحاب مقول "القدم" يقفون عن الإلهي ويتصورون للقرآن وجوداً أزلياً في اللوح المحفوظ خارج التاريخ، أي أن للقرآن وجوداً خارج مصالح البشر وخارج قوانين علاقتهم الاجتماعية. ومثل هذا التصور ينتج (الكهنوت) بكل تفأصيله وظلاله الكنسية في العصور الوسطى". صــ48

الخطاب الديني المعاصر .. آلياته ومنطلقاته الفكرية
الآليات..
لا يقوم الخطاب الديني بإلغاء المسافة المعرفية بين "الذات" و"الموضوع" فقط، بل يتجاوز ذلك إلى ادعاء- ضمني- بقدرته على تجاوز كل الشروط والعوائق الوجودية والمعرفية والوصول إلى القصد الإلهي الكامن في هذه النصوص. وفي هذا الادعاء الخطير لا يدرك الخطاب الديني المعاصر أنه يدخل منطقة شائكة هي منطقة "الحديث باسم الله"، وهي المنطقة التي تحاشى الخطاب الإسلامي- على طول تاريخه عدا استثناءات قليلة لا يعتد بها- مقاربة تخومها. ومن العجيب أن الخطاب المعاصر يعيب هذا المسلك ويندد به في حديثه عن موقف الكنيسة من العلم والعلماء في القرون الوسطى. صــ78
ـ إن الحديث عن إسلام واحد ثابت المعنى، لا يبلغه إلا العلماء، يمثل جزءاً من بنية آلية أوسع في الخطاب الديني. وليست هذه الآلية من البساطة والبداهة التي تبدو بها في الوجدان والشعور الديني العادي والطبيعي، بل نجدها في الخطاب الديني ذات أبعاد خطيرة تهدد المجتمع، وتكاد تشل فاعلية "العقل" في شئون الحياة والواقع، ويعتمد الخطاب الديني في توظيفه لهذه الآلية على ذلك الشعور الديني العادي، فيوظفها على أساس أنها إحدى مسلمات العقيدة التي لا تناقش. وإذا كانت كل العقائد تؤمن بأن العالم مدين في وجوده إلى علة أولى أو مبدأ أول- هو الله في الإسلام- فإن الخطاب الديني- لا العقيدة- هو الذي يقوم بتفسير كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية، بردها جميعها إلى ذلك المبدأ الأول. إنه يقوم بإحلال "الله" في الواقع العيني المباشر، ويرد كل ما يقع فيه. وفي هذا الإحلال يتم- تلقائياً- نفي الإنسان، كما يتم إلغاء "القوانين" الطبيعية والاجتماعية، ومصادرة أية معرفة لا سند لها من الخطاب الديني، أو من سلطة العلماء. صــ81

ورغم هذا الموقف الانتقائي "النفعي" من التراث- أو ربما بسببه- لا يتورع الخطاب الديني عن التفاخر بهذا الجانب الذي يرفضه من التراث، ولكن هذا التفاخر ينحصر في مجال المقارنة بين أوروبا القرون الوسطى وبين حضارة المسلمين، وكيف تأثرت أوروبا بمنهج التفكير العقلي عند المسلمين خاصة في مجال العلوم الطبيعية. وليست هذه المباهاة في حقيقتها إلا مبرراً يطرحه الخطاب الديني يسمح للمسلم بـ"استيراد" الثمرات المادية للتقدم الأوربي والثورة الصناعية بوصفها "بضاعتنا رُدت إلينا". إننا- طبقاً للخطاب الديني- نسترد ثمرات "المنهج التجريبي" الذي أخذته أوروبا عن أسلافنا، لكننا لا نأخذ عنها ما سوى ذلك من "كفر" والعياذ بالله، يقصد العلمانية، ذلك لأن أوروبا قطعت ما بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية، وشردت بعيداً عن الله في أثناء شرودها عن الكنيسة، التي كانت تستطيل على الناس بغياً وعدواناً باسم الله. وهكذا يخضع الإنجاز الأوروبي لمثل ما خضع له التراث من انتقائية ونفعية. صــ87
وهكذا فالخطاب الديني حين يزعم امتلاكه وحده للحقيقة المطلقة لا يقبل الخلاف في الرأي إلا ما كان في الجزئيات والتفاصيل، وهنا يبدو تسامحه واتساع صدره واضحاً ومثيراً للإعجاب، يتسع للتشدد والتنطع، بل وللتطرف، ولكن الخلاف إذا تجاوز السطح إلى الأعماق والجذور احتمى الخطاب الديني بدعوى الحقيقة المطلقة الشاملة التي يمثلها، ولجأ إلى لغة الحسم واليقين والقطع، وهنا يذوب الغشاء الوهمي الذي يتصور البعض أنه يفصل بين الاعتدال والتطرف. صــ90
يبدو إهدار البعد التاريخي في تصور التطابق بين مشكلات الحاضر وهمومه وبين مشكلات الماضي وهمومه، وافتراض إمكانية صلاحية حلول الماضي للتطبيق على الحاضر، ويكون الاستناد إلى سلطة السلف والتراث، واعتماد نصوصهم بوصفها نصوصاً أولية تتمتع بذات قداسة النصوص الأولية، تكثيفاً لآلية إهدار البعد التاريخي، وكلتا الآليتين تساهم في تعميق اغتراب الإنسان والتستر على مشكلات الواقع الفعلية في الخطاب الديني.صــ95

المنطلقات الفكرية..
ـ إن الإسلام جاء في نظر الخطاب الديني ليحرر الإنسان، لكن فهم هذا الخطاب للتحرر الذي جاء به الإسلام يتم اختزاله في نقل مجال الحكامية من العقل البشري إلى الوحي الإلهي: "إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر بصورة من الصور، أو بتعبير مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور، ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر يجعل بعضهم لبعض أرباباً من دون الله". صــ105
يتفق الخطاب الديني على أن النصوص قابلة لتجدد الفهم واختلاف الاجتهاد في الزمان والمكان، لكنه لا يتجاوز فهم الفقهاء لهذه الظاهرة، ولذلك يقصرها على النصوص التشريعية دون نصوص العقائد، أو القصص، وعلى هذا التحديد لمجال الاجتهاد يؤسس الخطاب الديني لمقولة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويعارض إلى حد التكفير الاجتهاد في مجال العقائد أو القصص الديني. صــ118
التراث بين التأويل والتلوين
يناقش علماء القرآن الدلالة الاصطلاحية لمفهوم التأويل عادة بمقارنته بدلالة مصطلح آخر هو "التفسير" ويحددون العلاقة بينهما بأنها علاقة العام بالخاص، إذ يتعلق التفسير عندهم بالرواية بينما يتعلق التأويل بالدراية، وبعبارة أخرى يتعلق التفسير بــ"النقل" في حين يتعلق "التأويل" بــ "العقل". صــ141
إن تفرقة القدماء بين نمطين من التأويل أحدهما مقبول والآخر مذموم يمكن أن تمثل- بعد نفي أساسها الأيديولوجي وتأصيل أساسها المعرفي- أساساً طيباً لتفرقتنا هنا بين التأويل والتلوين، إن التعامل مع النصوص، أو تأويلها، يجب أن ينطلق من زاويتين لا تُغني إحداهما عن الأخرى، خاصة إذا كنا نتحدث عن نصوص تراثية: الزاوية الأولى، زاوية التاريخ بالمعنى السوسيولوجي لوضع النصوص في سياقها من أجل اكتشاف دلالتها الأصلية، ويدخل في ذلك السياق التاريخي، وبالطبع السياق اللغوي الخاص لتلك النصوص، والزاوية الثانية زاوية السياق الاجتماعي والثقافي الراهن الذي يمثل دافع التوجه إلى تأويل- أو بالأحرى إعادة تأويل- تلك النصوص، وذلك من أجل التفرقة بين الدلالة الأصلية التاريخية وبين "المغزى" الذي يمكن استنباطه من تلك الدلالة. صــ142

إن كل الحجج النقلية هي في الحقيقة تركيب للنصوص على فرد معين، واستعمال لنص الوحي كنبوة أو توجيه ثم اختيار واقعة تاريخية معينًا كتحقيق لهذه النبوة، وتحقيق لهذا التوجيه، ولذلك خطأ في التفسير إذ لا يجوز إسقاط الحاضر على الماضي وقراءته فيه. صــ159
قراءة النصوص الدينية
ـ هناك المظاهر الإطلاقية والقداسة في المحاولات التي تبذل في شكل مؤتمرات وندوات ومؤلفات موضوعات جميعاً ما يطلقون عليه اسم "الأسلمة" في جميع مجالات النشاط الإنساني، وإذا كانت الدعوة إلى أسلمة القوانين بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أمراً مفهوماً في سياق تاريخنا الثقافي- رغم الخلاف حول مجالات التطبيق وآلياته- فإن الدعوة إلى أسلمة العلوم والآداب والفنون دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. إنها دعوة تؤدي إلى تحكيم الفكر الديني الخاضع لملابسات الزمان والمكان والموقف الاجتماعي في مجالات فكرية، عقلية وإبداعية، لم تتعرض لها النصوص الدينية، وإن حاول الفكر الديني دائماً بطرق تأويلية ملتوية أن يستنطق النصوص الدينية بما يراه في المجالات المشار إليها.صــ198
ـ إن ما نعنيه بالوعي التاريخي العلمي بالنصوص الدينية يتجاوز اطروحات الفكر الديني قديماً وحديثاً، ويعتمد على إنجازات العلوم اللغوية خاصة في مجال دراسة النصوص، وإذا كان الفكر الديني يجعل قائل النصوص- الله- محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا نجعل المتلقي- الإنسان- بكل ما يحيط به من واقع اجتماعي تاريخي- هو نقطة البدء والميعاد. إن معضلة الفكر الديني أنه يبدأ من تصورات عقائدية مذهبية عن الطبيعة الإلهية والطبيعية الإنسانية وعلاقة كل منهما بالأخرى، وبعبارة أخرى نجد المعنى مفروضاً على النصوص من خارجها، وهو بالضرورة معنى إنساني تاريخي يحاول الفكر الديني دائماً أن يلبسه لباساً ميتافيزيقياً ليضفي عليه طابع الأبدية والسرمدية في آن واحد. صــ200
ـ إذا كان الفكر الديني الإسلامي ينكر على الفكر الديني المسيحي "توهم" طبيعة مزدوجة للسيد المسيح، ويصر على طبيعته البشرية، فإن الإصرار على الطبيعة المزدوجة للنص القرآني وللنصوص الدينية بشكل عام يعد وقوعاً في "التوهم" نفسه. وينتج في الحالتين عن إهدار الحقائق التاريخية الموضوعية الملابسة للظاهرة، والتمسك بأصلها الميتافيزيقي والإصرار على أنه المفسر لها والمحدد لطبيعتها. ويعد "التوهم" من ثم حالة فكرية ثقافية تعكس موقفاً أيديولوجياً في واقع تاريخي محدد. وإذا كان التوهم قد أدى إلى عبادة ابن الإنسان في العقائد المسيحية، فإنه قد أدى في العقائد الإسلامية إلى القول بقدم القرآن وأزليته بوصفه صفة قديمة من صفات الذات الإلهية كما سبقت الإشارة، وفي الحالتين يتم نفي الإنسان وتغريبه عن واقعه لا لحساب الإلهي والمطلق كما يبدو على السطح، بل لحساب الطبقة التي يتم إحلالها محل المطلق والإلهي. صــ205
ـ إن القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها مالم تتدخل العناية الإلهية بوهب بعض البشر طاقات خاصة تمكنهم من الفهم، وهذا بالضبط ما يقوله المتصوفة، وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم الإنسان العادي- مقصد الوحي وغايته- وتصبح النصوص الدينية شفرة إلهية لا تحلها إلا قوة إلهية خاصة. صــ206
ـ ومن النصوص التي يجب أن تعتبر دلالالتها من قُبيل الشواهد التاريخي النصوص الخاصة بالسحر والحسد والجن والشياطين، وقد حاولت بعض التفسيرات الحديثة والعصرية تأويل الجن والشياطين على أساس من معطيات علم النفس الفرويدي بصفة خاصة بأنها بعض القوى النفسية، ولكن هذه التأويلات لم تنطلق من أية أسس معرفية عن طبيعة النصوص، بقدر ما كانت تهدف إلى غايات نفعية لنفي التعارض بين الدين والعلم. إنها محاولة تلفيقية لا تزال مستمرة في الخطاب الديني وإن اتخذت صيغاً أخرى مثل "أسلمة العلوم"، والفارق بين هذه الصيغة الأخيرة وبين سابقتها يتمثل في أن الأخيرة تجعل الإسلام نقطة ارتكازها للتوفيق، في حين كانت الأولى تجعل العلم نقطة الارتكاز. صــ212
إن الفرق بين المعنى والمغزى من منظور دراستنا يتركز في بُعدين غير منفصلين: البعد الأول أن المعنى ذو طابع تاريخي، أي أنه لا يمكن الوصول اليه إلا بالمعرفة الدقيقة لكل من السياق اللغوي الداخلي والسياق الثقافي الاجتماعي الخارجي. والمغزى- وإن كان لا ينفك عن المعنى بل يُلامسه وينطلق منه- ذو طابع معاصر، بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص. وإذا لم يكن المغزى ملامساً للمعنى ومنطلقاً من آفاقه تدخل القراءة داخل دائرة "التلوين" بقدر ما تتباعد عن دائرة "التأويل"، البعد الثاني للفرق بين المعنى والمغزى- وهو بعد يعد بمثابة نتيجة للبعد الأول- أن المعنى يتمتع بقدر ملحوظ من الثبات النسبي، والمغزى ذو طابع متحرك مع تغير آفاق القراءة وإن كانت علاقته بالمعنى تضبط حركته وترشدها، أو هكذا يجب أن تفعل. صــ221
















