نصر حامد أبو زيد ونقد الأيديولوجية الوسطية عند الإمام الشافعي
السبت 10/يوليو/2021 - 02:36 ص
طباعة
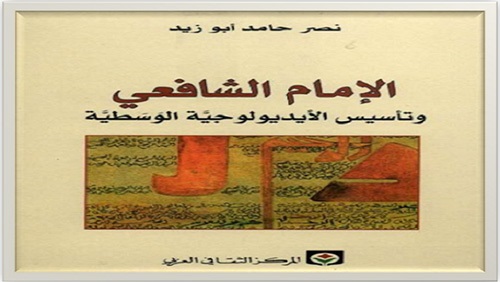 حسام الحداد
حسام الحداد
إن السؤال لا يتعلّق بقبول النص ولا برفضه، بل هو كيف يتلقّى الإنسان النص ويتفاعل معه، إن عقل الرجال ومستوى معرفتهم هو الذي يحدّد الدلالة ويصوغ المعنى، كهنة النقل يذودون عن فهمهم للنص بتقديس تأويلاتهم واجتهاداتهم فيصبح الخلاف معها كفرًا وإلحادًا وهرطقة
• الكتـاب: الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية
• المؤلف: نصر حامد أبو زيد
• الناشــر: المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء- الطبعة الأولى2007

لقد صاغ الإمام الشافعي، مفهوم الوسطية صياغة إيديولوجية وقد أصبح مفهومًا مركزيًا في الثقافة الإسلامية في القرن الثاني للهجرة، وفي كتاب الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي نقدم عرض له اليوم يقدم لنا قراءة جديدة تبدأ من تحليل النصوص التي استند إليها الشافعي، معارضاً رؤية الشافعي لهذه النصوص التي دفعت العقل العربي إلى الاعتماد على سلطة النص بعد أن تمت صياغة الذاكرة في عصر التدوين – عصر الشافعي- طبقاً لآليات الاسترجاع والترديد، وتحولت اتجاهات الاعتزال والاتجاهات العقلية إلى اتجاهات هامشية".
يقوم نصر حامد ابو زيد في مقدمة كتابه والتي استغرقت نصف الكتاب تقريباً، بالرد على الاتهامات التي وجّهت له ولمجمل أبحاثه خاصة الكتاب الذي بين ايدينا، من قبل الدكتور محمد بلتاجي، والدكتور عبد الصبور شاهين، بدعوى عدم تخصصه في الفقه، مفنّداً هذه الدعوى بأن كتابه ليس في علم الفقه، وإنما في نظرية المعرفة المستندة إلى علم تحليل الخطاب، ولهذا فهو بحث في المشكلات الاجتماعية الاقتصادية، وفي فكر الشافعي بوصفه آراء تقبل النقاش ويمكن ردها إلى جذورها الاجتماعية.
إن الحملة التي أثارها الدكتور عبدالصبور شاهين ومحمد البلتاجي، أستاذ الفقه وأصوله وخطباء المساجد وصحيفة "الشعب" ورئيس جامعة القاهرة بسبب كتاب "الإمام الشافعي" هي دفاع عن سلطة النصوص، وهي السلطة المضفاة على النصوص من جانب اتباع "النقل"، إن السؤال لا يتعلّق بقبول النص ولا برفضه، بل هو كيف يتلقّى الإنسان النص ويتفاعل معه، إن عقل الرجال ومستوى معرفتهم هو الذي يحدّد الدلالة ويصوغ المعنى، كهنة النقل يذودون عن فهمهم للنص بتقديس تأويلاتهم واجتهاداتهم فيصبح الخلاف معها كفرًا وإلحادًا وهرطقة، وهي الصفات التي ألصقت بكل اجتهادات الباحث، إن مفهوم «شمولية النصوص» لكل الوقائع يلغي من فهم الإسلام تلك المناطق الدنيوية التي تركها للعقل والخبرة والتجربة، إنه المفهوم الذي يفضي إلى القول بالحاكمية، وبتحكيم الفهم الحرفي للنصوص في كل مجالات حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهي شمولية حرص الشافعي على منحها للنصوص الدينية، ما يعني تكبيل الإنسان وإلغاءه فاعلية وإرادة، وتم تحويل السنّة النبوية من نصٍّ شارح إلى نصٍّ مشرّع لا يقل في سلطته عن النص الأول، وتم توسيع مفهوم السنّة بجعل الإجماع جزءاً منها، والقياس مجرد أداة للوصول إلى دلالة النص لا إلى توليد الدلالة، لهذا كانت مواقف الشافعي الاجتهادية «تدور في أغلبها في دائرة المحافظة على المستقر الثابت، وتسعى إلى تكريس الماضي بإضفاء طابع ديني أزلي عليه» في هذا السياق تأتي القراءة المغرضة التي أجّج سعيرها من هاجموا وكفّروا «نصر حامد أبوزيد» انطلاقاً من مسألة عدم الفهم «واعتبار الحديث عن سلطة النص كأنها موجهة إلى النص ذاته» إنهم ينظرون إلى القواعد التي تلقنوها عن المذهب – الحنفي أو الشافعي– بوصفها قواعد ثابتة من المؤسس الأول للمذهب، وليست قواعد تكوّنت وتراكمت عبر صيرورة تاريخية محكومة بقواعد وقوانين اجتماعية مالت بها إلى التقولب والتجمّد والثبات «لقد قرّر مفكرو المذهب المتأخرون إدماج المشهورات في المتواترات لتوسيع النص الثاني «السنة» بل جعلوا أحاديث الآحاد جزءاً منها، وجاء القياس ليكون جزءاً من السُنّة، في هدف واضح لتوسيع النص وتضييق مجال العقل.
وسطية الشافعي:

عاش الشافعي في منتصف القرن الثاني للهجرة، وتُوفي في بداية القرن الثالث الهجري، وأسس لما سمي بـ«الوسطية الفقهية» فجاء الأشعري المتوفى «330» ليؤسّس وسطيته في مجال العقيدة، ثم جاء الغزالي «ت:505» ليؤسّس وسطيته الفكرية والفلسفية، فالغزالي شافعي المذهب في الفقه، أشعري العقيدة، يُحسب للشافعي فضل الريادة لما سمي بـ«الوسطية التي يرى الكثيرون أنها من أهم خصائص التجربة العربية الإسلامية» تتركز الأصول الفقهية لدى الشافعي في أربعة، هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وهو في هذا الترتيب يؤسّس اللاحق منها على السابق، لهذا كان تأسيس السنّة بوصفها مصدراً ثانياً للتشريع، همّاً ومرتكزاً أساسياً وجوهرياً في المشروع الفقهي للشافعي، ومن هنا تفهم دلالة وصفه بـ«ناصر السُنة» على الشافعي، فلقد أسّس الشافعي السُنّة على الكتاب، ثم ألحقها بالكتاب على أنها جزء عضوي في بنائه من الوجهة الدلالية، فيصبح نصّاً تشريعياً يكتسب دلالته من دلالة النص المركّب من الكتاب والسنّة بناءً عضوياً ودلالياً واحداً يمكّن للشافعي بناء الإجماع عليه «ليصبح القياس/الاجتهاد استنباطاً من النص المركّب من الكتاب والسنّة والإجماع، ما يؤدّي إلى تضييق مساحة الاجتهاد/القياس بربطه «بوثائق النص ربطاً محكماً، آلية لا تخلو من مغزى أيديولوجي، في السياق التاريخي الشائع لفكر الشافعي، وفي فكرنا الديني الراهن على حد سواء".
الكتاب:
دافع الشافعي عن «عربية» القرآن، وأنكر بشكل مطلق أن تكون في القرآن ألفاظ غير عربية، خلافاً لما استقر عليه الرأي في عصره، معتبراً أن ما هو غير عربي، كأن يكون دخيلاً أو مقترضاً أو معرباً من اللغات الأخرى ما هو إلاّ ألفاظ عربية، فاللسان العربي واسع، ما يجعل الإحاطة به لا تكون إلاّ لنبي، وهو في رأيه هذا يدافع عن «نقاء اللغة العربية – وعن العروبة من ثم - من خلال إنكاره لوجود دخيل في القرآن» وتتفتق ذهنية الشافعي بحل وسطي في الظاهر منحازاً إلى فكرة الإنكار في جوهره، وهو أن ما يقال عن بعض الألفاظ بأنها أجنبية هي مما «تتفق فيها لغات وألسنة مختلفة، دون أن تكون قد انتقلت من لسان أمة إلى لسان أمة أخرى» وهو ما يصفه نصر حامد أبوزيد «وسطية تلفيقية» فلقد كان دفاع الشافعي عن عربية ونقاء لغة القرآن من الأجنبي الدخيل، دفاعاً عن نقاء لغة قريش، وتأكيداً لسيادتها في اللغة والحكم منذ أن جُمع القرآن على حرف «لغة» واحد، مسقطاً بقية الحروف «اللغات» فالشافعي يذهب إلى أن «الإمامة قد تجيء من غير بيعة إن كان ثمة ضرورة، وأن كل قرشي علا الخلافة بالسيف واجتمع عليه الناس فهو «خليفة» فالعبرة عنده في الخلافة أمران: كون المتصدي لها قرشياً، واجتماع الناس عليه، سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامته خليفة، كما في حال البيعة أم كان الاجتماع تالياً لاستيلائه على السلطة بقوة السيف وغلبة الشوكة، «لقد أدّى تأكيد الشافعي على أن ألفاظ القرآن كلها عربية، إلى إصرار الشافعي على أن قراءة الفاتحة في الصلاة لا تصح إلاّ باللغة العربية، وليس بأية لغة أخرى، على عكس رأي أبي حنيفة الذي أجاز قراءتها بغير العربية أو الفارسية – وبالتالي غيرها من اللغات – لمن لا يعرف اللغة العربية، ثم اشتراط الشافعي للبسملة، وترتيب الآيات، ما يعكس الخلاف حول «هويّة» النص القرآني، هل هو المعنى وحده أم المعنى متلبساً بالألفاظ، وعلى صحة الافتراض الأول يمكن للترجمة أن تحل محل الأصل وتجزّأ عنه، وهو فيما يبدو الموقف الضمني الذي ينطلق منه أبوحنيفة، أما الموقف الذي ينطلق منه الشافعي ويذود عنه فهو التلازم بين اللفظ والمعنى واعتبار العربية القرشية جزءاً جوهرياً في بنية النص.
السنّة:
تأسست مشروعية السنّة في عصر الشافعي كمصدر ثانٍ من مصادر التشريع، كان هناك من يرى أن القرآن كفاية وغني عن أحاديث وسنن يصعب التعرف على مدى صدقها ونسبتها إلى الوحي، وكان يرى دلالة الكتاب حاكمة على المرويات، وكان هؤلاء فيما يبدو يعتمدون على مرويات تؤكّد موقفهم، بالإضافة إلى مواقف بعض الصحابة من مرويات لم يأخذ بها لتعارضها مع دلالة بعض نصوص القرآن، لذلك حرص الشافعي على جعل السنّة ليست فقط شارحة ومفسّرة للنص الأول، وإنما جعلها جزءاً جوهرياً منه، وكما أن القرآن أنزل بواسطة وحي، كذلك الأحاديث أنزلت عن طريق «الإلقاء في الروع» فلقد جعل الشافعي السنّة وحياً من الله تتمتع بنفس القوة التشريعية والإلزامية للنص الأول، لهذا وسّع من مفهوم السنّة توسيعاً للنص لتشمل «الأقوال والأفعال والموافقات» لهذا يلجأ الشافعي إلى فكرة «العصمة» التي تمتّع بها الأنبياء، ومحمد خاصة ليزيل أي اعتراض، متجاهلاً بشرية الرسول تجاهلاً شبه تام، وتكاد تختفي من نسقه الفكري "أنتم أعلم بشئون دنياكم" حتى أنه يجعل من مواصفات النظام الاجتماعي السائد والذي لم يقمه الإسلام سنّة واجبة الاتباع، يجري عليها القياس، إن تأويل بعض نصوص الكتاب مثل تأويل الحكمة بأنها السنّة، والعصمة بانعدام الخطأ مطلقاً، كان مرتبطاً بموقف أيديولوجي، لقد انتهى الشافعي إلى أن يكون أهم أقطاب مدرسة الحديث في مواجهة مدرسة الرأي، فهو رغم اعترافه بمشروعية "القياس" إلاّ أنه كبّله بمجموعة من القيود جعلته مجرد استناد غير مباشر إلى النصوص «كان لابد من توسيع نطاق السنّة من جانب، والحرص على تأكيد أنها وحي آخر، لكن تصوّر علاقة السنّة بالقرآن عند الأحناف الذين اشتهروا بأنهم أهل الرأي، لا يتجاوز كونها نصاً شارحاً لا يستقل بالتشريع، فهي إما أن تقرّر ما قرّره القرآن، وتكون دلالتها دلالة التأكيد وفضل البيان، وإما أن تكون مفسّرة لما ورد مجملاً في القرآن، وهذا بيان التفسير، والقسم الثالث من بيان السنّة للقرآن هو بيان الناسخ والمنسوخ، وهو «بيان التبديل» وهو تصوّر للعلاقة بين السنّة والقرآن لا يستبعد تخصيص العام “من مجالات دلالة السنّة، إن الخلاف بين الشافعي «ناصر السنّة» والأحناف، أهل الرأي، هو خلاف حول انفراد السنّة بالتشريع، وإذا كان الشافعي قد تناقض على مستوى الناسخ والمنسوخ، فإن تناقضه في الحقيقة تناقض ظاهري، إن تأسيس السنّة وحي لم يكن يتم بمعزل عن الموقف الأيديولوجي الذي أسهبنا في شرحه وتحليله، موقف العصبية القرشية التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن النبي محمد وإلباسه صفات قدسية إلهية تجعل منه مشرّعاً، أما الأحناف فقد انطلق إمامهم من موقف مغاير، الأمر الذي مكّنهم من وضع السنّة موضعها الصحيح، بوصفها نصّاً شارحاً مبيناً للنص الأصلي، لذلك وضعوا النسخ في إطار «البيان» لا في إطار «التشريع».
حدود السنّة بين أهل الرأي وأهل الحديث:
لم يكن الشافعي وسطياً في المعركة بين أهل الحديث وأهل الرأي، وإنما كان منتصراً لأهل الحديث، ولم تكن المعركة متعلّقة بتضخم الأحاديث الموضوعة تحت ضغط الحاجة والصراعات السياسية، والمسائل المستجدة واقعياً، ولم يكن تضخم الرأي الذي ذهب لدى البعض بعيداً عن الفروض النظرية، إنما كان كل ذلك تعبيراً عن صراع بين "قوى التغيير والتقدّم، وقوى التثبيت والهيمنة" فعلى مستوى النص كان الصراع بين أهل الرأي وأهل الحديث حول مجال النصوص الدينية، كان أهل الحديث يدافعون عن شمولية النص لكل مجالات الحياة، وكان أهل الرأي يدافعون عن العقل و«المصالح المرسلة» و«الاستحسان» و«الاستصلاح» كان الصراع يأخذ شكل السيطرة على الذاكرة الجمعية من خلال صياغة موجّهات الذاكرة، هل هي “النصوص” أم على “العقل” الذي يجعل الاستنباط والاستدلال أساس الذاكرة فيظل هذا الصراع العام بين النقل والعقل، أو بين الفلسفة والدين، أو بين التقليد والإبداع، فلقد كان الشافعي متمسّكاً بالنصوص حتى ولو كانت ظنية الدلالة مثل أحاديث الآحاد، وذلك على عكس ما يُقال عن وسطيته بين أهل الحديث وأهل الرأي، فهو يعتبر حجيّة القياس أضعف من حجيّة حديث الآحاد، رغم اعتماد القياس على كليات الشريعة ومقاصدها العامة، فأحاديث الآحاد هي كالماء الذي يبطل "التيمم" القياس، ومعنى هذا أن القياس بمثابة المحظورات التي تجيزها الضرورات فقط، وهي الضرورات التي لا توجد مع تواجد النصوص ولو كانت ظنية، وليس معنى ذلك أن الشافعي يوحّد بين مستويات الدلالة في السنن والأحاديث، فحديث الآحاد في مرتبته أقل من المتواترات والمشهورات، وإن كان أقوى من القياس، فمن يرد حديث الآحاد لا يستتاب، في حين أنه لابد من استتابة من يشكّك في المرويات المجمع على صدقها، ولعل هذا الموقف الذي يتسم بالتساهل إزاء الحكم على أهل الرأي الذين يردّون أحاديث إذا تعارضت مع القياس، هو الذي أوهم الباحثين بوسطية موقف الشافعي بين الفريقين المتنازعين.
الإجماع:
مفهوم الإجماع لدى الشافعي ليس أكثر من نص غاب منطوقه عن البعض، وإن لم يغب مفهومه - محتواه ومضمونه – عن الكل، وفي هذا ما فيه من إهدار لدور الخبرة الجماعية المنتزعة من جدل الجماعة مع واقعها الاجتماعي التاريخي، وذلك بإلغاء تاريخيتها، وتحويلها إلى نص ديني ثابت المعنى والدلالة، فالإجماع حكاية غير مسموعة لا تقل في حجيّتها عن تلك المسموعة. إن انتقال الشافعي إلى مصر شوّش عليه «حجية الإجماع» بل شكّكه في وجوده على مستوى الأمة، لكن هذا الإدراك لزمانية الإجماع، بل ولإقليميته أيضاً لا يمنع الشافعي من الإصرار على كونه مرادفاً للسنة ويتمتع بقوة إلزامها وحجيتها، فالإجماع هو "ما اجتمع المسلمون عليه، وحكوا عمّن قبلهم الاجتماع عليه، وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة، فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها، وذلك أن اجتماعهم لا يكون عن رأي، لأن الرأي إذا كان تفرُّق فيه، والإجماع حجة على شيء، لأنه لا يمكن فيه الخطأ، أي أن الإجماع يندرج في السنة، وهو المفهوم الذي يتسع عند الشافعي لسنن الأعراف والعادات والتقاليد، فكلما اتسع نطاق السنة ضاق نطاق الاجتهاد، لقد حاول الشافعي في تصديه للعقل استخدام “بعض آليات التفكير العقلي ليبرّر نفي العقل وحبسه في دائرة النصوص، بحيث لا يتجاوز دوره استكشاف دلالتها، والعكوف على تأويلها وتفسيرها".
القياس:
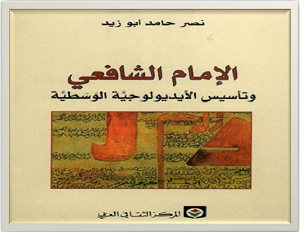
«القياس» لدى الشافعي هو ما يطلق عليه اسم "الحكم بغير إحاطة" فالحكم بإحاطة الظاهر والباطن يشمل: الكتاب والسنة (المتواترات والمشهورات) وتأتي أحاديث الآحاد في منطقة أقوى في حجيتها من القياس، ثم الحكم بغير إحاطة (بالظاهر والباطن) ويندرج فيه القياس/الاجتهاد، فالقياس مجرد اكتشاف للدلالة المستترة في الكتاب، فللكتاب بالمعنى الشامل نمطان من الدلالة: الأولى دلالة إبانة، والثانية دلالة إشارة. يحصر الشافعي حدود الاستدلال “على عين ثابتة موجودة بالدلائل الظاهرة، ويكاد الشافعي أن يحصر هذه العلاقة في المماثلة والمشابهة على مستوى الوقائع التي يجري القياس للحكم فيها” في تدرج بعلاقات الدال والمدلول يبدأ بالعام الشائع وينتهي إلى الخاص النادر يبدأ من المماثلة (علاقة القليل بالكثير) ويتوسط بالمشابهة في معنى الحكم أو علته، وينتهي بالتشابه المركب المتعدد الأوجه، وهذا الترتيب التدرجي يستدعي إلى الذهن نفس الترتيب لعلاقات التشابه عند البلاغيين، التي تنتقل من الحسي إلى المعنوي في علاقة تتصاعد معها قيمة التشبيه بقدرته على تنبيه العقل لاكتشاف العلاقات الموجودة بين الأشياء والتي يتفطن لها الشاعر دون أن يكون مبدعاً لها، ومثل البلاغيين يرى الشافعي أن المجتهد/القائس يصل إلى اكتشاف الدلالة المستترة في النصوص التي تشير إلى الوقائع الجديدة، ولكنه يجب أن يتجاوز إطار النصوص/العلامات ليبدع حلولاً جديدة، لو فعل ذلك لم يكن قائساً، بل يكون مستحسناً متلذذاً قائلاً برأيه والاستدلال على عين ثابتة يضيق دائرة القياس رغم ما يوهمه الشافعي بتعداده لأنماط التشابه على اتساع مدى القياس وتعدد ضروبه، ولأنه يعلم أن «المماثلة» الكمية تعني الدخول المباشر في حكم النصوص، فإنه لا يتوقف طويلاً عند قول من ينكرون وقوعه في مجال القياس، فالقياس لديه هو كل ما عدا النص من الكتاب والسنة، وهو ليس سوى اكتشاف لما هو موجود في النصوص بالفعل من الأحكام، فأي اجتهاد يقع خارج دائرة النصوص ودلالتها الحرفية هو استحسان وقول بالرأي والتشهي، برأي الشافعي، فلقد كان الشافعي برأي نصر حامد أبوزيد برفضه الاستحسان وتأكيده على القياس المكبل دائماً بسلطة الفهم الحرفي للنصوص، كان يناضل من أجل القضاء على التعددية الفكرية والفقهية، وهو نضال لا يخلو من مغزى اجتماعي فكري سياسي واضح، فالقياس عاصم للاختلاف، والاستحسان “قرين” التنازع الذي أشار إليه القرآن، وطالب المسلمين حين وقوعه أن يردّوا الأمر المتنازع فيه إلى الله، وهذا التعارض بين القياس والاستحسان ينطلق من موقف أيديولوجي ويعكس رؤية للعالم والإنسان، تجعل الإنسان معلولاً دائماً بمجموعة من الثوابت التي إذا فارقها حكم على نفسه بالخروج من الإنسانية، وليست هذه الرؤية للإنسان والعالم معزولة تماماً عن مفهوم «الحاكمية» في الخطاب الديني السلفي المعاصر، حيث ينظر إلى علاقة الله بالإنسان والعالم من منظور علاقة السيد بالعبد الذي لا يتوقّع منه سوى الإذعان، فلقد كان الاستحسان والاعتداد بالأعراف منهج أبي حنيفة مؤدياً إلى التعدد، في حين أن القياس لا يؤدّي إلى ذلك وإنما إلى ما يسميه الشافعي بـ«وحدة الحق» فالحق واحد ثابت في ذاته، كما أن البيت الحرام واحد في ذاته، وإن اختلف المصلّون في تحديد اتجاهه في وقت محدد ومكان بعينه، وهذا الإلحاح على "وحدة الحق" رغم اختلاف القائسين هو الذي يعطي القياس – في نظر الشافعي- مشروعية يحرم فيها الاستحسان، ومن غير المفيد أن نناقش الشافعي قائلين إن "الاستحسان" لا يخالف نصاً في كتاب أو سنة قائمة، وإنه مثل القياس ليس مطلوباً فيه علم الحق الذي هو غيب الله، وإنّ تعدد الآراء الناتجة عن الاستحسان لا يجب أن يقدح في مشروعيته، كما لم يقدح تعدد الاجتهادات في مشروعية القياس، لقد تحوّل القياس لدى الشافعي إلى نص ملزم بدوره، ومن هنا يأتي إلزامه دائما في عدم جواز خلاف ما اجتمع عليه السابقون، ولو كان قياساً فهو ينتهي إلى أن المسلك الذي يجب على الفقيه في الاجتهاد برأيه هو القياس وحده، وذلك لتكون الدلالة من النص بالحكم، فهو لا يرى معتمداً في الشرع إلاّ على النص، فإن لم يكن بظاهر الدلالة المستنبطة منه فباستخراج المعاني من النصوص، وتعرف عللها، ثم بالحكم بمثل ما نصّت عليه في كل ما يشترك مع النص وفي علة الحكم، فحجّة العلم في الفقه هو النص القرآني أو النبوي بألفاظه أو بالحمل على القياس، ومن قال بلا خبر لازم، ولا قياس على الخبر، كان أقرب إلى الإثم، هذه هي الشمولية في توسيع سلطة النصوص لتشمل النص الشارح، وأضفى عليها نفس درجة الإلزام بأن الحق الإجماع في النص، وجعل من القياس مجرد أداة اكتشاف الثابت من النص، ألغى فاعلية الإنسان وأهدر خبرته وكرس الماضي كونه من وجهة نظره هو النقي والخيّر، ليأتي الأشعري في مجال العقيدة والغزالي في مجال الفكر والفلسفة لتكتمل بهم دائرة تكبيل العقل العربي الإسلامي والهيمنة على مجمل الخطاب الديني حتى عصرنا هذا الذي يعتمد على آليات الاسترجاع والترديد، وتحوّلت الاتجاهات الأخرى في بنية الثقافة - والتي أرادت صياغة الذاكرة طبقاً لآليات الاستنتاج الحر من الطبيعة والواقع الحي- كالاعتزال والفلسفة العقلية إلى اتجاهات هامشية، وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر – لا من سلطة النصوص وحدها – بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا، علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان .















