" الفيصل " تعرض الكتاب الاحدث ...هل انتهت الفلسفة في زمن الإسلام؟
الإثنين 16/سبتمبر/2024 - 11:05 م
طباعة
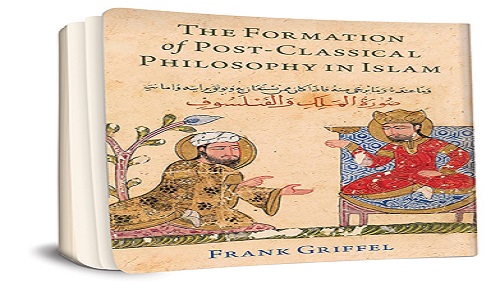 روبير الفارس
روبير الفارس
عرض العدد الاخير من مجلة " الفيصل " السعودية كتاب «تشكّل الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام». للكاتب "فرانك غريفل "وهو أستاذ في الدراسات الإسلامية في جامعة ييل جاء العرض من خلال قراءة للكاتب الباكستاني "حسن حميد " وترجمة للسورية " سارة حبيب
كان فرانك غريفل، حتى قبل نشر كتابه الأخير، يُعَدّ واحدًا من أبرز دارسي الغزالي في العالم. فبحثه السابق «اللاهوت الفلسفي للغزالي» كسب على السواء استحسان الأوساط الأكاديمية الغربية وحلقات المسلمين المتمسكين بالتقاليد.
، ناقش في كتابه السابق أن آراء الغزالي أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد «رفض» بسيط «لقوانين الطبيعة». هكذا، أدى كتاب غريفل إلى تخفيف حدة الادعاءات التي تقول بأن الغزالي يمكن أن يحمَّل مسؤولية انحطاط (مزعوم) للعلوم الطبيعية في الإسلام بعد القرن الثاني عشر. ويأتي كتابه الحالي ليتمم نقاشاته السابقة ويقدم دحضًا باهرًا لفرضية الانحطاط الفلسفي بعد الغزالي.
إن إستراتيجية غريفل بسيطة: أفضل دليل لإثبات أن الفلسفة لم تمت بعد الغزالي هو وجود الفلاسفة وكتب الفلسفة. ففي أكثر من ست مئة صفحة، يأخذنا غريفل في جولة مشوقة في التاريخ الفكري الإسلامي، مستكشِفًا حيوات وأعمال مجموعة كبيرة من المفكرين المسلمين في العقود اللاحقة للغزالي. في الحقيقة، إن هؤلاء الكتّاب، ونصوصهم، متعددون جدًّا، إلى درجة أننا نتساءل: كيف أمكن للباحثين السابقين أن يغفلوهم؟ وهذا السؤال يعود بغريفل إلى بحثٍ للغزالي استُشهد به مرارًا كإثبات على آراء الغزالي المعادية للفلسفة: «تهافت الفلاسفة».
في «التهافت»، قدّم الغزالي الفلاسفةَ بوصفهم أتباعًا غير نقديين لمواقف ابن سينا الفلسفية. زعم هؤلاء الفلاسفة أن مواقف ابن سينا كانت مبنية على الاستدلال اليقيني (شكلٌ من الجدال يؤدي إلى خلاصات أكيدة منطقيًّا وغير قابلة للدحض). ثم أثبت التهافت بطلان هذا الادعاء، مستخدِمًا مبادئ المنطق الأرسطي ذاتها التي أيدها الفلاسفة. حلّل الغزالي عشرين معتقدًا رئيسًا من معتقدات فلسفة ابن سينا؛ سبعة عشر: وجد فيها هرطقة ضد التعاليم الإسلامية؛ ثلاثة: كفر صريح. وفي الصفحة الأخيرة من الكتاب، أطلق الغزالي فتوى تقول: إن الشخص الذي يعتنق هذه المعتقدات الثلاثة -أبدية العالم، إنكار البعث الجسدي، إنكار معرفة الله بدقائق الأمور- يصبح غير مسلم ويستحق عقوبة الموت.
الفلسفة في ثوب الحكمة وعلم الكلام
رأى كثير من الباحثين الغربيين في الجملة الأخيرة إثباتًا على أن الغزالي كان جزءًا من «تعصب إسلامي» عازم على اضطهاد الفلاسفة. لكن غريفل يناقش بأن الكتّاب الغربيين هنا -كما في مواضع أخرى كثيرة- مذنبون بأنهم بمنتهى السهولة أسقطوا التجربة التاريخية للمسيحية الأوربية على تاريخ الإسلام. لكن، يظهر السجل التاريخي أن فتوى الغزالي كان لها القليل جدًّا من الأثر، في حين أن نقد الغزالي العام لفلسفة ابن سينا كان له تأثير عميق في الفكر الإسلامي. ويمكن ملاحظة هذا في تطورين رئيسين في القرن الثاني عشر. وفقًا لغريفل: «التطور الأول هو أن الفلاسفة الذين كانوا ملتزمين بالتقليد العلمي والنصي للفلسفة كما انحدرت من الإغريق إلى العرب تجنبوا كلمة «فلسفة» واستبدلوا بها كلمة أخرى اتخذت إلى حد كبير المعنى ذاته الذي كان للفلسفة حتى أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي] أي الحكمة[. ثانيًا، نلحظ نشوء نوع مختلف من الفيلسوف أي المتكلم، وهو الشخص الذي يكتب في الفلسفة وينخرط فيها تمامًا كما كان الفلاسفة في القرون السابقة، لكنه يرفض عمدًا سمة فيلسوف، وينأى بنفسه عن الفلسفة».
بكلمات أخرى، كثير من العلماء المسلمين بعد الغزالي كتبوا عن موضوعات مثل الميتافيزيقا، وعلم الأخلاق، واللاهوت. وانشغلوا عمدًا بعلماء سابقين كتبوا عن موضوعات مشابهة. بالتالي، كانت اهتماماتهم الفلسفية وانخراطهم بتقليد فلسفي كافية لوصف أعمالهم على أنها فلسفة. مع هذا، تجنب هؤلاء العلماء تسمية «فلاسفة» لأنفسهم و«فلسفة» لما يمارسونه؛ لأن نقد الغزالي جعل هذه المصطلحات غير ملائمة لذوق العصر. وفي حين أن الفلسفة لم تختفِ تمامًا؛ كان ثمة أولئك الذين استمروا باتباع تعاليم ابن سينا من دون الانشغال بنقد الغزالي، لكنهم لم يشكلوا سوى أقلية بين المجموعات التي كانت تمارس الفلسفة. في النتيجة، عندما بحث الباحثون الغربيون عن الفلسفة في العالم الإسلامي في المدة اللاحقة للغزالي -ما يدعوه الأكاديميون المرحلة ما بعد الكلاسيكية من الإسلام- قصروا بحثهم على الكتب التي عُرِّفت على أنها كتبُ فلسفةٍ، من دون أن يدركوا وجود نوعين آخرين من الفلسفة كانا أكثر إنتاجًا ودُعِيَا بأسماء مختلفة: الحكمة (التي كان يُدعى من يمارسها «حكيمًا»)، والكلام (الذي كان يُدعى مَن يمارسه «متكلمًا»).
(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)، كما يرد في القرآن. إن للحكمة، كتعبير، شرعية مقدسة. في الحقيقة، استُخدم تعبير الحكمة في كتابات ابن سينا مرادفًا للفلسفة بين الفينة والأخرى. هكذا، عمد الفلاسفة المسلمون الذين يسعون للنأي بأنفسهم عن الفلاسفة الذين انتقدهم الغزالي إلى التشبث بالتعبير كوصف ذاتي لممارستهم للفلسفة. علاوة على ذلك، وهنا تكمن ملاحظة غريفل الرئيسة، يشير التعبير أيضًا إلى نوع جديد من الفلسفة يميز نفسه عمدًا عن الفلسفة. وتسعى الكتب التي تنتمي لنوع الحكمة إلى تطوير نظام ابن سينا «من الداخل». إنها تنشغل بنقد الغزالي لابن سينا، لكنها ليست مهتمة سوى بالاستدلال الفلسفي؛ سواء كانت الخلاصات تدعم تعاليم الوحي أو تعارضها لم يكن بذي أهمية. كذلك، تقر هذه الكتب ضمنيًّا أن الغزالي، على الرغم من أنه كان مهتمًّا بتعاليم ابن سينا؛ لأنها بدت له معارضة للوحي، فإن نقده لها في «التهافت» كان مبنيًّا على حجج فلسفية سليمة.
في تطور الحكمة كنوع، كانت الشخصية الرئيسة هو يهودي اعتنق الإسلام: أبو البركات البغدادي (توفي 560هـ/1165م). وبعد تكلف عناء إعادة بناء سيرته الذاتية من إحالات متفرقة في مصادر عديدة، أثبت غريفل أن البغدادي كان فيلسوفًا يهوديًّا محترمًا حتى قبل اعتناقه الإسلام في وقت متأخر من حياته؛ يقال: إنه كان في نحو الستين من عمره حينها. مثل كثير من الفلاسفة في تلك الحقبة، كان البغدادي شكليًّا طبيبًا في بلاط الحكّام السلاجقة. وفي حين أن ظروف تحوله للإسلام غير واضحة، ما من شك حول أهمية عمله العظيم «الكتاب المعتبر في الحكمة». يقلع البغدادي، متأثرًا بالغزالي، عن فكرة أن الحقيقة الفلسفية يمكن إثباتها من البرهنة (الاستدلال اليقيني). ويطور كتابه، بدلًا من ذلك، منهجًا مختلفًا: الاعتبار (إمعان النظر) الذي تتم فيه مقارنة خيارات مختلفة من أجل الوصول إلى الأقرب للحقيقة بينها. هكذا، يُدخل البغدادي «انعطافة جدلية» إلى الفلسفة الإسلامية، وخطوةً فكرية تبلغ أوجها في أعمال الموسوعي المسلم الشهير، فخر الدين الرازي (توفي 606هـ/ 1210م).
لا أدرية الرازي
واكد العرض الذى ترجمته سارة حبيب علي ان الرازي هو واحد من الكتّاب الأكثر إنتاجًا وتأثيرًا في تاريخ الإسلام. لقد ألّف كتبًا في حقول الطب، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الفلك، والتاريخ، وغيرها، إلا أن أعماله الأكثر شهرة هي تفسيره القرآن الكريم وكتبه في الفلسفة. وقد أثارت هذه الأخيرة مشكلة عويصة للمؤرخين: يبدو أن الرازي كان يتبنى مواقف فلسفية متناقضة في أعماله المختلفة. على سبيل المثال، اتخذ في بعض النصوص موقفًا يرى أن العالم قديم، ورأى في أخرى أن العالم مُحدَث. فكيف يمكن شرح هذا التباين؟
يقدم غريفل شرحًا ذكيًّا: تتخذ أعمال الرازي المختلفة مواقف مختلفة؛ لأنها تنتمي إلى نوعين مختلفين من الفلسفة في الإسلام: الحكمة والكلام. رأينا تطور الحكمة بعد الغزالي، أما الكلام، أو الحديث، فكان سلفًا نوعًا قائمًا قبل الغزالي بوقت طويل. وهو يشير إلى كتب الخلاف بين الطوائف حول مسائل الميتافيزيقيا، أي نوع من اللاهوت العقلاني. وإسهام الغزالي الرئيس، وفقًا لغريفل، هو إدخال أدوات الفلسفة، ولا سيما المنطق الأرسطي، إلى الكلام. لقد استندت الحكمة، بالطبع، إلى المنطق الأرسطي أيضًا، لكن السمة الرئيسة للكلام هي تأكيده الوحي بوصفه مصدر المعرفة والحكمَ النهائي للحقيقة. شعر الرازي أنه مُطالَب بالإسهام في كلا النوعين، ولم تكن لديه مشكلة في تأييد مواقف مختلفة وفقًا لأنواع مختلفة.
مع هذا، يبقى السؤال قائمًا: أي موقف آمن به فعلًا؟ يعطي غريفل إجابة مذهلة: لم يستطع الرازي أن يختار بينهما. ففي نهاية المطاف، المعرفة الإنسانية محدودة. ببساطة، لم يعطنا الله في بعض المسائل ما يكفي من المعلومات للوصول إلى الحقيقة. والدافع ليس تمامًا دافع إيمانويل كانط (توفي عام 1804م): «إنكار المعرفة من أجل إفساح المجال للإيمان»، لكن المعضلات مماثلة للمعضلات التي دعاها الفلاسفة الأوربيون الشهيرون «تناقضات العقل».
إن التمييز بين الفلسفة، والكلام، والحكمة، ليس من صنع غريفل. فهو يقدم من مجموعة كبيرة من الأدلة لتمييزات مماثلة في مجموعة من قواميس السير الذاتية كُتبت في العقود التالية للغزالي. في الواقع، يشكّل استخدام الكتاب الواسع للمواد المصدرية أحد أكبر نقاط قوته.
فإضافة إلى مجموعة مثيرة للإعجاب من الأعمال الفلسفية وقواميس السير الذاتية التي كتبها مؤلفون مسلمون من العصور الوسطى -كثير منها لا يزال في شكل مخطوطة- يستند غريفل إلى المعرفة الموجودة حاليًّا في عدد من الحقول -علم التأريخ، وعلم الآثار، والدراسات الحضرية- من أجل تقديم أدلة على مشهد فكري مزدهر بعد الغزالي في مناطق تشكّل اليوم جزءًا من إيران، الشرق الأوسط، ووسط آسيا. كذلك، يذكّرنا غريفل بأن الكتّاب يحتاجون رعاية؛ في ذلك الحين، كما اليوم، وأن تأليف كتب الفلسفة غير كافٍ لكسب العيش. ويوضّح أن كثيرًا من الحكومات الحضرية في تلك المناطق عاشت نموًّا اقتصاديًّا في القرن العشرين. فأنفقت على ثقافة نشطة ذات حياة علمية وتعليم عالٍ. وبهذا، يعارض غريفل الفكرة المنتشرة القائلة بأن الغزوات المغولية دمرت الحياة الاقتصادية، وبالتالي، الحياة الفكرية في تلك المدن.
أثر الاستعمار
يحاول غريفل أيضًا أن يتصدى لفكرة أخرى مؤذية بقدر سابقتها يتبناها خطاب وسائل الإعلام الشعبية: أن المدرسة، المؤسسة التقليدية للتعليم العلمي الإسلامي، كانت مغلقة أمام العلوم العقلية كالفلسفة. فبالاستناد إلى أعمال سونيا برينتيس حول تاريخ الرياضيات في المجتمعات الإسلامية، والسير الذاتية للفلاسفة المسلمين، يحاول غريفل أن يُظهر العكس؛ أن المدرسة هي المركز المؤسساتي للفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام. لقد كان نظام المدرسة التقليدي هذا لا يتعطل إلا عندما يوقف المستعمرون الأوربيون الهبات الدينية (الأوقاف) التي تدعم المدرسة؛ تخيلْ أثر مرسوم قانوني يوقف فجأة هبةَ رابطةِ جامعاتِ آيفي البحثية النخبوية. يتابع غريفل ليقول: إن كتب الحكمة كانت تعلَّم في المدرسة لقرون حتى جاءت «اللحظة التي أُدخلت فيها مؤسسات التعليم الاستعمارية وانتشرت الأفكار الغربية حول طبيعة الفلسفة».
تعاني هذه المزاعم الأخيرة نقصًا في التحديد ونقصًا في الأدلة. فمتى هي، بالضبط، «لحظة» القطيعة العظيمة هذه؟ أي مدرسة، على وجه التحديد، كان غريفل يقصد؟ أي كتب فلسفية كانت تاريخيًّا جزءًا من منهاج المدرسة، ومتى أزيلت؟ جدير بالذكر أن المناطق التي تشكّل اليوم الشرق الأوسط، وجنوب آسيا كانت لها تجارب مختلفة مع الاستعمار. وحتى ضمن هذه المناطق الكبيرة، كان للعلماء المسلمين في أمكنة مختلفة ردود أفعال متعددة ومعقدة لضغوطات الاستعمار. ولا يزال من الضروري إجراء المزيد من البحث فيما يخص تطور منهاج المدرسة عبر الزمن في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي؛ لأنه، قبل ذلك، تجازف المزاعم العامة حول مساوئ الاستعمار بدعم موقف يتجنبه المسلمون أنفسهم، وضع اللوم في كل ما هو خاطئ على المستعمرين.
لا تنتقص هذه الانتقادات من قدرِ مناقشة غريفل الرئيسة، بل تكشف قوتها؛ ازدهرت الفلسفة في العالم الإسلامي بعد الغزالي. فكثرة الأعمال الفلسفية في القرن الثاني عشر وما بعده هي ما يجعلنا نفكر: متى، أين، ولماذا، يمكننا تتبع «انحطاط» الفلسفة في العالم الإسلامي، إن كان قد حدث؟ وقبل أن نتساءل: «ما الذي جرى على نحو خاطئ» في المجتمعات الإسلامية، علينا أن نفهم على نحو أفضل «ما الذي حدث؟» الخطوة الأولى نحو تصفية استعمارِ التاريخ هي معرفة التاريخ الذي يتجاوز نظرة المستعمر.
إضافة إلى التأريخي، يرغمنا الكتاب على طرح أسئلة أخرى. لقد أظهر غريفل أن العلماء المسلمين القدماء المؤثرين جمعوا بين معرفة واسعة في العلوم الفلسفية وإتقان لموضوعات أخرى مثل: الحديث والقانون. وكانت إنجازاتهم مزيجًا من هذه الاهتمامات المختلفة. على سبيل المثال، رؤى الرازي في تفسيره للقرآن الكريم مدينة بالفضل لانشغاله بالفلسفة. فإذا كانت تلك هي الحال، ما الذي يخسره المسلمون اليوم عندما يديرون ظهورهم لتقاليد المعرفة التي تُعَدّ «علمانية»؟ اعترف المسلمون، بالطبع، منذ أيام الاستعمار، بالحاجة إلى دراسة مواضيع كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لكن التسويغ بالعموم كان ذرائعيًّا؛ إذا لم يكن بوسعنا بناء طائرات خاصة بنا، كيف سنطير إلى مكة؟ غير أن كتاب غريفل يظهر أن المسألة لا تقتصر على الحاجة إلى دراسة حقول معرفية مختلفة لأجل المنافع المادية التي قد تنطوي عليها في هذا العالم؛ إنها بالأحرى أهمية الدراسة عبر حقول معرفية مختلفة من أجل فهم وحي الله على نحو أفضل. والمهم هنا أن كتاب غريفل يظهر أن العكس صحيح أيضًا: أي أن الفلاسفة -وممارسي العلوم الأخرى- يخسرون شيئًا أيضًا عندما يرفضون الانخراط في تقاليد المعرفة الأخرى، مثل التقليد الفكري الإسلامي.
إن كتاب «تشكّل الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام» هو، أولًا وقبل كل شيء، إسهام بارز في ذلك التقليد. لكن، كما أظهرت هذه المراجعة، إن فيه أيضًا كثيرًا مما يفيد المؤرخين، الفلاسفة، وأي شخص مهتم بكيفية صياغة الأفكار الإشكالية في الحاضر -مثل سرديات الانحطاط- لقراءات الماضي
كان فرانك غريفل، حتى قبل نشر كتابه الأخير، يُعَدّ واحدًا من أبرز دارسي الغزالي في العالم. فبحثه السابق «اللاهوت الفلسفي للغزالي» كسب على السواء استحسان الأوساط الأكاديمية الغربية وحلقات المسلمين المتمسكين بالتقاليد.
، ناقش في كتابه السابق أن آراء الغزالي أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد «رفض» بسيط «لقوانين الطبيعة». هكذا، أدى كتاب غريفل إلى تخفيف حدة الادعاءات التي تقول بأن الغزالي يمكن أن يحمَّل مسؤولية انحطاط (مزعوم) للعلوم الطبيعية في الإسلام بعد القرن الثاني عشر. ويأتي كتابه الحالي ليتمم نقاشاته السابقة ويقدم دحضًا باهرًا لفرضية الانحطاط الفلسفي بعد الغزالي.
إن إستراتيجية غريفل بسيطة: أفضل دليل لإثبات أن الفلسفة لم تمت بعد الغزالي هو وجود الفلاسفة وكتب الفلسفة. ففي أكثر من ست مئة صفحة، يأخذنا غريفل في جولة مشوقة في التاريخ الفكري الإسلامي، مستكشِفًا حيوات وأعمال مجموعة كبيرة من المفكرين المسلمين في العقود اللاحقة للغزالي. في الحقيقة، إن هؤلاء الكتّاب، ونصوصهم، متعددون جدًّا، إلى درجة أننا نتساءل: كيف أمكن للباحثين السابقين أن يغفلوهم؟ وهذا السؤال يعود بغريفل إلى بحثٍ للغزالي استُشهد به مرارًا كإثبات على آراء الغزالي المعادية للفلسفة: «تهافت الفلاسفة».
في «التهافت»، قدّم الغزالي الفلاسفةَ بوصفهم أتباعًا غير نقديين لمواقف ابن سينا الفلسفية. زعم هؤلاء الفلاسفة أن مواقف ابن سينا كانت مبنية على الاستدلال اليقيني (شكلٌ من الجدال يؤدي إلى خلاصات أكيدة منطقيًّا وغير قابلة للدحض). ثم أثبت التهافت بطلان هذا الادعاء، مستخدِمًا مبادئ المنطق الأرسطي ذاتها التي أيدها الفلاسفة. حلّل الغزالي عشرين معتقدًا رئيسًا من معتقدات فلسفة ابن سينا؛ سبعة عشر: وجد فيها هرطقة ضد التعاليم الإسلامية؛ ثلاثة: كفر صريح. وفي الصفحة الأخيرة من الكتاب، أطلق الغزالي فتوى تقول: إن الشخص الذي يعتنق هذه المعتقدات الثلاثة -أبدية العالم، إنكار البعث الجسدي، إنكار معرفة الله بدقائق الأمور- يصبح غير مسلم ويستحق عقوبة الموت.
الفلسفة في ثوب الحكمة وعلم الكلام
رأى كثير من الباحثين الغربيين في الجملة الأخيرة إثباتًا على أن الغزالي كان جزءًا من «تعصب إسلامي» عازم على اضطهاد الفلاسفة. لكن غريفل يناقش بأن الكتّاب الغربيين هنا -كما في مواضع أخرى كثيرة- مذنبون بأنهم بمنتهى السهولة أسقطوا التجربة التاريخية للمسيحية الأوربية على تاريخ الإسلام. لكن، يظهر السجل التاريخي أن فتوى الغزالي كان لها القليل جدًّا من الأثر، في حين أن نقد الغزالي العام لفلسفة ابن سينا كان له تأثير عميق في الفكر الإسلامي. ويمكن ملاحظة هذا في تطورين رئيسين في القرن الثاني عشر. وفقًا لغريفل: «التطور الأول هو أن الفلاسفة الذين كانوا ملتزمين بالتقليد العلمي والنصي للفلسفة كما انحدرت من الإغريق إلى العرب تجنبوا كلمة «فلسفة» واستبدلوا بها كلمة أخرى اتخذت إلى حد كبير المعنى ذاته الذي كان للفلسفة حتى أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي] أي الحكمة[. ثانيًا، نلحظ نشوء نوع مختلف من الفيلسوف أي المتكلم، وهو الشخص الذي يكتب في الفلسفة وينخرط فيها تمامًا كما كان الفلاسفة في القرون السابقة، لكنه يرفض عمدًا سمة فيلسوف، وينأى بنفسه عن الفلسفة».
بكلمات أخرى، كثير من العلماء المسلمين بعد الغزالي كتبوا عن موضوعات مثل الميتافيزيقا، وعلم الأخلاق، واللاهوت. وانشغلوا عمدًا بعلماء سابقين كتبوا عن موضوعات مشابهة. بالتالي، كانت اهتماماتهم الفلسفية وانخراطهم بتقليد فلسفي كافية لوصف أعمالهم على أنها فلسفة. مع هذا، تجنب هؤلاء العلماء تسمية «فلاسفة» لأنفسهم و«فلسفة» لما يمارسونه؛ لأن نقد الغزالي جعل هذه المصطلحات غير ملائمة لذوق العصر. وفي حين أن الفلسفة لم تختفِ تمامًا؛ كان ثمة أولئك الذين استمروا باتباع تعاليم ابن سينا من دون الانشغال بنقد الغزالي، لكنهم لم يشكلوا سوى أقلية بين المجموعات التي كانت تمارس الفلسفة. في النتيجة، عندما بحث الباحثون الغربيون عن الفلسفة في العالم الإسلامي في المدة اللاحقة للغزالي -ما يدعوه الأكاديميون المرحلة ما بعد الكلاسيكية من الإسلام- قصروا بحثهم على الكتب التي عُرِّفت على أنها كتبُ فلسفةٍ، من دون أن يدركوا وجود نوعين آخرين من الفلسفة كانا أكثر إنتاجًا ودُعِيَا بأسماء مختلفة: الحكمة (التي كان يُدعى من يمارسها «حكيمًا»)، والكلام (الذي كان يُدعى مَن يمارسه «متكلمًا»).
(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)، كما يرد في القرآن. إن للحكمة، كتعبير، شرعية مقدسة. في الحقيقة، استُخدم تعبير الحكمة في كتابات ابن سينا مرادفًا للفلسفة بين الفينة والأخرى. هكذا، عمد الفلاسفة المسلمون الذين يسعون للنأي بأنفسهم عن الفلاسفة الذين انتقدهم الغزالي إلى التشبث بالتعبير كوصف ذاتي لممارستهم للفلسفة. علاوة على ذلك، وهنا تكمن ملاحظة غريفل الرئيسة، يشير التعبير أيضًا إلى نوع جديد من الفلسفة يميز نفسه عمدًا عن الفلسفة. وتسعى الكتب التي تنتمي لنوع الحكمة إلى تطوير نظام ابن سينا «من الداخل». إنها تنشغل بنقد الغزالي لابن سينا، لكنها ليست مهتمة سوى بالاستدلال الفلسفي؛ سواء كانت الخلاصات تدعم تعاليم الوحي أو تعارضها لم يكن بذي أهمية. كذلك، تقر هذه الكتب ضمنيًّا أن الغزالي، على الرغم من أنه كان مهتمًّا بتعاليم ابن سينا؛ لأنها بدت له معارضة للوحي، فإن نقده لها في «التهافت» كان مبنيًّا على حجج فلسفية سليمة.
في تطور الحكمة كنوع، كانت الشخصية الرئيسة هو يهودي اعتنق الإسلام: أبو البركات البغدادي (توفي 560هـ/1165م). وبعد تكلف عناء إعادة بناء سيرته الذاتية من إحالات متفرقة في مصادر عديدة، أثبت غريفل أن البغدادي كان فيلسوفًا يهوديًّا محترمًا حتى قبل اعتناقه الإسلام في وقت متأخر من حياته؛ يقال: إنه كان في نحو الستين من عمره حينها. مثل كثير من الفلاسفة في تلك الحقبة، كان البغدادي شكليًّا طبيبًا في بلاط الحكّام السلاجقة. وفي حين أن ظروف تحوله للإسلام غير واضحة، ما من شك حول أهمية عمله العظيم «الكتاب المعتبر في الحكمة». يقلع البغدادي، متأثرًا بالغزالي، عن فكرة أن الحقيقة الفلسفية يمكن إثباتها من البرهنة (الاستدلال اليقيني). ويطور كتابه، بدلًا من ذلك، منهجًا مختلفًا: الاعتبار (إمعان النظر) الذي تتم فيه مقارنة خيارات مختلفة من أجل الوصول إلى الأقرب للحقيقة بينها. هكذا، يُدخل البغدادي «انعطافة جدلية» إلى الفلسفة الإسلامية، وخطوةً فكرية تبلغ أوجها في أعمال الموسوعي المسلم الشهير، فخر الدين الرازي (توفي 606هـ/ 1210م).
لا أدرية الرازي
واكد العرض الذى ترجمته سارة حبيب علي ان الرازي هو واحد من الكتّاب الأكثر إنتاجًا وتأثيرًا في تاريخ الإسلام. لقد ألّف كتبًا في حقول الطب، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الفلك، والتاريخ، وغيرها، إلا أن أعماله الأكثر شهرة هي تفسيره القرآن الكريم وكتبه في الفلسفة. وقد أثارت هذه الأخيرة مشكلة عويصة للمؤرخين: يبدو أن الرازي كان يتبنى مواقف فلسفية متناقضة في أعماله المختلفة. على سبيل المثال، اتخذ في بعض النصوص موقفًا يرى أن العالم قديم، ورأى في أخرى أن العالم مُحدَث. فكيف يمكن شرح هذا التباين؟
يقدم غريفل شرحًا ذكيًّا: تتخذ أعمال الرازي المختلفة مواقف مختلفة؛ لأنها تنتمي إلى نوعين مختلفين من الفلسفة في الإسلام: الحكمة والكلام. رأينا تطور الحكمة بعد الغزالي، أما الكلام، أو الحديث، فكان سلفًا نوعًا قائمًا قبل الغزالي بوقت طويل. وهو يشير إلى كتب الخلاف بين الطوائف حول مسائل الميتافيزيقيا، أي نوع من اللاهوت العقلاني. وإسهام الغزالي الرئيس، وفقًا لغريفل، هو إدخال أدوات الفلسفة، ولا سيما المنطق الأرسطي، إلى الكلام. لقد استندت الحكمة، بالطبع، إلى المنطق الأرسطي أيضًا، لكن السمة الرئيسة للكلام هي تأكيده الوحي بوصفه مصدر المعرفة والحكمَ النهائي للحقيقة. شعر الرازي أنه مُطالَب بالإسهام في كلا النوعين، ولم تكن لديه مشكلة في تأييد مواقف مختلفة وفقًا لأنواع مختلفة.
مع هذا، يبقى السؤال قائمًا: أي موقف آمن به فعلًا؟ يعطي غريفل إجابة مذهلة: لم يستطع الرازي أن يختار بينهما. ففي نهاية المطاف، المعرفة الإنسانية محدودة. ببساطة، لم يعطنا الله في بعض المسائل ما يكفي من المعلومات للوصول إلى الحقيقة. والدافع ليس تمامًا دافع إيمانويل كانط (توفي عام 1804م): «إنكار المعرفة من أجل إفساح المجال للإيمان»، لكن المعضلات مماثلة للمعضلات التي دعاها الفلاسفة الأوربيون الشهيرون «تناقضات العقل».
إن التمييز بين الفلسفة، والكلام، والحكمة، ليس من صنع غريفل. فهو يقدم من مجموعة كبيرة من الأدلة لتمييزات مماثلة في مجموعة من قواميس السير الذاتية كُتبت في العقود التالية للغزالي. في الواقع، يشكّل استخدام الكتاب الواسع للمواد المصدرية أحد أكبر نقاط قوته.
فإضافة إلى مجموعة مثيرة للإعجاب من الأعمال الفلسفية وقواميس السير الذاتية التي كتبها مؤلفون مسلمون من العصور الوسطى -كثير منها لا يزال في شكل مخطوطة- يستند غريفل إلى المعرفة الموجودة حاليًّا في عدد من الحقول -علم التأريخ، وعلم الآثار، والدراسات الحضرية- من أجل تقديم أدلة على مشهد فكري مزدهر بعد الغزالي في مناطق تشكّل اليوم جزءًا من إيران، الشرق الأوسط، ووسط آسيا. كذلك، يذكّرنا غريفل بأن الكتّاب يحتاجون رعاية؛ في ذلك الحين، كما اليوم، وأن تأليف كتب الفلسفة غير كافٍ لكسب العيش. ويوضّح أن كثيرًا من الحكومات الحضرية في تلك المناطق عاشت نموًّا اقتصاديًّا في القرن العشرين. فأنفقت على ثقافة نشطة ذات حياة علمية وتعليم عالٍ. وبهذا، يعارض غريفل الفكرة المنتشرة القائلة بأن الغزوات المغولية دمرت الحياة الاقتصادية، وبالتالي، الحياة الفكرية في تلك المدن.
أثر الاستعمار
يحاول غريفل أيضًا أن يتصدى لفكرة أخرى مؤذية بقدر سابقتها يتبناها خطاب وسائل الإعلام الشعبية: أن المدرسة، المؤسسة التقليدية للتعليم العلمي الإسلامي، كانت مغلقة أمام العلوم العقلية كالفلسفة. فبالاستناد إلى أعمال سونيا برينتيس حول تاريخ الرياضيات في المجتمعات الإسلامية، والسير الذاتية للفلاسفة المسلمين، يحاول غريفل أن يُظهر العكس؛ أن المدرسة هي المركز المؤسساتي للفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام. لقد كان نظام المدرسة التقليدي هذا لا يتعطل إلا عندما يوقف المستعمرون الأوربيون الهبات الدينية (الأوقاف) التي تدعم المدرسة؛ تخيلْ أثر مرسوم قانوني يوقف فجأة هبةَ رابطةِ جامعاتِ آيفي البحثية النخبوية. يتابع غريفل ليقول: إن كتب الحكمة كانت تعلَّم في المدرسة لقرون حتى جاءت «اللحظة التي أُدخلت فيها مؤسسات التعليم الاستعمارية وانتشرت الأفكار الغربية حول طبيعة الفلسفة».
تعاني هذه المزاعم الأخيرة نقصًا في التحديد ونقصًا في الأدلة. فمتى هي، بالضبط، «لحظة» القطيعة العظيمة هذه؟ أي مدرسة، على وجه التحديد، كان غريفل يقصد؟ أي كتب فلسفية كانت تاريخيًّا جزءًا من منهاج المدرسة، ومتى أزيلت؟ جدير بالذكر أن المناطق التي تشكّل اليوم الشرق الأوسط، وجنوب آسيا كانت لها تجارب مختلفة مع الاستعمار. وحتى ضمن هذه المناطق الكبيرة، كان للعلماء المسلمين في أمكنة مختلفة ردود أفعال متعددة ومعقدة لضغوطات الاستعمار. ولا يزال من الضروري إجراء المزيد من البحث فيما يخص تطور منهاج المدرسة عبر الزمن في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي؛ لأنه، قبل ذلك، تجازف المزاعم العامة حول مساوئ الاستعمار بدعم موقف يتجنبه المسلمون أنفسهم، وضع اللوم في كل ما هو خاطئ على المستعمرين.
لا تنتقص هذه الانتقادات من قدرِ مناقشة غريفل الرئيسة، بل تكشف قوتها؛ ازدهرت الفلسفة في العالم الإسلامي بعد الغزالي. فكثرة الأعمال الفلسفية في القرن الثاني عشر وما بعده هي ما يجعلنا نفكر: متى، أين، ولماذا، يمكننا تتبع «انحطاط» الفلسفة في العالم الإسلامي، إن كان قد حدث؟ وقبل أن نتساءل: «ما الذي جرى على نحو خاطئ» في المجتمعات الإسلامية، علينا أن نفهم على نحو أفضل «ما الذي حدث؟» الخطوة الأولى نحو تصفية استعمارِ التاريخ هي معرفة التاريخ الذي يتجاوز نظرة المستعمر.
إضافة إلى التأريخي، يرغمنا الكتاب على طرح أسئلة أخرى. لقد أظهر غريفل أن العلماء المسلمين القدماء المؤثرين جمعوا بين معرفة واسعة في العلوم الفلسفية وإتقان لموضوعات أخرى مثل: الحديث والقانون. وكانت إنجازاتهم مزيجًا من هذه الاهتمامات المختلفة. على سبيل المثال، رؤى الرازي في تفسيره للقرآن الكريم مدينة بالفضل لانشغاله بالفلسفة. فإذا كانت تلك هي الحال، ما الذي يخسره المسلمون اليوم عندما يديرون ظهورهم لتقاليد المعرفة التي تُعَدّ «علمانية»؟ اعترف المسلمون، بالطبع، منذ أيام الاستعمار، بالحاجة إلى دراسة مواضيع كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لكن التسويغ بالعموم كان ذرائعيًّا؛ إذا لم يكن بوسعنا بناء طائرات خاصة بنا، كيف سنطير إلى مكة؟ غير أن كتاب غريفل يظهر أن المسألة لا تقتصر على الحاجة إلى دراسة حقول معرفية مختلفة لأجل المنافع المادية التي قد تنطوي عليها في هذا العالم؛ إنها بالأحرى أهمية الدراسة عبر حقول معرفية مختلفة من أجل فهم وحي الله على نحو أفضل. والمهم هنا أن كتاب غريفل يظهر أن العكس صحيح أيضًا: أي أن الفلاسفة -وممارسي العلوم الأخرى- يخسرون شيئًا أيضًا عندما يرفضون الانخراط في تقاليد المعرفة الأخرى، مثل التقليد الفكري الإسلامي.
إن كتاب «تشكّل الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام» هو، أولًا وقبل كل شيء، إسهام بارز في ذلك التقليد. لكن، كما أظهرت هذه المراجعة، إن فيه أيضًا كثيرًا مما يفيد المؤرخين، الفلاسفة، وأي شخص مهتم بكيفية صياغة الأفكار الإشكالية في الحاضر -مثل سرديات الانحطاط- لقراءات الماضي
















