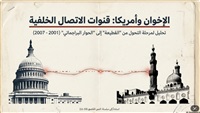الميراث بين الثابت الديني والمتحول الاجتماعي: قراءة نقدية لبيان دار الإفتاء المصرية
الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 04:35 م
طباعة
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حاسمًا ضد الدعوات المتكررة للمساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة، معتبرةً تلك الدعوات ستارًا لهدم الثوابت الدينية وتمييع الأحكام القطعية التي قررها القرآن الكريم. البيان ــ كما هو متوقع من جهة دينية رسمية ــ تمسك بالنصوص القرآنية بوصفها أحكامًا توقيفية لا يجوز تغييرها، ورفض فكرة إخضاعها للتصويت الشعبي أو الاجتهاد المجتمعي. لكنه في المقابل، طرح تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة بين النص الديني والتطور الاجتماعي، وحدود الثابت والمتحول، خاصة في ضوء التجارب الإسلامية المعاصرة.
أولاً: ما بين النص الديني وواقع العصر
ينطلق بيان الإفتاء من فرضية أن "أحكام الميراث قطعية"، وهو ما يجعلها ـ بحسب البيان ـ لا تقبل الاجتهاد ولا التطويع. إلا أن هذا الطرح يتجاهل أن التشريع الإسلامي في جوهره لم يُؤسس على الجمود، بل على الموازنة بين الثوابت القطعية والمتغيرات الظرفية. فالنصوص القطعية في الميراث تمثل الهيكل العام، لكن الفقهاء الكبار عبر العصور لم يمتنعوا عن الاجتهاد ضمن هذا الهيكل، بما يتناسب مع تغير السياقات والأحوال.
إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي لحقت بالمرأة، جعلت مساهمتها في بناء الأسرة والدولة مساوية ـ وأحيانًا تفوق ـ الرجل، وهو ما يطرح ضرورة إعادة النظر في التوزيع التقليدي للميراث باعتباره انعكاسًا لوضع اجتماعي لم يعد قائمًا في كثير من الحالات. فهل من العدل أن تحصل امرأة أنفقت على أهلها وتعول أسرتها على نصف ما يحصل عليه شقيقها الذي لا يتحمل أية أعباء؟
ثانيًا: الفرضية الفقهية والجدل القانوني
ما يطرحه دعاة المساواة ليس نقضًا للنص، بل تساؤلًا حول آلية تطبيقه في ظل التحولات الاجتماعية. إن القول بأن "التبرع لا يصنع تشريعًا" صحيح في بنيته الفقهية، لكنه لا يكفي لحسم النقاش. فالقانون لا يتأسس فقط على الأحكام الدينية، بل على المصلحة العامة وتطور المجتمع. القانون المدني لا يستمد شرعيته من النصوص الدينية فقط، بل من التوافق الاجتماعي والعدل النسبي، وهو ما فعلته تركيا وتونس في هذا المجال.
ثالثًا: تونس وتركيا... اجتهادان في قلب العالم الإسلامي
تونس، في ظل قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الحبيب بورقيبة عام 1956، وبعده مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي عام 2017، طرحت نقاشًا عامًا حول المساواة في الميراث، انطلاقًا من الفصل 21 من الدستور التونسي الذي ينص على المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات. وقد تبنت لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE) تقريرًا يدعو إلى تعديل نظام المواريث بما يحقق العدالة الاجتماعية لا فقط الانضباط للنص الديني. رغم التراجع لاحقًا عن تمريره برلمانيًا، إلا أن النقاش ظل قائمًا، وأصبحت المساواة خيارًا مطروحًا قانونيًا في حالات معينة.
أما تركيا، فقد تبنت منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك قانونًا مدنيًا علمانيًا (مأخوذ من القانون السويسري)، يقوم على المساواة الكاملة بين الجنسين، بما في ذلك الميراث. هذا التعديل لم يمنع المجتمع التركي ـ المتدين بطبيعته ـ من التعايش مع القانون، بل أدى إلى دمج الدين بالحياة المدنية دون صدام.
هاتان التجربتان تبيّنان أن الاجتهاد في الميراث ليس بدعة، بل ضرورة فقهية ومجتمعية لتجاوز الجمود والنظر في العدالة الاجتماعية بصفتها مقصدًا شرعيًا أساسيًا، لا عدوًا للنص.
رابعًا: الحركات النسوية وشرعية المطالبة
يتعامل البيان مع مطالبات الحركات النسوية بوصفها "زعزعة لقدسية النص"، بينما هي في الحقيقة دعوة لإعادة ترتيب العلاقة بين الأحكام الدينية وواقع النساء. فالحركة النسوية الإسلامية نفسها ـ كما عبّرت عن ذلك مفكرات مثل أمينة ودود، وفاطمة المرنيسي ـ لا ترفض النص، لكنها تطالب بتفسيره من زاوية عدالة النوع الاجتماعي. أما النسويات العلمانيات فيعتمدن على المرجعية الحقوقية الدولية والدساتير الوطنية التي تضمن المساواة التامة في الحقوق.
الخطاب الديني في هذا السياق لا يزال مأسورًا بثنائية "الحق والواجب" و"المباح والمحظور"، بينما تتجاوز مطالب المساواة هذه الثنائية إلى أفق أوسع يتعلق بكرامة الإنسان، وإعادة النظر في ترتيب الأولويات في مجتمع تغيرت بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
خامسًا: بين الفريضة الشرعية والحق القانوني
يرى البيان أن تحويل التبرع إلى قانون هو "ظلم"، لأن الأخ سيلزم بإعطاء أخته ما لم يفرضه الشرع. لكن يغيب هنا أن القوانين الحديثة لا تفرض الإلزام إلا حين يوجد نص تشريعي واضح، وهي تصدر بعد حوارات مجتمعية طويلة وليست اعتباطية. فالتحول من "حق التبرع" إلى "قانون المساواة" ليس اعتداءً على الدين، بل إعادة صياغة لعلاقة الدولة بمواطنيها. القانون لا يمنع أحدًا من الالتزام بنصوص الشريعة، لكنه يفتح مجالًا للعدالة المدنية.
ختامًا: نحو فقه جديد للعدالة الاجتماعية
إن بيان دار الإفتاء ــ رغم حرصه على حماية النص الديني ــ إلا أنه أغفل المصلحة المتجددة للمجتمع، ولم يفرّق بين الثابت الأصولي والمتحول الفقهي. لقد حان الوقت لإطلاق نقاش موسّع تشارك فيه المؤسسات الدينية، والمراكز البحثية، والحركات النسوية، لصياغة فقه اجتماعي جديد، لا يصطدم بالنص، لكنه يقرأه في ضوء مقاصد الشريعة الكبرى: العدل، والرحمة، والمساواة.
فالمجتمعات لا تُحكم فقط بالنصوص، بل بالتوازنات الدقيقة بين القيم الدينية والمبادئ المدنية، وهذا ما ينبغي أن تسعى إليه المؤسسات الدينية، لا أن تحكم بالإقصاء على كل من يطرح أسئلة مختلفة.