علي عبد الرازق.. ومعركته "الإسلام وأصول الحكم"
الإثنين 12/أغسطس/2024 - 09:00 ص
طباعة
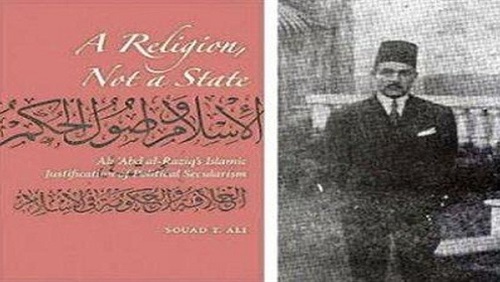 حسام الحداد
حسام الحداد
على حسن أحمد محمد عبد الرازق، الشيخ مواليد البهنسا، أبو جرج، محافظة المنيا، 1888 – توفي بالقاهرة، 23 سبتمبر 1967. مفكر وأديب مصري كبير درس في الأزهر وفي نفس الوقت في الجامعة المصرية، وأخد شهادة العالمية من الأزهر سنة 1912. سافر إلى انجلترا ودرس في جامعة أوكسفورد السياسة والاقتصاد ورجع مصر بعدما قامت الحرب العالمية الأولى. اشتغل في القضاء في المحاكم الشرعية وبقي عضوًا في مجلس النواب والشيوخ وعُين وزيرًا للأوقاف. كان عضوًا في المجمع اللغوي، وله مؤلفات مهمه في الأدب والفلسفة. ناقش في كتابه "الإسلام وأصول الحكم " فكرة الخلافة والحكومة في الإسلام فعمل ضجة كبيرة، وحكم عليه بتجريده من شهادة العالمية الأزهرية. كان الملك فؤاد الأول يتطلع لمنصب خليفة المسلمين وهو الذي كان خلف محاكمته.
نشأته

ولد علي عبد الرازق في قرية أبو جرج في محافظة المنيا سنة 1888. أبوه حسن باشا عبد الرازق درس في الأزهر، وكان عضوًا في المجالس شبه النيابية، بعدما علم في كتاب القرية وحفظ القرآن أدخله أبوه الأزهر في القاهرة لإكمال تعليمه، ولما فتحت الجامعة المصرية التحق بها ودرس فيها بجانب دراسته في الأزهر. سنة 1912 أنهى تعليمه في الأزهر وحصل على شهادة العالمية، وفي يوليه من نفس العام سافر مع أخيه مصطفى عبد الرازق على فرنسا ليكمل دراسته هناك، لكنه ترك أخاه في فرنسا وذهب إلى انجلترا نزولًا على رغبة والده، فدخل جامعة أوكسفورد ودرس السياسة والاقتصاد، وظل هناك حتى قيام الحرب العالمية الأولى فعاد إلى مصر سنة 1915، وعين قاضى شرعي وظل في هذا العمل في محكمة المنصورة الشرعية إلى أن نشر كتابه المشهور "الإسلام واصول الحكم ".
معركة الإسلام وأصول الحكم

فكتاب الإسلام وأصول الحكم هو الكتاب الأكثر ليبرالية وشجاعة؛ ولأنه أتى من أزهري ينحدر من أسرة عريقة بما جعله وثيق الصلة هو وشقيقه مصطفى بحزب كبار الملاك العقاريين "الأحرار الدستوريين". ثم لأن الكتاب أغضب الكثيرين فكانت محاكمة مثيرة أمام هيئة كبار العلماء.. وضجيجًا مايز بين مواقف الكثير من القوى السياسية.
وبدأ الشيخ كتابه بكلمة لماذا؟ وأجاب بأن هناك سؤالين ألحا على تفكيره وهما "هل الخلافة أصل من أصول الدين؟ وهل الإسلام أو غيره من الأديان يمكن أن يكون نظاماً للحكم في العصر الحدث؟ وبدا الشيخ في إجابته ذا توجهات ليبرالية بامتياز. فهو متعمق في دراسة الفقه أي أنه من أهل الاختصاص، وليس مجرد واحد من الليبراليين الذين أدركوا قيمة الفكر التجديدي، ولكنه أضاف إلى معرفته بالفقه وبصحيح الإسلام دراسة في الجامعة المصرية تخصص فيها في الأدب والفلسفة، ثم دراسة في أكسفورد مستهدفاً التخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية لكنه قطعها بسبب نشوب الحرب. [د. غالي شكري – النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث – ص 238]، ثم إنه فوق ذلك انتسب هو وشقيقه الشيخ مصطفى إلى مجموعة ليبرالية ضمت عديداً من الشبان منهم محمود عزمي – عزيز ميرهم – د. منصور فهمي– د. محمد حسين هيكل وغيرهم [فهمي جدعان – أسس التقدم عند مفكري الإسلام – ص568]، وقد بدأت هذه المجموعة نشاطاً فكرياً مهما، فنقرأ لمحمد حسين هيكل "ومرت الأيام وأنا أرى في مدينة النور ألواناً من الحياة تفسح أمام النظر أفق التفكير وتزيد الإنسان إيماناً بحرية العقيدة والرأي، وبأن التعصب ذميم وأن أول واجب للإنسان أن يديم البحث عن الحقيقة" [مجلة اللغة العربية (مجموعة 1962) كلمة شفيق غربال في تأبين الدكتور هيكل – صـ212] كما قام هيكل بترجمة عدة أجزاء من كتاب جان جاك روسو ونشرها بإهداء "إلى مصر الحرة، وإلى القلوب الخافقة بمعاني الحرية والعدالة والإخاء" [المرجع السابق – ص216].
أما الشيخ مصطفى عبد الرازق فقد أصدر مع مجموعة من الشباب الأزهريين الليبراليين مجلة "السفور" لتدعو إلى التجديد في فهم الدين والحياة. وقد نادت هذه الجماعة إلى تأسيس حزب. ويروى أحد الداعين لتأسيسه وهو محمود عزمي القصة قائلاً: "حدثني د. منصور فهمي عن تأسيس حزب سياسي تحدث بشأنه بالفعل إلى بعض أصدقائه، وتم التفاهم فيما بينهم عليه وعلى الاسم الذي سيطلقونه عليه وهو "الحزب الاشتراكي" ولكنني أقنعته بأن يعدل تسمية المولود الجديد بالحزب الاشتراكي، وأن يسمى الحزب الديمقراطي" [محمود عزمي – خبايا سياسية – ص 36] ونشأ الحزب ولكن وسط خلاف بين مؤسسيه، ونقرأ ما قاله شفيق غربال: "نشأ الحزب في جو من النشاط السياسي في إطار ثورة 1919 وحاول ميرهم أن يتجه بالحزب إلى الاشتراكية بينما حاول هيكل أن يتجه به نحو الفردية، وكاد الخلاف أن ينهى الحزب لولا تدخل الشيخ مصطفى عبد الرازق للتوفيق بين الرأيين" [مجلة اللغة العربية – المرجع السابق – ص218] . وتأسس الحزب الديمقراطي يوم 10-9-1919 وعقد الاجتماع التأسيسي في منزل آل عبد الرازق، وأصدر برنامجاً أسمى قانون الحزب جاء فيه "تفويض الشعب سلطته إلى هيئة نيابية تنتخب على أكمل وجه ويكون من اختصاصها التشريع وفرض الضرائب ومحاسبة الحكومة المسئولة أمامها – توحيد التشريع في حدود مصر وتعميم تطبيقه على كل من يسكن البلاد . [بمعنى إخضاع الأجانب للتشريع المصري – وأن يكون التشريع وضعياً ومدنياً ويكفل حقوق المسلمين والمسيحيين معاً] – ترقية الطبقات العاملة أدبياً ومادياً وإعانة من لا يستطيع العمل" . [راجع النص الكامل للبرنامج في الطليعة – عدد فبراير 1965]. ويشرح عزيز ميرهم فلسفة الحزب قائلاً: "إن الحزب لم يأخذ باعتبار أن الديمقراطية مسألة سياسية فحسب بل عدها سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى هذا لا تعتبر البلاد الأوربية ديمقراطية بالمعنى الصحيح، لأن الشطر الأكبر من الثروة يستأثر به عدد ضئيل، بينما المنتجون الحقيقيون لهذه الثروة محرومون من كد يدهم وثمرة ذهنهم" . [عزيز ميرهم – الديمقراطية – ص8] .. ولم يدم هذا الحزب طويلاً – إذ ما لبث أن تفرق [راجع تفاصيل نشأة ونهاية الحزب الديمقراطي في: د. رفعت السعيد- تاريخ الحركة الشيوعية المصرية – الجزء الأول – الطبعة السادسة (1956) – ص117] .. وعبر هذا المسار الذي انغمس فيه الشيخ علتت عبد الرازق أتى كتاب الإسلام وأصل الحكم.
ونأتي إلى الكتاب الذي تفجر في وجوه كثيرة. ويبدأ الشيخ علي عبد الرازق متسائلاً: ما هو سند الخلافة؟ هل القرآن؟ أم السنة؟ أم إجماع المسلمين؟ ويقول: القرآن والسنة لم يتعرضا مطلقاً لموضوع الخلافة، لأنها لم تكن أبداً حكماً من أحكام الدين الإسلامي، كما أن الإجماع في التاريخ الإسلامي لم ينعقد أبداً على خليفة. ثم يقول: "ليس بنا حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا، ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين".. "فالحكم والحكومة والقضاء والإدارة ومراكز الدولة هي جميعاً خطط دنيوية، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة" [صـ102]. ويؤكد أن القرآن والسنة لم يرد فيهما أي ذكر لفكرة الخلافة كنظام سياسي ملزم للمسلمين، "وكل ما جرى في أحاديث الرسول الكريم من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة لا يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكم قيصر" [صـ19] ويؤكد أن الخلافة لا تقوم إلا على القهر والظلم "وإذا كان في الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد والظلم، ويسهل عليه العدوان والبغي، فذلك هو مقام الخلافة، وقد رأيت أنه أشهى ما تتعلق به النفوس، وأهم ما تغار عليه، وإذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة وأمدتها القوة البالغة، فلا شيء إلا العسف ولا حكم إلا السيف" [ص28] ثم يعود فيكرر: "ذلك أن شعائر الله تعالي ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، وأولئك الذين يسميهم الناس خلفاء، فليس من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا، ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك، فإنما كانت الخلافة ولا تزال نكبة على الإسلام والمسلمين، وينبوع شر وفساد [ص36]، ويفرق الشيخ بين ولاية الرسول وولاية الحاكم أو الخليفة "فولاية المرسل إلى قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعاً صادقاً تاماً يتبعه خضوع الجسم، ولا الحاكم ولاية مادية تعتمد على إخضاع الجسم من غير أم يكون لها بالقلب اتصال". [ص69] ثم "إن القرآن صريح في أن سيدنا محمد لم يكن إلا رسولا خلت من قبله الرسل، ثم إن القرآن بعد ذلك صريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، وأنه لا يكلف شيئاً غير ذلك البلاغ وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به، ولا أن يحملهم عليه" [ص73]. ثم هو يوضح أن الرسول لم يعين من بعده خليفة وأن الذين تزعموا المسلمين من بعده ومن بينهم الخلفاء الراشدون كانت زعامتهم مدنية أو سياسية وليست دينية، وإن أبى بكر هو الذي أسمى نفسه خليفة، وأن بيعته كانت ثمرة لجدال ثم اتفاق سياسيين ومن ثم كان حكمه مدنياً وكان اجتهاده دنيوياً ولا علاقة له بفكرة الدولة الدينية" ويمضى كل الكتاب على هذا المنوال بما دفع أحد الباحثين إلى القول بأن كتاب الإسلام وأصول الحكم "يمثل موقفاً راديكاليا، وهو أبعد من أن يكون بحثاً عن نصوص دينية تحرم الكهنوت والاستبداد. وأنه أبعد من محاولة التوفيق بين نصوص الشريعة وبين مبادئ الحضارة الغربية، بل هو أول دراسة للحقيقة الدينية وارتباطها بشريعة السلطة السياسية كما أنه أول نقد يظهر التضامن التاريخي بين الفكر الثيولوجي والبنى السياسية والسلطوية التي استخدمت الأديان من أجل بناء الإمبراطوريات [محمد أركون – فك الارتباط ما بين اللاهوت والسلطة – دراسة بمجلة تحولات – العدد 4 [1991] . ولهذا كانت الضجة التي صاحبت صدور الكتاب وهي ضجة أحدثت صخباً وأزمات وتداعيات تستحق أن نتحدث منها فيما يلي.

والحقيقة أن "الإسلام وأصول الحكم" قد أحدث زلزالًا فكريًا وسلطويًا حرك المياه الراكدة في بحيرة الليبرالية المصرية، فتحركت أقلام عديدة لمساندته وقوى عاصفة أخرى لإدانته . فقد انحاز حزب الأحرار الدستوريين [وهو حزب كبار الملاك العقاريين] ربما بسبب علاقة تاريخية لمساندة الشيخ في مواجهة حملة عاصفة وظالمة، وأتت مجلة الهلال إلى صف الشيخ وتقول "إن كل أمه إسلامية حرة في انتخاب من تريده حاكمًا عليها وسواء كان الأستاذ على عبد الرازق قد وفق في أن يسند نظريته إلى الدين – كما يعتقد – أم لم يوفق، فإن هذه النظرية تتفق وأصول الحكم في القرن العشرين الذي يجعل السيادة للأمة دون سواها من الإفراد مهما كانت ولادتهم وميزاتهم الأخرى . [الهلال – يوليو 1925] ويكتب سلامه موسى في الهلال أيضًا "لعلي عبد الرازق الحق في أن يكون حرًا يرتئي ما يشاء من الآراء دون أن يقيد بأي قيد سوى الإخلاص" [الهلال – أكتوبر 1925] وتشترك "المقتطف" في حملة التأييد فتقول: "إننا نعتقد أن كل ما قاله حضرة القاضي على عبد الرازق وأمثاله قرين الصواب وخال من الخطأ . كذلك فإن قيام بعض المفكرين ووقوفهم موقف الانتقاد والشك يشحذ الهمم ويغري بالبحث والتنقيب" [المقتطف – أغسطس 1925] . ويكون مثيراً للدهشة أن يتصور المعارضون للكتاب من غير الأزهريين أنه هو سعد زغلول باشا زعيم حزب الوفد الليبرالي التقليدي فقد كتب سعد "قرأت كثيراً للمستشرقين ولسواهم فما وجدت من طعن منهم في الإسلام بمثل هذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ على عبد الرازق، ولقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظريته [نقلاً عن – د. غالى شكري – النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث – ص 244] .. ويتعين هنا أن نتأمل الخريطة المصرية المرتبكة فحزب كبار الملاك الموالي للملك الطامع في الخلافة يؤيد الشيخ وكتابه . أما سعد زغلول الليبرالي والذي رفض تنصيب الملك فؤاد خليفة وهاجم "مؤتمر الخلافة" يقف ضد الشيخ وكتابه . وهي خريطة أربكت الكثير من الباحثين خاصة بعد أن تسببت مساندة حزب الأحرار الدستوريين ورموزه للشيخ وكتابه في أزمة وزارية عارمة وتسببت في استقالات وزارية . وعلى أيه حال فإن معركة الصراع مع الشيخ وكتابه قد تجاوزت حدود مشادات كلامية أو مناكفات حزبية بين خصوم تقليديين، خاصة أن الأزهر بمكانته قد دخل بكل ثقلة في المعركة مستندًا إلى الملك فؤاد الذي كان حلم الخلافة يراوده ويقض مضجعه .. ولعل ما يثير الدهشة ويزيد من إرباك الخريطة المصرية هو موقف أحمد شوقي .. الذي اعتبره الكثيرون محسوبًا على القصر الملكي في كثير من الأحيان .
ونقرأ لأحمد شوقي قصيدة هي خير من ألف مقال .
مضت الخلافة والإمام فهل مضى .. ما كان بين الله والعُبَّاد
والله ما نسىَّ الشهادة حاضرٌ .. في المسلمين ولا تردد بادى
والصوم باق والصلاة مقامة .. والحج ينشط في عناق الحادي

وتردد الأزهر قليلاً في المعركة ربما منتظرًا الضوء من الملك وتململ رشيد رضا، فكتب "لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عن هذا الكتاب لئلا يقول الشيخ وأنصاره أن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه [المنار – 21يونيو 1925 – مجلد 26 – ص104] . ويثمر هذا التحريض الواضح معركة ضارية هزت أركان مصر .
ومع صيحات الهجوم على كتاب "الإسلام وأصول الحكم" خاصة تلك التي أطلقها الزعيم سعد زغلول والتي اتهم فيها الشيخ على عبد الرازق بأنه جاهل بقواعد دينه وبالبسيط من نظريته، استأسد الكثيرون والذين كانوا يتحينون الفرصة لإرضاء الملك فؤاد المتطلع للخلافة ولإرضاء خيالاتهم الرجعية، وإنبرى الشيخ محمد رشيد رضا محرضاً الجميع "لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه لئلا يقول هو وأنصاره أن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه [المنار – 21 يونيو 1925 – مجلد 26 – صـ104] ثم أسرع الشيخ محمد بخيت بطبع كتاب أعده على عجل متهمًا الشيخ عبد الرازق بأنه بكتابه "يريد أن يعطل الأداة التي يمكن بها إحداث التغيير والتطوير في الإسلام، كما أنه يفضى في آخر الأمر إلى إنكار الشريعة ذاتها" [محمد أحمد حسين – المرجع السابق – صي85] ثم يأتي الشيخ الخضر حسين ليصدر كتاباً بعنوان "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم" وأهداه إلى "خزانه صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر الأعظم برجاء التفضل بالقبول" وبعد الإهداء يأتي الاستعداء على ذات صفحة الإهداء "والصلاة والسلام على النبي وآله، وكل من حرس شريعته بالحجة والحسام" [الشيخ الخضر حسين – نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم – صـ1] كما أصدر الشيخ محمد الظاهر عاشور كتابًا امتلأ بشحنات من الهجوم الظالم والظلامي ضد على عبد الرازق [محمد الطاهر عاشور – نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم – 1344هـ] وعديد من الكتابات والمقالات والكتب احتشدت جميعاً لتهاجم الرجل . ثم تكون القمة في العداء عندما اجتمعت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر محمد أبو الفضل بحضور 24 عضوًا، واستدعت الشيخ وحاكمته باعتباره عضوًا فيها وحاصلًا على شهادة العالمية وقاضيًا شرعيًا، وبعد ساعتين من الجدل والنقاش مع آذان صماء أصدرت المحكمة قرارها "اجتمعت هيئة كبار العلماء في 12 أغسطس 1925، وقررت نزع شهادة العالمية من الشيخ على عبد الرازق ومحو اسمه من سجلات الجامع الأزهر وطرده من كل وظيفة لعدم أهليته للقيام بأية وظيفة دينية أو غير دينية . [راجع النص الكامل للحكم في: د. رفعت السعيد – الإرهاب إسلام أم تأسلم – ص253] وعقب صدور الحكم أسرع شيخ الأزهر بالإبراق إلى الملك "شاكراً له غيرته على الدين من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وحفظ كرامة العلم والعلماء" [محمد رجب البيومي – الأزهر بين السياسة وحرية الفكر – ص115] وأُرسل القرار إلى عبد العزيز فهمى باشا وزير العدل لتوقيعه والتصديق عليه لكن عبد العزيز فهمى رفض التوقيع متخذًا موقفًا شجاعًا ليس فقط في مواجهة الأزهر وشيخه وهيئة كبار علمائه وإنما أيضًا في مواجهة الملك، الذي يصطف حزب الأحرار الدستوريين الذي يشارك الباشا في عضوية قيادته في دفاعه عنه وضد حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول وكتب "استحضرت هذا الكتاب وقرأته مرة وأخرى فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه، بل على العكس وجدته يشيد بالإسلام ونبي الإسلام ويقدس النبي تقديسًا تامًا ويشير إلى أن النبوة هي وحى من عند الله والوحى لا خلافة فيه، ومن ثم ثقل على ذمتي أن أنفذ هذا الحكم الذي هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء، وفي جريمة الاتهام بالخطأ في الرأي من عالم مسلم يشيد بالإسلام، وكل ما في الأمر أن هؤلاء الذين يتهمونه يتأولون في تفسير أقواله كلها، وانتهت هذه الغضبة باستقالة عبد العزيز فهمى ومعه ثلاثة وزراء هم محمد على علوبة باشا وتوفيق بك دوس وإسماعيل بك صدقي . واشتعلت الأزمة، وتفجرت معها مفارقة مثيرة للدهشة .. حلفاء الملك من كبار الملاك يدافعون عن الليبرالية ويدافعون عن الشيخ وكتابه وخصم الملك اللدود سعد زغلول يقف ضد الكتاب أي في صف الملك .
غير أن الكتاب اثار جدلاً من نوع آخر، حين أعلن الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو مجمع البحوث الإسلامية في 1989 بما أسر له به الشيخ على عبد الرازق من أن المؤلف الحقيقي للكتاب هو د. طه حسين وليس على عبد الرازق، وكان ذلك فيما بين 1942، 1948، ولأن الشيخ مسلم رجل لا غبار عليه فقد أثارت شهادته الأوساط الثقافية والدينية، وشككوا في هذه الشهادة على الرغم من وجود خبر أن الشيخ علي عبد الرازق قد تراجع عما جاء في كتابه قبل وفاته والذي نفته قطعا ابنته د.سعاد علي عبد الرازق، مؤكدة أن والدها لم يتراجع وإنه يملك من الشجاعة ما يجعله يواجه الناس بتراجعه ويعلن موقفه الجديد على الملأ.
وفى يونيو 1966 وقبل وفاة الشيخ على عبدالرازق بشهور قليلة ذهب إليه الأستاذ محمود أمين العالم يستأذنه في إعادة طبع كتابه فكان سعيدًا وحريصًا على أن يؤكد له أنه ما تخلى ولن يتخلى عن كتابه أبداً، وكان الحديث عن إعادة طبع الكتاب قد أثارت في نفسه الجرح القديم فقال له: لم" أعد احتمل مغامرة جديدة، اطبعوا الكتاب على مسئوليتكم، ولا تطلبوا منى إذنًا بغير ضمان أكيد اطمئن إليه.
وهذا معناه أن الشيخ على عبد الرازق قد وافق على إعادة طبع الكتاب، ومعناه أنه لم يتراجع عن أفكاره وتبقى قضية نسبة الكتاب إلى طه حسين وشهادة الشيخ مسلم في ذلك لغزاً ربما تنجلي أسبابه يوما ما.
مؤلفاته

أمالي علي عبد الرازق.
الإجماع في الشريعة الإسلامية.
من آثار مصطفى عبد الرازق.















