حول "القرآن من النص إلى الخطاب".. حسام الحداد: "نصر أبو زيد" من الاجتهاد إلى التجديد"
الثلاثاء 26/مايو/2015 - 10:23 م
طباعة
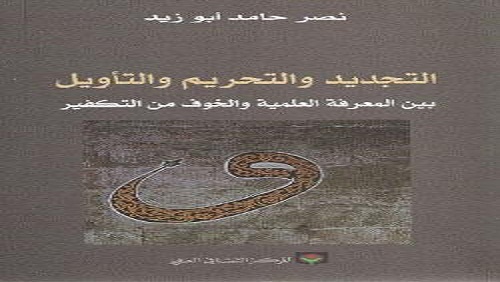 حسام الحداد
حسام الحداد
عقدت مؤسسة الدكتور نصر حامد أبو زيد، أمس الاثنين 25 مايو 2015، ورشةً فكرية ونقدية، بعنوان "القرآن مِن النص إلى الخطاب"، تناول خلالها المتحدثون عددًا من القراءات والمقاربات النقدية حول القرآن من النص إلى الخطاب نحو تأويلية إنسانوية.. وهو الفصل الأخير من كتاب نصر حامد ابو زيد "التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التفكير"، حيث عقدت الورشة بمقر المؤسسة.
وجاءت مشاركة الباحث حسام الحداد بورقة عنوانها: "نصر أبو زيد، من الاجتهاد إلى التجديد وارتباط النص بالواقع"
هناك الكثير من القضايا التي شغلت تفكير الراحل نصر حامد أبو زيد خلال مشواره الفكري والبحثي، تتصل بالتجديد والتراث والتأويل وسواها. وكان الهاجس الرئيس لديه يتمحور حول كيفية استنهاض الإنسان العربي، من خلال وضعه ضمن رهان الوعي المعاصر، بمختلف إشكاليات وقضايا الإنسان والحرية، والنظر إليه بوصفه كائناً فاهماً، ولا تتحقق إنسانيته إلا في إطار وعي عام بمسألة الحرية، وأن يكون حراً ضمن شروط وجوده كائناً لغوياً، مع الأخذ في الاعتبار أن الوعي هو مفتاح الفهم، ورأسمال رمزي للإنسان، ومتعلق بما يكونه إنساناً، وبما يشكل فهم الإنسان لعالمه ومحيطه، أو للمجال الثقافي والاجتماعي الذي يوجد فيه.
وظل ابو زيد ينظر إلى التجديد بوصفه حاجة دائمة، وسيرورة اجتماعية وسياسية وثقافية، ومن دونه تتجمد الحياة وتفقد رونقها، وتدخل الثقافات في نفق الجمود ثم الاندثار والموت، واعتبر أن كل ما ليس تجديداً في مجال الفكر هو «ترديد» وتكرار لما سبق قوله، وهو ليس من الفكر في شيء ولا يمت إليه بصلة، ولكل تجديد سياقه التاريخي والاجتماعي، والسياسي والفكري؛ حيث لا ينبع التجديد في أي مجال من رغبة شخصية أو هوى ذاتي عند هذا المفكر أو ذاك. وهو ليس تحليقاً في سموات معرفية، أو عرفانية، بل ينبت في أرض الحياة، كما أنه ليس حالة فكرية طارئة، بل يجسد الفكر في تجاوبه مع الأصول التي ينبع منها، ويتجاوب معها بوسائله الخاصة.
وحسب انتاج نصر ابو زيد المعرفي نجد ان من أهم التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية الآن، ذلك الاستخدام الإيديولوجي النفعي للإسلام لتحقيق مصالح وغايات ذات طبيعة فئوية محلية عاجلة . وسواء تم هذا الاستخدام من جانب جماعات سياسية بعينها، أو من جانب أنظمة وسلطات سياسية فاقدة للمشروعية الاجتماعية والسياسية والقانونية، فالنتيجة واحدة، هي تحويل الإسلام إلي أداة من الأدوات واختزاله في وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية متدنية، ويضرب لنا أبو زيد مثلا على هذا بقوله "ولننظر مثلا في مقولة إن الإسلام دين شمولي، من أهم أهدافه ووظائفه تنظيم شئون الحياة الإنسانية الاجتماعية والفردية في كل صغيرة وكبيرة، بدءا من النظام السياسي ونزولا إلي كيفية ممارسة الفرد لنظافته الذاتية في الحمام . هذه المقولة تفترض أن دخول الفرد في الإسلام بالميلاد والوراثة أو بالاختيار الواعي يعني تخلي الإنسان طواعية أو قسرا عن طبيعته الإنسانية الفردية التي تسمح له باتخاذ القرار بشأن كثير من التفاصيل الحياتية التي من شأنها أن تتضمن اختيارات عديدة" .
وحسب نصر ابو زيد أصبح السؤال المتكرر هنا وهناك لا يتعلق بمدي ملاءمة هذا الاختيار أو ذاك بالنسبة للمجال الذي يتعين علي الإنسان الاختيار فيه، وإنما صار يتعلق بمدي سلامة هذا الاختيار أو ذاك من الوجهة الدينية والشرعية . وحين تأخذ أسئلة الحياة هذا المنحى يتحتم أن تتوقع الإجابات الصحيحة من رجل الدين لا من رجل الخبرة والاختصاص في الشأن المعني، وقد عهدنا رجال الدين في كل عصر من العصور إذا سئلوا عن رأي الدين في شأن من الشئون أن يصعب علي الواحد منهم أن يقول مثلا : 'هذا أمر لا شأن للدين به '، ذلك أن مثل هذا الجواب من شأنه أن يزعزع مقولة ' الشمولية ' التي يستند الخطاب الديني عليها في ممارسة سلطته
ذلك الخطر إنما يكمن في ذلك الفهم السقيم للإسلام، الذي من شأنه أن يرسخ سلطة رجل الدين والمؤسسات الدينية، لتصبح سلطة شاملة ومهيمنة في كل المجالات، ومن شأن هذا الاستفحال والامتداد السلطوي أن يخلق وضعا نعاني منه الآن أشد المعاناة اجتماعيا وسياسيا وفكريا، فبرغم كل الادعاءات والدعاوي العريضة، والفارغة من المضمون، عن عدم وجود سلطة دينيه في الإسلام تشبه سلطة الكنيسة في المسيحية، فالواقع الفعلي يؤكد وجود هذه السلطة، بل وجود محاكم التفتيش في حياتنا . والسلطة هذه تجمع السياسي والديني في قبضة واحدة، فيصبح المخالف السياسي مارقا خارجا عن الإجماع ومهددا لوحدة الأمة، وبالمثل يقول رجل الدين إن من يغير دينه يجب التعامل معه بوصفه خائنا للوطن . إن اتحاد الدين والوطن يجد تعبيره في كل الدساتير السياسية التي تحصر الوطن في دين، وتختزل الدين في الوطن . وهنا يختزل الوطن في الدولة، وتختزل الدولة في نظامها السياسي، ويجد المواطن نفسه حبيس أكثر من سجن . إن مقولة الشمولية تبدأ من الفكر الديني لتخترق مجال السياسة والمجتمع، أو تبدأ من الفكر السياسي لتأسر الدين في إيديولوجيتها، والنتيجة واحدة، فأي خطر أشد من هذا وأي بلاء.
والخطر الحقيقي الذي حذرنا ابو زيد منه هو أن يحدث في الإسلام ما حدث في المسيحية، حيث أدي كفر الناس بسلطة الكنيسة إلي تحميل الدين كل جرائم الكنيسة . ولا شك أن أخطاء خطابنا الديني لا فرق بين خطاب ديني معارض وآخر سلطوي، فالسعي لفرض الهيمنة جزء جوهري في بنية كليهما - تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة مع تحالف بعض قطاعات هذا الخطاب مع إرهاب أعمي البصر والبصيرة لا يفرق بين حاكم ومحكوم أو بين أعزل ومسلح، ولا يميز بين رجل وامرأة، ناهيك عن أن يميز بين طفل وراشد.
فما هي حاجتنا الى التجديد؟

يجيب نصر حامد ابو زيد في مقالة له بعنوان الاستخدام النفعي للدين منشورة في مجلة الديموقراطية حيث يقول "نحن بحاجة إلي "تثوير" فكري، لا مجرد تجديد، وأقصد بالتثوير تحريك العقول بدءا من سن الطفولة . فقد سيطرت علي أفق الحياة العامة في مجتمعاتنا سواء في السياسة أو الاقتصاد أو التعليم - حالة من ' الركود ' طال بها العهد حتي أوشكت أن تتحول إلى "موت "، هذه الظاهرة مشهودة في أفق الحياة العامة، بصرف النظر عن مظاهر حيوية جزئية هنا أو هناك، في الفنون والآداب بصفة خاصة، فستجد أن بؤر الحيوية تلك مثل بقع الضوء التي تكشف المساحات الشاسعة للظلمة . فإذا وصلنا إلي مجال الفكر، فحدث عن اغتراب الفكر وغربة المفكرين، إلا من يحتمي بمظلة سلطة سياسية أو إثنية أو دينية تحوله إلي بوق ينطق بما ينفخ فيه .
ويستطرد ابو زيد قائلا "وتثوير الفكر الذي نحتاجه يتطلب السعي إلي تحريك العقول بالتحدي والدخول إلي المناطق المحرمة، اللا مفكر فيه حسب تعريف ' محمد أركون '، وفتح النقاش حول القضايا . وأهم من ذلك التخلص من ذلك الجدار العازل الذي طال وجوده في ثقافتنا بين ' العامة ' و' الخاصة '، فتلك الدعوات التي تتردد بين الحين والآخر عن حصر النقاش في بعض القضايا الدينية داخل دائرة ' أهل العلم '، حتي لا تتشوش عقائد العامة أو يصيبها الفساد، دعوات في ظاهرها الرحمة والحق، وفي باطنها السوء والباطل . كيف يمكن في عصر السماوات المفتوحة التي تنقل 'العالم' إلي غرف النوم، وفي عصر اكتساح ثورة المعلومات لكل الحدود، أن يطالب البعض بحماية "العامة " من خطر الفكر العلمي في أخطر القضايا التي تمس حياتهم، إنه للأسف منطق ' الوصاية ' يتذرع باسم "الحماية " لممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية لا تقل خطرا عن الديكتاتورية السياسية في مجتمعاتنا.
ويرتبط منهج التجديد بالحاجة إلي التجديد في سياقه التاريخي الاجتماعي، السياسي والفكري. فالتجديد في أي مجال لا ينبع من رغبة شخصية أو هوي ذاتي عند هذا المفكر أو ذاك، إنه ليس تحليقا في سماوات معرفية، أو بالأحرى عرفانية، منبتة عن أرض الحياة وطينها، وعن عرق الناس وكفاحهم في دروب الحياة الاجتماعية، قد يبدو المفكر محبا للعزلة حريصا على الهدوء والابتعاد عن صخب الحياة، لكنها أوقات التأمل التي لو انسلخت تماما عن نسيج الحياة الحي وتيارها الجاري لصارت سجنا من الأوهام، وقلعة للشياطين العابثة . من هنا يمكن القول إن "التجديد " ليس حالة فكرية طارئة، بل هو الفكر ذاته في تجاوبه مع الأصول التي ينبع منها ويتجاوب معها بوسائله الخاصة.
ويوضح لنا ابو زيد انه ما ليس تجديدا في مجال الفكر فهو ' ترديد ' وتكرار لما سبق قوله، وليس هذا من الفكر في شيء، ولا يمت إلي الفكر بأدني صلة من قريب أو من بعيد . وبما أن قانون الحياة الطبيعية والاجتماعية هو التغير في كل شيء، سواء كان ذلك التغير مدركا وملحوظا أو لم يكن، فإن قانون الفكر هو ' التجديد '، ذلك هو قانونه من حيث هو فكر في ذاته. ويصبح ' التجديد ' مطلبا ملحا كلما سيطر ' التقليد '، الذي هو عين ' الترديد ' والتكرار لما سبق قوله، وساد، إذ في هذه الحالة ينفصل الفكر عن حركة الحياة التي تمضي في حركة تغيرها غير آبهة بعجز الفكر عن متابعتها فضلا عن قيادتها وترشيد اتجاه حركة التغيير فيها .
تنبع الحاجة إلي التجديد من مطلب التغيير، وهذا المطلب الأخير يصبح بدوره ضرورة ملحة حين تتأزم الأوضاع علي كل المستويات والأصعدة : الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، والثقافي والفكري علي السواء .
يمكن القول إن تعدد أوجه الأزمة يخلق الحاجة إلي التغيير، وأول مظهر من مظاهر التغيير هو الحاجة إلي ' التجديد ' الفكري والسياسي والاجتماعي، أي في كل مجالات المعرفة وحقولها في هذا السياق يكتسب التجديد في إطار الفكر الديني أكثر إلحاحا بسبب أن كل هذه الأزمات والهزائم يتم تفسيرها في الخطاب الديني بشقيه الرسمي والشعبي تفسيرا دينيا
وهناك ايضا مبرر معرفي للتجديد يلفت ابو زيد انتباهنا اليه حيث ان مهمته تحقيق عملية ' التواصل ' الخلاق بين الماضي والحاضر . والمقصود بعملية ' التواصل الخلاق ' الخروج من أسر ' التقليد الأعمي ' وإعادة إنتاج الماضي باسم ' الأصالة '، وكذلك الخروج من أسوار ' التبعية ' السياسية والفكرية التامة للغرب باسم ' المعاصرة '. وليست عملية ' التواصل الخلاق ' بالضرورة هي محاولة التلفيق بأخذ طرف من التراث وطرف من الحداثة دون تحليل تاريخي نقدي لكليهما، وهو النهج الذي سيطر بدرجات متفاوتة علي المشروع الفكري النهضوي، فأفضي إلي تكريس ثنائية ' الغرب ' المادي العلمي المتقدم والمفلس روحيا، و ' الشرق ' الروحي الفنان المتخلف ماديا وعلميا . العودة إلي دراسة ' التراث ' مجددا، خاصة ' التراث الديني ' تستهدف إعادة النظر في كل تلك المسلمات، سعيا لتحرير المشروع النهضوي من تلفيقيته التي انكشف عجزها واضحا من خلال الهزيمة الشاملة .
كيف نتجاوز حالة ' التحزب ' و ' الاستقطاب ' الحاد في مجتمعاتنا بين فريقين يحرص كل منهما علي نفي الآخر واستبعاده، تتعدد آليات ' الاستبعاد '، لكنها تتجلي في بنية ثنائية تناقضية، يستبعد فيها ' الإسلامي ' العلماني علي أساس ' خروج ' الأخير علي ثوابت الأمة وتبنيه لمشروع فكري، ثقافي سياسي اجتماعي، يفضي إلي مزيد من التبعية للغرب . وبالمثل يستبعد ' العلماني '' الإسلامي ' علي أساس قيام مشروعه علي أوهام العودة إلي الماضي والتقليد والاعتماد علي شعارات فضفاضة غامضة لا تغني عن غياب المشروع الاجتماعي السياسي الواضح الأهداف والمقاصد والمحدد لإجراءات العمل والتنفيذ
ليس هناك بديل فكري ثالث جاهز، هناك آراء واقتراحات، الشرط الوحيد لبلورتها هو دفاعنا جميعا عن ' ديمقراطية ' غير مشروطة، ديمقراطية لا تستبعد أحدا ممن نظنهم أعداءنا أو خصومنا إننا نبحث عن وهم لا وجود له، ولم يوجد أبدا في التاريخ، شيء اسمه ' الاتفاق ' و ' الإجماع ' علي صيغة سياسية ثقافية فكرية حضارية للخروج من الأزمة، وهو وهم تخلص منه العالم المتقدم حين اتفق علي كيفية تنظيم ' الاختلاف ' من خلال آليات ' الديمقراطية ' الحديثة . دعنا ننظم اختلافنا، الذي هو أمر ليس طبيعيا فقط، بل هو صحي . لقد خلقنا الله مختلفين، فالاختلاف ظاهرة في أصل الخلقة، ثم يصوغ المجتمع بعناصره وتعدد مصالح فئاته، وتضاربها أحيانا، هذا الاختلاف صوغا اجتماعيا وسياسيا وفكريا . لهذا يتكون المجتمع من ' جماعات ' تتباين فيما بينها، وإن كانت تشكل كلا واحدا غير هلامي هو الذي يميز مجتمعا ما عن غيره من الجماعات إن الاختلاف ' المنظم ' ثراء وغني، بعكس ' الاتفاق ' أو ' الإجماع ' القائم علي القهر والعسف والشطط. ولنتعلم جميعا من دروس الماضي والحاضر : قد أختلف معك في الرأي، لكني علي استعداد أن أدفع حياتي ثمنا لحماية حقك في التعبير عن رأيك .
ارتباط النص بالواقع:
الدراسات الإسلامية تركز على ان معرفة القرآن تسير اليوم في مجالَين مستقلَّين: معرفة تقليدية قائمة على تفسير القرآن وفق الأساليب الكلامية القديمة، وهي تتلقى الدعم والترويج من المؤسسات الدينية الرسمية، وينتمي إلى دائرتها بعض المثقفين الدينيين. ومعرفة حديثة، وأصبحت حقلا تعليميا في الجامعات، ويستطيع المسلم وغير المسلم أن يدرسها وأن يتخصص في بعض المجالات المتفرعة عنها.
وحسب نصر حامد أبو زيد قوله فإن غالبية مفسري القرآن التقليديين والحداثيين، باستثناء المفكر الجزائري الراحل محمد أركون، يغفلون نقطة مهمة: وهي أن القرآن الذي نزل على النبي لم يكن “نصا”، وأن ما هو موجود بيننا اليوم، أي نص القرآن، لم ينزل مرة واحدة بل نزل على مراحل، مشيرا إلى أن القرآن هو حصيلة تجميع وتدوين تم في عهد الصحابة، وأن أول نسخة من القرآن، أو من “المصحف”، افتقد النقاط على حروفه ولم يكن بالإمكان إعرابه، وظهر في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان، أما النسخة النهائية من القرآن، أو من “المصحف” الذي بين أيدينا اليوم، والذي اشتمل على النقاط والإعراب، فقد ظهر في مراحل لاحقة. لذا، لا يجوز في إطار تعاملنا مع القرآن، أي في إطار تعاملنا مع “المصحف”، الذي تم ترتيب آياته وتنظيمها وتدوينها بشكل خاص، أن نضيف إليه شيئا وأن نحدّد فيه أي عيوب.
أما القرآن المستند إلى الوحي، حسب اركون وابو زيد فهو ليس كلاما شفهيا قيل لمرة واحدة، بل هو كلام شفهي قاله النبي لصحابته في فترة زمنية امتدت لأكثر من عشرين عاما، هو كلام قيل في سياق ظروف تاريخية متباينة ولأفراد مختلفين. لكن المسلمين تعاملوا مع القرآن بفرضية أنه “نص” أو “مصحف”، وسعوا إلى تفسيره وتأويله. والنتيجة أن الأساس الذي انبنت عليه التفسيرات كان ضعيفا.
فيقول ابو زيد عن نفسه "تعاملت مع القرآن وفق هذه الفرضية لفترة طويلة من الزمن، وبحثت في معنى النص من خلال وسيلة التأويل، خاصة فی کتاب "مفهوم النص". أما راهنا فقد أدركت بأني أخطأت الطريق، ولابد مجددا أن أنظر إلى القرآن بصورة مغايرة". ويضيف أبوزيد بأن أصالة “نص” القرآن، هي بمثابة نزع لروح النص، ولقابليته للحركة، وتبديل النص إلى هوية جامدة غير قابلة للتغيير، ومحاصرته وسط جدران سميكة من التأويلات النهائية، وجعل النص هدفا لألاعيب الجماعات السياسية التي ستفسر النص وفق مصالحها.
وهنا جاء التأكيد على ضرورة التحرر من فكرة أن القرآن “نصّ”. ففي الوقت الذي يعزف الفقهاء والمفسرون التقليديون على وتر التأويل، يعتقدون بأنهم أمام نص قد يغوص في تفسيرات تؤدي إلى تناقضات في الفهم. وبما أن النص القرآني يجب أن لا يحتوي على تناقضات، بسبب أنه نص إلهي سماوي جاء عن طريق الوحي، سعى المفسرون إلى خلق أدوات للتفسير تعالج تلك التناقضات. على سبيل المثال، بما أن الفقهاء يعتقدون بأن القرآن “نصّ”، فإنهم يعتبرونه منبعا للتشريع. وحينما يأتون بآيات تطرح أحكاما متباينة حول موضوع واحد، فبالضرورة يؤسسون لمفهوم “النسخ”. وفي إطار نظرتهم تلك فإن هناك آيات ناسخة وهناك آيات منسوخة. وفي الوقت الذي لم يكن لدى المفسرين التقليديين القدرة العلمية على اكتشاف الترتيب الدقيق لنزول الآيات، فإن تقییم الناسخ والمنسوخ كان محل خلاف بينهم.
كذلك، حينما تم تقسيم الآيات إلى محكمة (ذات معنى واضح) ومتشابهة (التي تفتقد لوضوح المعنى وتحتاج إلى تأويل)، فإن ذلك أجج النزاع بين المتكلمين في مختلف المذاهب. وكانت مفردات أصولية مثل “العام” و"الخاص" من الأدوات المفاهيمية التي ساهمت في معالجة التناقضات الظاهرة في فهم “النص” القرآني. والقرآن بوصفه “نصّاً”، ساهم في اعتباره بناء لتشريع القوانين وإضفاء المشروعية على أحكام صالحة لکل زمان ومکان. أي أن أصالة “النص” القرآني أصبحت متعلقة بتجاهل الرؤية التاريخية للنص. في حين أن القرآن كان عبارة عن مجموعة من الكلام الشفهي الذي ظهر إلى الوجود في إطار سياق تاريخي. فطبيعته كانت حية، وأُرسل إلى شخص خاص، وقيل في ظروف خاصة، وأجاب عن أسئلة متعلقة بحاجات واقعية وإنسانية. لهذا، فإن “تفسير القرآن بالقرآن”، على سبيل المثال، يبدو لا معنى له.
من هذا المنطلق، وجب الاشارة إلى ظهور مفهوم “أصالة النص” القرآني، على اعتبار ان ذلك مسعى لمنع أي إمكانية لتغيير معنى “النص”، ولجعل هوية القرآن جامدة، ومحاصرة القرآن وسط جدران سميكة من التأويلات الثابتة التي لن تتغير إلا حسب ما تقتضي المصالح. كذلك، تتحقق أدلجة القرآن من خلال فرضية أنه “نص”، فيما الوسيلة الوحيدة لمواجهة تلك الأدلجة ورفعها هي بمعرفة طبيعة القرآن الشفهية الخطابية.
فيقول أبوزيد "أن القرآن ليس صوتا واحدا وإنما مجموعة مختلفة من الأصوات التي تصل إلى مسامعنا. فالذين تخيلوا بأن القرآن “نصّ”، سعوا من خلال التحليل البنيوي إلى تصنيف الأشكال الأدبية من الآيات إلى: آيات القسم والشهادة وما يرتبط بها، الآيات بمعنى العلامات التي تدل على الشيء، الآيات بمعنى المعيار القرآني والقصص والأحكام والعبادات. أما إدراك الطبيعة الخطابية الشفهية للقرآن فهو بمعنى أن القرآن مثله مثل أي حديث شفهي أو خطاب، يستطيع أن يحتوي على حوار وجدل وإنكار وقبول واختيار. هو كلام شفهي وليس نصّا مكتوبا. ويجب إدراكه من خلال أداة تحليل الخطاب لا عن طريق فهم النص
فإننا إذا اعتبرنا القرآن خطابا، أو كلاما شفهيا، فسوف لن نجد فيه أي تناقض، في حين تتحقق فرضية التناقض من خلال اعتبار القرآن مصحفا (أي نصا مكتوبا). فالنص وكأن شخصا قد كتب كتابا من بدايته حتى نهايته. في حين أن القرآن هو خطاب، أو مجموعة من الكلام الشفهي، قيل خلال فترة تتجاوز العشرين عاما وفي ظروف مختلفة، لذلك سوف لن نشهد أي تناقض فيه. وما يتراءى لنا بوجود نصوص متناقضة يتأسس انطلاقا من اختلاف الظروف التي قيلت خلالها الآيات، لكنها لا يمكن أن تكون متناقضة.
ان محمد أركون، هو من روّاد فهم القرآن باعتباره خطابا وكلاما شفهيا. بينما نصر حامد ابوزيد يعتقد بأن أركون على الرغم من رؤيته الخطابية تلك لكنها تحمل طبيعة واحدة لشكل العلاقة: طبيعة أنا (المتكلم) – أنت (النبي) وأنتم المؤمنون. فشكل العلاقة التي يطرحها القرآن، وفق أركون، ينتمي إلى أنا المتكلم وأنت المخاطَب أو أنتم المخاطَبون.
بينما يقول ابو زيد بأن ذلك قد يكون هو النوع الغالب على شكل العلاقة، لكنه ليس النوع الوحيد في ظل تباين الخطاب القرآني، وعليه، لا يُمكن أن نسمع صوتا واحدا من القرآن، بل أصواتا مختلفة. فالصوت “المقدس” لا يخرج دائما من ضمير المتكلم “أنا”، بل يخرج في كثير من الأحيان من ضمير الغائب "هو"، ففي الخطاب التعبدي يُشار إلى الأمر المقدس بضمير "أنت"، لكنه يتبدل إلى كلام إنسان يخاطب الله بحثا عن الهداية، فيصبح نوعا من الحوار المباشر الذي يعكس الطبيعة الخطابية للقرآن، وحينما نتصور بأن الآيات القرآنية هي كلام وحياني خرج من لسان النبي في ظروف مختلفة، سوف لن نجد فيه تناقضا، ولن نعتبره مصدرا لأحكام نهائية في ظل الطبيعة التاريخية للقرآن، كما يشير ابو زيد إلى أمثلة عديدة بوصفها حصيلة تلك النظرة، أحدها هو زواج الرجل المسلم من امرأة كتابية أو العكس، وبما أن جزءا من الكلام الشفهي في القرآن هو عبارة عن حوار، فالمؤمنون كانوا يسألون النبي، فيما هو يرد عليهم بلسان الوحي. فهم يسألونه في مسائل مختلفة، كتلك المتعلقة بشرب الخمر ولعب القمار ونوعية الطعام والصدقات والحروب في الأشهر الحرم، وكانت بعض إجابات النبي ردا على سؤال واحد متباينة، لأنها كانت تعكس الرد على سؤال في إطار ظرفين مختلفين. من هنا طرح الفقهاء، المؤمنون بـ ”النص”، بحث الناسخ والمنسوخ والعام والخاص من أجل معالجة تلك التباينات.
يشير أبوزيد إلى آيات في سورة المائدة تتساءل عمّا هو مباح، فتشير إلى مشروعية الأكل والزواج من أهل الكتاب. لكن الفقهاء يعتقدون، حسب ابوزيد، بأن ذلك التشريع قد تم نسخه بالآية 221 من سورة البقرة التي منعت المؤمنين من ان يتزوجوا من نساء المشركين. ويستشهد ابوزيد بقول ابن رشد في “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”، الكتاب الثامن، باب النكاح، الجزء الثاني، بوجود رؤيتين في الفقه حول هذه الجزئية: الأولى تقول بأن آيات سورة المائدة التي تشرع لزواج المسلم من امرأة من أهل الکتاب هي أحكام خاصة، وبالتالي هي تعتبر خارج إطار الحكم العام الذي يحرّم زواج المسلم من امرأة مشركة، أما الرؤية الثانية فتقول بأن الآية في سورة البقرة نسخت حكم آيات سورة المائدة، وبالتالي فإن زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية يصبح غير جائز. أي أن الفقهاء هنا يعتبرون القرآن “نصّاً” ومرجعا قانونيا ولا يمكن أن يقبلوا وجود تناقض أو تباين بين آياته.
لکن وفق ابوزيد، إذا استطعنا التمسك بالطبيعة الخطابية الكلامية الشفهية للقرآن، حينها نستطيع أن نخرج من إطار النسخ والتخصص، وسيتشكل أفق أوسع أمام أعيننا، وسوف نستطيع القول بأن سورة البقرة هي عبارة عن خطاب منفصل عن خطاب سورة المائدة. فالخطاب في سورة البقرة هو حول الانفصال عن المشركين، أي هو يدعو المسلمين إلى عدم التدخل في أمور المشركين في مقابل عدم تدخل المشركين في أمور المسلمين. لكن الكلام في سورة المائدة هو حول تعايش المسلمين مع أهل الكتاب. أي أن المسلمين سألوا النبي مجددا وفي ظروف جديدة مغايرة عن حكم مسألة كانوا يعرفون إجابتها، لكنهم لا يعلمون بأنه هل الحكم سيتغير أم سيبقى كما هو في ظل تغير الظروف. ففي الظرف الجديد المغاير، عاش المسلمون مع اليهود في المدينة، وانطلاقا من ذلك حث خطاب الوحي المسلمين هذه المرة على التعايش مع أهل الكتاب وعلى الزواج منهم ودعاهم إلى أن يأكلوا من طعامهم.
وحسب نصر حامد ابوزيد، فإن سؤالا هنا يفرض نفسه: أي قاعدة يجب أن تهيمن على المسلمين وفق فهمهم للقرآن؟ هل هي قاعدة التعايش أم قاعدة الابتعاد والانفصال؟ هل يمكن تحقيق التعايش من دون تحقيق المساواة والتعاون في الحياة العادية وفي المأكل وفي الزواج؟ هل اللا مساواة بين الرجل والمرأة، في ظل شروط التعايش التي تقتضي المساواة بين الناس، ممكنة؟ وفي ظل شروط الحياة الحديثة، والتي تتفاوت فيها الظروف عن السياق الذي نزلت خلالها الآيات، هل يستطيع الله أن يغض البصر عن التغييرات الاجتماعية التي حصلت، وأن يكلّف الناس بأحكام لا تتماشى مع ظروفهم الإنسانية والتاريخية؟
وحسب ما يقدمه نصر ابو زيد، يجب إعادة فهم الأصل والفرع في الخطاب القرآني. فالله لم يضع فرقا بين الرجل والمرأة حينما تعلق كلامه بالعبادات. لكن، حينما وصل الخطاب إلى الشأن الاجتماعي، ظننّا بأنه كلام تمييزي. فالخطاب القرآني الذي يشير إلى الظروف الاجتماعية، للمرأة، على سبيل المثال، يتعلق بسياق نزول الآيات. في حين لابد أن یکون مبدأ الكلام مرتبطا بالآيات التي تتحدث عن الحالة التعبدية للرجل والمرأة والتي لا يوجد في ثناياها أي تمييز بينهما، فالآيات المتعلقة بالظروف الاجتماعية هي الفرع. فلو كان النبي موجودا اليوم ويستطيع المسلمون أن يوجهوا إليه أسئلة تتعلق بظروف حياتهم ويطالبونه بحكم يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإن الله ومن دون أي تردد كان سيحكم بتأييد المساواة. ويستطرد ابو زيد قائلا بأن المسألة تتلخص في السؤال التالي: هل نحن نعترف بحرية الإنسان؟ فإذا لم يعترف الشخص الذي يمارس عملية تأويل الكلام القرآني بأصل الحرية الفردية للرجل والمرأة، أي الحرية وفق إطارها الحديث، ولم يعترف بحق الإنسان في اختيار دينه، فإن طريق الخروج من أفق الذهنية المتشددة سيكون مسدودا، لأن هذه الذهنية مستعدة أن تضحي بالقرآن لصالح فكرها الظلامي التاريخي، وستمنع أي تعايش سلمي بين المسلمين والآخرين، وترفض الشراكة مع الشعوب الأخرى في إطارها المدني.















