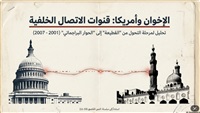"باتريك هايني" وإسلام السوق
الإثنين 20/يوليو/2015 - 01:16 م
طباعة
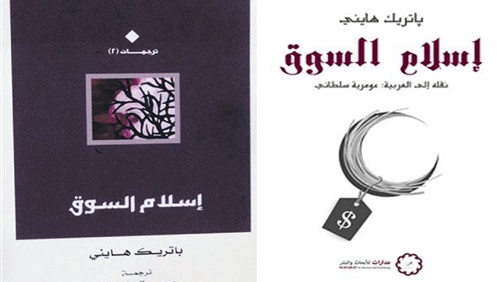
الكتاب: إسلام السوق
المؤلف: باتريك هايني
الناشر: دار النشر لوسوي وجمهورية الأفكار
الطبعة: الأولى 2005
جاءت مقدمة الدكتورة هبة رءوف عزت والتي تبين فيها كيف شغل العقل المسلم بالتعامل مع الاستبداد، فأنتج سيلًا من الكتابات عن علاقة الإسلام بالديمقراطية، في حين مدت الحداثة كمشروع علماني جذورها في مجتمعاتنا دون أن يستوعب المشتغلون بالدعوة مخاطرها ومواطن الزلق فيها، وترى د. هبة أن السيولة هي الكلمة المفتاحية في الكتاب فالجيل الجديد الذي انصرف عن الأطروحات الصلبة للتنظيمات وركز على قيم النجاح الفردي بدلًا من المفاهيم الكبرى كالخلافة والتي تبتعد عن هموم الناس اليومية؛ مما أدى إلى تمكن السوق من ابتلاع الظاهرة الإنسانية وتحولت الدعوة لسلع تُباع كبرامج تلفزيونية في رمضان.
ويتناول الكتاب ما فعلته المدينة الحديثة التي هي ساحة الرأسمالية وبَوتقة مشروع الحداثة الغربي برؤيته العلمانية والفردية فالمدينة تجمع بين السوق والعسكرة في الدولة وتتسم بالاستهلاكية والسلطة الإدارية في آن واحد وهو ما يحملنا للتساؤل ما الذي يمكن أن يعتبر تجديدًا في الخطاب الإسلامي؟ وما الذي يمثل سيولة وعلمنة وما المعيار؟ والحل تراه د. هبة بعرض الأمر على الفقه، فقه الشرع وفقه العقل المسلم في فهم الحداثة حتى لا تتحول لعلمنة تهدر مقصد الشرع وحكمة النص.
وترى د. هبة أن غلبة الخلفية التكنوقراطية والعقلية الحداثية على قيادات التنظيمات وتراجع دور الفقه الشرعي في صناعة القرار والسياسات أحد أهم أسباب المأزق الذي وصلت إليه تلك الحركات، فحسابات المكاسب السياسية والحشد الجماهيري ومنطق التنظيمات هو منطق في عمومه حداثي كمنطق التنمية البشرية والإدارية سواء بسواء، وتضيف إلى أنه بالإضافة إلى إدراك ابتلاع السوق للمفاهيم الإسلامية لا بد من فهم سيكولوجية المال كمفتاح لفك شفرة الثقافة الاستهلاكية وهيمنة السوق وما يرتبط به من إعلاء قيمة المال وارتباط المكانة الاجتماعية بالثروة والشهرة.
مقدمة الكتاب

وتأتي مقدمة الطبعة العربية والتي يرصد فيها الكتاب بعد عشر سنوات من صدور كتابه كيف تفاعلت المجتمعات العربية مع حركتي الأسلمة والعولمة في الوقت ذاته مع عجز الإسلام السياسي عن طرح بديل فعلي، من هنا ينطلق إلى مصطلح إسلام السوق الذي هو مزيج من النزعة الفردانية ونزع القداسة عن الالتزام التنظيمي وإعادة النظر في فكرة شمولية الإسلام؛ ليظهر التدين الورع الذي لا يولي لمسألة الدولة والثقافة المرتبطة بالطبقة الاجتماعية اهتمامًا، إسلام السوق هو حافز للانفتاح على العالم على حساب الهوية وهو حالة منتشرة بين أطياف التوجه الإسلامي من الإخوان للسلفية للصوفية والدعاة الجدد وأصحاب المشاريع الرأسمالية بطابع إسلامي.
إسلام السوق إذن فكرة للربط بين أنماط معينة من التدين الإسلامي والأسس الفلسفية للسوق مثل النزعة الفردانية والانفتاح وأولوية الشأن الخاص على العام المرتبط بالدولة والعولمة ونزعة الاستهلاك؛ مما يؤدي في النهاية لتقليص المكونات الهوياتية، حيث يرى الكاتب أن إسلام السوق يتوسع بسرعة منذ منتصف التسعينيات نتيجة لأربعة نماذج تشكل مباحث الكتاب؛ نموذج التدين الفرداني المنفصل عن المشاريع الجماعية الكبرى في سبيل مشاريع شخصية، إعادة صياغة الإسلام بنماذج تفكير السوق، التأكيد على روح المؤسسة داخل مساحة الديني والفتنة بنظريات المنجمات، إعادة تسييس الديني على أسس نيوليبرالية فلم يعد الهدف مطلب الشريعة وإنما بناء مجتمعات مدنية مزدهرة.
ويرصد كتاب "إسلام السوق" جانبًا مغيبًا من الصحوة الإسلامية المعاصرة غفل عنه الدارسون، في الوقت الذي تتنافس فيه وسائل الإعلام ومراكز الرصد والبحث والمراقبة والكتابة والتأليف في حركات ما يسمى بالإسلام السياسي تنافسا يصل إلى درجة التمييع.
الجانب المغيب يشمل ما سماه المؤلف السويسري باتريك هايني في العنوان الفرعي التفسيري للكتاب "الثورة المحافظة الأخرى"، والمقصود بها هو أشكال التدين الإسلامي الجديدة والخارجة عن مجال الحركات والأحزاب الإسلامية، والرافضة في الوقت نفسه للدخول في قلب الصراع السياسي سواء كان صراعًا بين الحركات الإسلامية ذات البعد السياسي والأنظمة الحاكمة، أو بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية.
وباتريك هايني يمثل جيلًا جديدًا من أجيال الإسلامولوجيين (المهتمين بالظاهرة الإسلامية)، وهو جيل يحرص أشد الحرص على الموضوعية العلمية والدراسة الوصفية والتحليلية البعيدة عن أي توظيف سياسي.
وقد قضى وقتا طويلا في مصر وأقطار أخرى من العالم الإسلامي، وله صلات علمية وطيدة مع بعض التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، فعاش حينا من الدهر في القاهرة دارسا، وتعلم اللغة العربية وتعرف عن كثب على الإسلاميين، وتعرف أيضًا على الإسلاميين الإندونيسيين والأتراك.
وانطلاقًا من مصر ومرورًا بإندونيسيا وانتهاء بتركيا، يحلل "إسلام السوق" بزوغ شكل جديد من أشكال الكينونة الإسلامية تخرُج من صلب إسلام سياسي ظهر عليه التعب، أو تمرُّ محاذية له، تشترك معه في المنبع لكنها تختلف معه في الهدف والوسيلة وتحديد مجالات العمل.
مقاولات دعوية
في بداية الكتاب يشخص هايني ازدياد "الإسلاميين الغاضبين" الذين ينتقدون في الآن نفسه الأيديولوجيات الإسلامية ليقينيتها، وبنياتها التنظيمية لجمودها وقسوتها.
ومن دون أن يصل هذا الموقف بأصحابه إلى مغادرة الحركات الإسلامية، يفضل هؤلاء البحث عن طرق للخلاص الفردي وتحقيق الذات والنجاح الاقتصادي على حساب الأزمة الثابتة بين الإسلاميين التي تفقد في أعين المنتقدين جاذبيتها رويدا رويدا.
ويثير المؤلف الانتباه بعد هذا إلى التنافس بين الدعاة الجدد في استثمار موجة الصحوة الإسلامية الاجتماعية المنفلتة من قبضة التنظيمات الإسلامية المستعصية عليها، وسعيهم نحو إنجاز مصالحة توفيقية بين المد الديني والحداثة الغربية.
ويحدث هذا عبر مقاولات دعوية تستخدم الطرق الأمريكية في الدعاية والاشتغال وتشجع ميلاد فرق موسيقية إسلامية عصرية ووجوه دعوية نسائية حديثة.
تلك هي الصورة الدينية الجديدة التي يلتقطها باتريك هايني مسميًا إياها "إسلام السوق"، وهو اسم اختير للدلالة على العلاقات القائمة بين المؤسسات الاقتصادية والثقافة المقاولاتية الجديدة ذات الأصل الأمريكي.
ومنذ عشر سنوات، صار امتداد "إسلام السوق" نتيجة واضحة لأربعة سيناريوهات استعرضها الكاتب في فصول أربعة هي مجمل فصول الكتاب.
"في حركات بلغ منها الجهد مبلغه ويشعر المنخرطون فيها بالجمود التنظيمي والاختناق النفسي والفكري، يجد الغاضبون الحل في الانفتاح على المدنية الغربية والاقتباس منها و"أسلمة" منتجاتها وعناصرها بعملية تلفيقية سريعة".
تجاوز الإسلام السياسي
يكشف لنا الفصل الأول عن تجمد أصاب التدين النضالي- إن صح التعبير- تتجاوز فيه الرغبات الشخصية في تحقيق الذات المشاريع الجماعية الكبرى التي تحتل موقع الصدارة في الخطاب الإسلامي الكلاسيكي.
ففي حركات بلغ منها الجهد مبلغه ويشعر المنخرطون فيها بالجمود التنظيمي والاختناق النفسي والفكري، يجد الغاضبون الحل في الانفتاح على المدنية الغربية والاقتباس منها، و"أسلمة" منتجاتها وعناصرها بعملية تلفيقية سريعة. وفي هذا المناخ الجديد يتحول الجهاد عن مكانه القديم ليصبح "جهادا إلكترونيا" و"جهاد النهضة".
ويتابع هايني قصة النشيد الإسلامي من بداياته الملتزمة وتعبيره عن قضايا الأمة وبأسائها وضرائها، إلى ظهور فرق غنائية حديثة تخطب ود الأجيال الإسلامية الجديدة وتمتهن "الدعوة بالموسيقى".
المسار نفسه انخرطت فيه الحشمة الإسلامية وزيها الخارجي لتنتقل من الحجاب المناضل ذي الرمزية السياسية إلى الاستهلاك الجماعي والتأثر بالموضة.

ويقدم المؤلف تركيا نموذجًا إسلاميًّا للاندماج في اقتصاد السوق وبروز برجوازية إسلامية تصنع فضاء إعلاميًّا جديدًا تلتقي فيه العولمة بالإحيائية الدينية الإسلامية، وتغير الحشمة من وجهها وملامحها وألوانها وأشكالها، ثم يتوج كل ذلك بالموجة الثالثة من الحجاب في "الإسلام الأوروبي".
ولا تركب الدعوة بساط الأنغام المتنوعة ثقافيًّا وجغرافيًّا، بل تمتطي ظهور القنوات الفضائية متأثرة بالتجربة الإعلامية الإنجيلية الأمريكية لدى نجمين من نجوم الوعظ التلفزيوني وهما المصري عمرو خالد، والإندونيسي عبد الله جمنستيار، فالأول اكتسب الطريقة من متابعة الوعاظ الأمريكيين في قنواتهم، والثاني دربه عليها واعظ أمريكي إنجيلي سابق استطاع مضاعفة أعضاء كنيسته في عامين فقط بفضل تقنيات التسويق الإعلامي، قبل أن يعتنق الإسلام عام 1997 ويصير مستشارًا لجمنستيار.
الواعظون الإسلاميون الفضائيون يتمكنون حسب المؤلف من الاستحواذ على جمهور عريض جدًّا، خاصة من الذين خاب أملهم في حركات الإسلام السياسي.
"لم تعد وظيفة السوق هي الترويج للأفكار وإقناع رواده بها، ولكن وظيفته صارت تلبية طلبات الجمهور المستهدف وأغلبه من البرجوازية المتدينة الكارهة لكل نضال ذي محتوى سياسي".
قانون السوق
بحكم علاقة القرب بين الإسلاميين الجدد ورجال المال والاقتصاد، وجد هذا الوجه المتدين أن القناة الوحيدة للتعبير عن نفسه هي السوق.
ولم تعد وظيفة السوق هي الترويج للأفكار وإقناع رواده بها، ولكن وظيفته صارت تلبية طلبات الجمهور المستهدف وأغلبه من البرجوازية المتدينة الكارهة لكل نضال ذي محتوى سياسي بالمعنى الأصيل أو بالمعنى الدخيل.
يضرب المؤلف المثال بتجارة الأشرطة الدينية في القاهرة والتي تظهر أن مقاولات الإنتاج والترويج تستطيع تجاوز البنيات السلفية الموجودة وتسعى إلى الإقناع عن طريق الإغراء.
بل إن الوعاظ الجدد لا يجدون مانعًا من الظهور في قنوات تجارية محضة أو غير إسلامية، وهي بدورها تشتري حق البث لأغراض تجارية بحتة.
قانون السوق يستطيع إلحاق الهزيمة بالسلفيين أيضا فيلجون عالم "التسويق الأخلاقي"-حسب تعبيرهم- و"السوق الحلال" خاصة في تجارة الملابس.
وما إن يستغني رواد هذا السوق حتى يفكروا في "الهجرة" من ضواحي المدن الغربية المهددة بخلايا القاعدة، لا للعيش في البلدان الأصلية وأغلبها مغاربية، بل للاستقرار في بلدان الخليج؛ حيث يوجد الطلب على السلع المعروضة.
في البلدان الغربية وبالخصوص فرنسا، تحرص المقاولات التجارية الإسلامية على تجنب إظهار الطابع الإسلامي لسلعها تحت ضغط العلمانية وتوسع من الفئات المستهدفة لتشمل غير المسلمين مع مواكبة موجات الموضة والثقافة الغالبة.
عقيدة الرفاهية
ينظر المؤلف في الفصل الثالث إلى الجهد المبذول من لدن رواد "إسلام السوق" وزعمائه للجمع بين التقوى والغنى، وإبعاد التهمة عن الباحثين عن الغنى والثروة والربح من المسلمين البرجوازيين.
فيصر عبد الله جمنستيار على أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ذاته كان رجل أعمال ناجحًا، ويكتب عمرو خالد أن الثروة والغنى وسيلة لإتقان التدين وتقديم نموذج جيد. ويدافع الإسلاميون الأتراك المقربون من حزب العدالة والتنمية عن أن القرآن الكريم يدعو إلى تكديس الثروة وأن الفقر يؤدي إلى الكفر.
وفي السياق نفسه يؤسس الوعاظ والمرشدون الجدد لعقيدة الرفاهية والتنمية الفردانية، متأثرين في ذلك بالكاتب الأمريكي ستيفن كوفي صاحب الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة والعالم "العادات السبع للناس الأكثر فعالية" المترجم إلى العربية.
في الجنوب الشرقي الآسيوي تتخذ عقيدة الرفاهية مسارا مشتبها، إلا أن المستفز إليها هو المنافس الصيني الذي احتكر السوق والثروة على أقليته.
وفي تركيا تتجمع ثلاثة عناصر لميلاد الظاهرة وهي الحركة النورسية والداعية فتح الله غولان وطبقة التجار في الأناضول.
"الحركة الدينية الليبرالية الجديدة استطاعت أن تشطب مطلب الدولة الإسلامية من قائمة الأهداف، وصار الهدف تأسيس مجتمعات مدنية فاضلة تشبه في طريقة عملها المؤسسات الدينية الأمريكية الموازية للحزب الجمهوري."
تحجيم الدولة
أما الفصل الرابع والأخير فيتولى بيان أن هذه الحركة الدينية الليبرالية الجديدة استطاعت أن تشطب مطلب الدولة الإسلامية من قائمة الأهداف، كما روجت لذلك حينًا من الزمن أدبيات الحركات الإسلامية التقليدية.
وصار الهدف هو تأسيس "مجتمعات مدنية فاضلة" تشبه في طريقة عملها المؤسسات الدينية الأمريكية الموازية للحزب الجمهوري الأمريكي، وتستطيع عقد اتفاقيات مع الحكومة للقيام بعدة مشاريع وأعمال في المجتمع.
ويضرب الكاتب أمثلة من تجربة عمرو خالد في بناء وإنجاز عدة مشاريع ناجحة في الوطن العربي والإسلامي، ويفسر كيف استطاعت هذه التجربة أن تعيد الاعتبار إلى المجتمع المدني ضد مفهوم الدولة الراعية المهيمنة على كل شيء.
ويخلص القارئ لكتاب "إسلام السوق" إلى أن رواد هذا العمل الإسلامي صاروا اليوم أبعد عن "الإسلامية السياسية" لكنهم أقرب إلى "الأمريكانية" إذ يؤمنون بحداثةٍ ليست هي الفلسفة الفرنسية في علمانية الدولة والسياسة، ولكنها النموذج الأمريكي المحافظ الذي يمثل نقطة الوسط بين دولة دينية ثيوقراطية غير مرغوب فيها وإسلام تنويري يجد صعوبة في الخروج والنشأة.
ويختم المؤلف دراسته الجيدة بكلمات نفيسة تستحق التوقف عندها، عندما يعتبر أن "إسلام السوق" المعروض في كتابه يظهر في النهاية كأنه شريك مثالي للأمريكيين في سياستهم الشرق أوسطية، وأيضًا في صراعهم ضد الحداثة الذي يجعلهم خصوما لأوروبا عصر الأنوار والعقل العلماني ومنطق الدولة الراعية.
خاتمة
بذل باتريك هايني جهدًا تنظيريًّا وميدانيًّا كبيرًا لتشخيص بعض تحولات الصحوة الإسلامية والحركات الإسلامية في عالم يتغير بسرعة كبيرة، ويتداخل بعضه مع بعض بما لم يحدث من قبل.
ولا نحسب التحولات التي تابعها المؤلف إلا إفرازًا من إفرازات العولمة والتداخل بين الثقافات والسياسات والديانات استجاب له بعض الإسلاميين بالطريقة التي قدمها لنا المؤلف.
وليست الأفكار المروجة في "إسلام السوق" اجتهادا خاصا برواد الظاهرة الجديدة، إذ يوجد كثير منها عند حركات إسلامية أخرى لم يتطرق إليها الكتاب مثل حركة التوحيد والإصلاح المغربية.
ففي قضية العلاقة بين المجتمع والدولة ومطلب الدولة الإسلامية انتبهت حركة التوحيد والإصلاح مبكرًا إلى أن المجتمع أهم من الدولة، وأن الإسلام يمكن أن يحيا ويزدهر ويبقى دون الحاجة إلى الدولة.
"التدين المدروس في كتاب باتريك هايني شكل من الأشكال وتعبير من التعبيرات الساعية إلى رفع الحرج والتعارض النفسي لدى المتدين الجديد"
وللدكتور أحمد الريسوني الرئيس السابق للحركة كتب ومقابلات ومساجلات في هذه القضية.
وقد استطاعت هذه الحركة أن تفرع عن هذا الفهم أن العمل السياسي لا يستحق الحجم الضخم الذي يقدم به في أوساط الحركات الإسلامية وغير الإسلامية، ومثل هذا يقال عن قضية العمل الاقتصادي والمالي للأفراد والحركات.
وربما كان اقتصار المؤلف على نماذج هو أقرب إليها بحكم إقامته الطويلة في مصر واطلاعه على التجربة الإسلامية في بلدان الغرب خاصة فرنسا، هو السبب في هذا.
غير أن الكتاب امتاز بشيئين: أحدهما إلقاؤه الضوء على ظاهرة لا تعيرها مراكز البحوث والدراسات والرصد ووسائل الإعلام الغربية الاهتمام اللازم، لحاجات ذات صلة بالجغرافيا السياسية وأجندة الأجهزة الاستعلامية التي تعتمد المقياس السياسي بالدرجة الأولى، والمسافات بين الظواهر والخطوط الحمراء.
والثاني تقديم تفسير معتبر للظاهرة الإسلامية الجديدة ودعاتها ووعاظها واستجابتهم لتحدي العولمة والحداثة والإعلام الجماهيري وتقديم أشكال جديدة من التدين والعمل الإسلامي تقدم بدائل للغاضبين من الجمود الحركي الإسلامي من جهة، وللرافضين للانخراط في بنياتها التنظيمية من أبناء المجتمع من جهة ثانية.
وقد حرصت الحركات الإسلامية على تقديم نموذج واحد للتدين اتسم بالمثالية المفرطة ولم يراع الواقع المعاصر، كما لم يراع تغير الأشكال في التدين بحسب الثقافات والسياسات والنفوس البشرية.
وأظن أن التدين المدروس في كتاب باتريك هايني شكل من الأشكال وتعبير من التعبيرات الساعية إلى رفع الحرج والتعارض النفسي لدى المتدين الجديد، وتستحق هذه الظاهرة المتابعة والرصد حتى نهايتها أو دخولها في تحول ومنعطف جديدين.
فالإسلام كما قال حسن الترابي يوما ما: "طريق وليس حالة"، ومن المعلوم أن الطريق غاص بمستعمليه وهم يتنوعون حسب سرعاتهم ومراكبهم وبنائهم النفسي وما يتعرضون له أثناء سيرهم من لذة وألم.