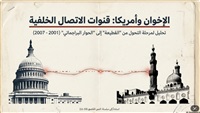السلفية الجهادية في تونس.. الواقع والمستقبل
الثلاثاء 21/يوليو/2015 - 07:34 م
طباعة
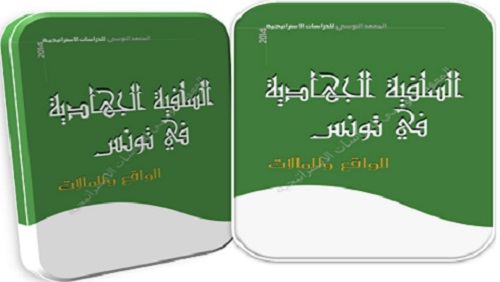

د. محمّد الحاج سالم
• الكتاب: السلفية الجهادية في تونس: الواقع والمآلات
• تحرير وتقديم: د. محمّد الحاج سالم
• الناشر: المعهد التونسي للدّراسات الاستراتيجيّة
• سنة النشر: ديسمبر 2014
في ظلّ انفلات الساحة الدينيّة وما مثّله ذلك من مخاطر الجنوح للعنف وتهديد الأمن والتمرّد على القانون، تشكّلت في بداية سنة 2013 وحدة بحث هي المعهد التونسي للدّراسات الاستراتيجيّة تولّت دراسة هذه الظاهرة وضمّت ثلّة من الباحثين الشبّان من اختصاصات مختلفة قامت بجملة من البحوث كانت حصيلتها هذا الكتاب.
وكما تقول مقدمة كتاب "السلفية الجهادية في تونس: الواقع والمآلات" للدكتور محمّد الحاج سالم، فقد أدّت الثورة التونسيّة، من ضمن تداعياتها الأخرى، إلى نوع من القطع مع المركزيّة الدينيّة ودولنة الدّين، وجاء الدستور الجديد مكرّساً لحريّة الضمير استجابة لحاجة باتت ملحّة في المجتمع، حيث بات كلّ تونسي حرّ الكيان في الانتماء للمدرسة العقائديّة والمذهبيّة التي يختارها.
وبانهيار الوصاية الدينية للدّولة على المجتمع وضمائر التونسيّين، برزت ثقافات دينيّة جديدة تعبّر من خلالها فئات من المجتمع على مقاربات أخرى للمشغل الديني وقضاياه، وأدّى انفجار المكبوت الدّيني إلى انفلات واضطراب في مجالات الشّأن الديني والإعلامي والثقافي كانت نتيجته حدوث تصادم بين المجالين الإعلامي والثّقافي من جهة والمجال الدّيني من جهة أخرى.
وفي هذا الخضمّ، تطوّرت في السياق التونسي، وهو سياق غير مستقلّ بأيّ حال عن السياقات السياسيّة الإقليميّة والدوليّة، أشكال تنظّيم ديني خارج إطار رقابة الدولة ودون انتظام معنوي ضمن المنظومة المدنيّة، تستمدّ مشروعيّتها مباشرة ممّا تعدّه سلطة إلهيّة، أهمّها ما اصطلح على تسميته ظاهرة السلفيّة الجهاديّة.
إن هذا الكتاب كما تقول مقدمته، حصيلة بحوث من منظورات علميّة مختلفة دامت لسنة ونصف وأنجزت فيها وحدة البحث حول السلفيّة الجهاديّة أعمالاً بدأت بإنشاء قاعدة معلومات حول الظاهرة قامت على تجميع أدبيّات التيّار السلفي الجهادي المكتوبة والمسموعة والمرئيّة بغية استكشاف الإطار الفكري الذي خرجت منه هذه الظاهرة شكلها الإيديولوجي. وقد صاحب هذه الفترة نقاشات عميقة مع بعض منظري التيّار بهدف التعرّف ميدانيّاً على أنشطتهم وكيفيّة تنزيل أفكارهم في الواقع المحلّي. إلاّ أنّ الأحداث التي شهدتها البلاد من اغتيالات سياسيّة وعمليّات إرهابيّة اثبتت لدى أجهزة الدولة ضلوع تنظيمات جهاديّة فيها (تنظيم أنصار الشريعة وكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أساساً) أدّى إلى بروز مصاعب جمّة في التواصل مع الظاهرة، وهي الصعوبات التي تفاقمت بالخصوص بعد انتهاء مرحلة الاستكشاف ومرور وحدة البحث إلى مرحلة العمل الميداني نظراً إلى ما كان يحفّ الأمر من مخاطر أمنيّة وعزوف منظري التيّار عموماً إلى التخفّي أو الامتناع عن التواصل وإن كان لغرض علمي بحت.
فالخطاب السلفي بكلّ تنويعاته قديم وأصيل في الموروث الديني السنّي، لكن تجلّي هذا الخطاب في إيديولوجيا تعتنقها جماعات منظّمة ذات توجّه دعوي سياسي وتأخذ صورة حركات اجتماعيّة هو تطوّر حديث نسبيّاً في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المدرسة السلفيّة ذاتها. ولعلّ أهمّ ما يميّز الجماعات السلفيّة المعاصرة هو اختلافها عن حركات الإسلام السياسي التقليديّة، فهي متعدّدة وسريعة التكاثر وغير مستقرّة وغير منتظمة هرميّاً، وهو ما يعكس تشظّي مرجعيّاتها بين المحلّي والإقليمي والدولي، ويفسّر إلى حدّ ما، اعتمادها مبدأ «سلفيّة المنهج وعصريّة المواجهة«. إنّنا أمام ظاهرة جديدة تحدوها إرادة تغيير الآخر القريب (المجتمع) والآخر البعيد (الغرب) وينطلق موقفها من مجرّد المعارضة على مستوى الخطاب ليمرّ في أحيان كثيرة إلى الاحتجاج من خلال الممارسات السلوكيّة، ليصل أحياناً درجة المحاربة الماديّة الفجّة. فالفكر السلفي الجهادي اعتراضي ومعارض بطبيعته، لكنّه ليس عارضاً بقدر ما هو نتيجة للسياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتضافر ذلك مع السياسات الدوليّة والظروف الإقليميّة العاصفة.
فقد ركزت مجموعة الباحثين، في مفتتح هذا العمل على قراءة مسيرة التيّار السلفي الجهادي في تونس من خلال المراحل التاريخيّة الأربع لتطوّره على المستوى العالمي، وهو ما تناوله البحث الأوّل تحت عنوان «الثابت والمتحوّل في مسيرة التيّار السلفي الجهادي في تونس« (طارق الكحلاوي). وقد حاول هذا البحث وضع التجربة الجهاديّة التونسيّة في سياقاتها الإقليميّة وعلاقتها بالإرهاب للتساؤل حول مآلاتها المستقبليّة بين احتمالي الانتظام والتوحّش، وهو ما فصّله البحث الموالي المخصّص لدراسة «السلفيّة الجهاديّة في تونس بعد الثّورة وفشل تجربة الانتظام« (سامي براهم) حيث تناولت الدراسة في قسمها الأوّل التيّار السلفي الجهادي والثّورة التونسيّة لتتساءل حول مدى تأثّر هذا التيّار بالعوامل الجديدة بعد الثورة وترصد موقفه من الثورة ومدى ترسيخ تلك العوامل المستجدّة لتوجّهات جديدة داخل التيّار قد تؤثّر في وزنه وفي دوره على الساحة التونسيّة مستقبلاً. كما تناولت نفس الدراسة في قسمها الثاني التيّار السلفي الجهادي في تونس وتجربة التهيكل ضمن تنظيم أنصار الشريعة، وذلك من خلال قراءة تحليليّة لبرنامج أنصار الشّريعة وأهدافهم ووسائل تحقيقها، كي يتمّ في القسم الثالث من الدراسة قراءة موقع تونس في خطّة الجهاد العالمي المعتمدة تأسيس الخلافة من رحم الفوضى العارمة (التوحّش) أو تفكيك الدّولة وتركيب الخلافة، ومدى اعتماد هذه الاستراتيجيّة من قبل التنظيمات الجهاديّة التونسيّة ومنها تنظيم أنصار الشريعة على وجه الخصوص.
وبالطّبع كان لا بدّ من رصد ردود فعل المجتمع السياسي والمدني تجاه تنظيم أنصار الشريعة وموقف هذا الأخير منها، وهو ما تضمّنه بحث «العلاقة بين أهمّ الفاعلين الجماعيّين وتنظيم أنصار الشريعة في تونس« (عادل بن عبد الله)، حيث نجد تحليلاً مضموني يستند إلى منهج تحليل الخطاب ويتناول طبيعة التأثير المتبادل بين الخطاب السلفي الجهادي لأنصار الشريعة من جهة، وبين سائر خطابات أهمّ الفاعلين الجماعيّين سياسيّاً (حزب نداء تونس، حركة النهضة، الجبهة الشعبيّة) ومدنيّاً (الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، منظّمة حريّة وإنصاف) ونقابيّاً (الاتّحاد العامّ التونسي للشّغل) من جهة أخرى. وقد أعادت هذه الدراسة قراءة مواقف مختلف الفاعلين المذكورين من بعض الأحداث الفارقة في مسيرة تونس بعد الثورة بدءاً من حدث الثورة التونسيّة نفسها، أي كيف أعادت السلفيّة الجهاديّة وباقي الفاعلين الجماعيّين إنتاج هذا الحدث في أدبيّاتها وبياناتها، وكيف نظرت إلى موقع الطرف الآخر ودوره فيه، ثمّ حدث انتخابات 23 أكتوبر 2011، وكيف أصّلت السلفيّة الجهاديّة موقفها "الشرعي" من هذا الحدث (بكلّ فلسفته ومؤسّساته والفاعلين فيه بما في ذلك حركة النهضة ذات المرجعيّة الإسلاميّة)، وكيف تعامل أهمّ الفاعلين الجماعيّين مع هذا الموقف أو كيف أثّروا في بنائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ثمّ حادثة معرض العبدليّة بالمرسى وما تلاها من اعتداء على السفارة الأمريكيّة وما أعقبها من تحوّل جذري مسّ علاقة السلفيّة الجهاديّة بحركة النهضة خاصّة، ليتمّ إثرها قراءة الخطابات الخاصّة بحوادث الاغتيال السياسي وسلسلة الأعمال الإرهابيّة الموجّهة ضدّ أجهزة الأمن والجيش، دون نسيان الحدث الفاصل في مسيرة تنظيم أنصار الشريعة حين عقد مؤتمره الثاني بالقيروان، والجدل الذي حدث بعد رفض التصريح له بإنجاز مؤتمره الثالث، وأخيراً حدث تصنيف أنصار الشريعة تنظيماً إرهابيّاً.
وقد مهّدت هذه القراءات لسياقات تمظهر الظاهرة السلفيّة الجهاديّة محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، لتناول الظاهرة ضمن سياقها التونسي البحث عبر سلسلة من البحوث الميدانيّة استهلّت بـ«مقاربة نفسيّة اجتماعيّة للظّاهرة السلفيّة في تونس« (محمّد الحاج سالم)، وهو بحث مرتكز على تقنيات البحث الاجتماعي ويعتمد المنهج الوصفي الاستقرائي لمسائل تهمّ الانتظام الهيكلي للجماعات الجهاديّة وإيديولوجيّتها المتميّزة بالتكثّف واعتماد مبادئ التمايز والاكتفاء الذاتي والقطيعة بين الجماعة وبقيّة المجتمع من خلال تطوير ثقافة ثانويّة مضادّة من قبل شرائح شبابيّة تمرّ عبر مصفاة انتداب تعتمد تقنيات استيعاب وتشريط نفساني وجسماني مخصوصة. ويخلص البحث إلى أنّ الشباب الجهادي في تونس هو شباب مهمّش في مجال حضريّ مهمّش لا يرى في الدولة والمجتمع إلاّ وجههما التسلّطي الإقصائي، ولا سبيل إلى ردّ العنف المادّي والرمزي للدّولة والمجتمع إلاّ بعنف آخر يوازيه في القوّة ويهزّه في العمق. وينبّه إلى أنّ استمرار عدم الاستقرار السياسي ومناخ التهميش والإقصاء لفئات من المجتمع من شأنها تغذية الاندفاع نحو تبنّي الإيديولوجيا السلفيّة وخاصّة تعبيراتها القصوى الجهاديّة.
ويلي هذا «دراسة ميدانيّة للظاهرة السلفيّة في حيّ شعبي« (معتزّ الفطناسي)، وهو حيّ سيدي حسين الواقع على التخوم الغربيّة لمدينة تونس بوصفه أحد الأحياء الشعبيّة التونسيّة الأكثر احتضاناً للأفراد المنتسبين للتيّار السلفي الجهادي، وقد تميّز بشهوده عدداً كبيراً من الاشتباكات والمواجهات بين منظوري التيّار وقوّات الأمن. وقد حاولت هذه الدراسة رصد التحوّلات التي عايشتها الظاهرة السلفيّة بمنطقة سيدي حسين، وقدّمت صورة واضحة لما آل إليه المشهد العامّ للحضور السلفي، ومن ثمّة حاولت فهم طريقة تشكّل المشهد الحالي للظّاهرة باستخدام المنهج التحليلي وخاصّة العوامل التي أدّت إلى تقلّص الظاهرة في الحيّ المذكور سواء نتيجة تدخّل أجهزة الدولة المتمثّل بالخصوص في تكثيف الحملات الأمنيّة ومنع التظاهرات والتحركات الميدانيّة وغلق الجوامع خارج أوقات الصلاة واستبدال الأئمة المحسوبين على التيّار السلفي الجهادي ومعاقبة المتجاوزين منهم، أو من خلال ما أسماه المقاومة المجتمعيّة ورفض عموم الناس للظّاهرة، وكذلك ما عرفه التيّار من انقسامات داخليّة بفعل الأحداث الإقليميّة التي أدّت إلى التحاق العديد من الشباب بجبهات القتال في ليبيا ثمّ سوريا، ليفقد التيّار السلفي الكثير من أنصاره وعناصره النوعيّة. وهي الخلافات التي غذّتها خلافات المجموعات الجهاديّة المقاتلة في سوريا حيث انقسم الشباب السلفي في منطقة سيدي حسين بين مؤيّد لجبهة النصرة ومؤيّد لتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام بعد دخول الطرفين في مواجهات دامية، ممّا أضعف التيّار وشتّت جهوده، خاصّة وأنّ انتساب الكثيرين للتيّار السلفي لم يكن لأسباب فكريّة أو عقديّة بقدر ما كان لأسباب نفعيّة وانتهازيّة يُرجى منها تحسين الوضعيّة الماديّة والاجتماعيّة.
وتأكيداً للمنحى الميداني الذي أردنا توخّيه في دراسة الظاهرة، تأتي الدراسة الخاصّة بالشباب الجهادي في دُوّار هيشر: دراسة حالة إثنوغرافيّة « (جهاد الحاج سالم) كي تتعمّق في إشكاليّة تحوّل «الفضاءات الهامشيّة» التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتنتشر فيها بشدّة مظاهر الانحراف والجريمة والاقتصاد اللاشكلي، إلى «فضاءات احتجاجيّة» تتخلّق في رحمها الهويّات الرّافضة، ومن بينها على وجه الخصوص الهويّة التي يقوم عليها ويبشّر بها التيّار السلفي الجهادي ضمن مسار حشد إيديولوجي ذي منهل ديني صارخ.
إنّها دراسة لاستراتيجيّة التيّار الجهادي الدعويّة التي لم تتّخذ شكلاً حزبيّاً أو جمعيا يخضع لمحدّدات الانتظام المدني التي تمليها الثقافة السياسيّة التونسيّة، وبقيت تُمارَس ضمن شبكات ممتدّة تفتقر إلى الهيكلة والتّراتب الهرمي الشكلي والصفة القانونيّة الرسميّة إزاء الدولة، متّخذة شكل مجموعات من الشباب الجهادي المتناثرة في مناطق متعدّدة على مدى البلاد. ومن خلال تتبّع انتشار هذه المجموعات من الشباب الجهادي في أحد الأحياء الشعبيّة للعاصمة من خلال عدد من الفضاءات، التقليديّة والمستحدثة، ذات الوظائف الدينيّة والسياسيّة والاقتصاديّة المتمايزة والمتداخلة، تسعى هذه الدراسة إلى تحديد جملة أنشطتها وممارساتها اليوميّة التي تحشد نموذجاً معياريّاً متخيَّلاً ومتعيّناً في جماعة المسلمين الأولى (السلف الصالح) حسب ما تبلوره الإيديولوجيا الجهاديّة، ومعرفة كيفيّة نشرها لتلك الإيديولوجيا على مستوى الساحات المحليّة والمعيش اليومي، مشكّلة حركة اجتماعيّة جذريّة مضادّة لنمط العيش السائد تحمل في طيّاتها مشروعاً سياسيّاً طموحه إعادة هيكلة الروابط الاجتماعيّة التي توثّق عرى الأفراد بعضهم ببعض وبالدّولة وفق قيمٍ وترتيباتٍ جديدة.
وتقوم هذه الدراسة غير المسبوقة حول السّمات السوسيولوجيّة التي يختصّ بها الشباب الجهادي في دُوّار هيشر، على محاولة الإجابة على جملة من الأسئلة المحوريّة: من هو الشباب الجهادي بدُوّار هيشر؟ كيف تجري ديناميكيّات حشد الإيديولوجيا الجهاديّة في معيشه اليومي وحِراكه؟ كيف تشكّلت ساحة التيّار الجهادي في الحيّ؟ وما هي العمليّات التي يعيشها هذا الشباب ضمنها؟ وذلك باعتماد منهجيّة جمعت بين مقاربتي الإثنوغرافيا ودراسة الحالة، تماشياً مع سعيها إلى استكشاف الديناميّات الداخليّة لما تعتبره ساحة حركة اجتماعيّة جذريّة تشكّلها مجموعات من الشباب الجهادي داخل حيّ شعبي، وفي سبيل ذلك، توجّب على الباحث الاقتراب من هذه المجموعات لاستكشاف معيش فاعليها وأنشطتهم وطرق استيعابهم لتجاربهم عبر استخدام أداتي استقصاء أساسيّتين، وهما الملاحظة المركّزة والمقابلات البحثيّة المفتوحة المدعّمتين بالمعطيات الكميّة.
وبتعرّفنا إلى السمات السوسيولوجيّة التي يختصّ بها الشباب الجهادي، نصل إلى مرحلة محاولة التعرّف على مآلات التيّار السلفي الجهادي في تونس من خلال الدراسة الموسومة بـ«السلفي الجهادي في تونس: دراسة استشرافية« (ماهر الزغلامي). وهي دراسة سعت، باعتماد منهجيّة الدراسات الاستشرافيّة وتقنية السيناريوهات باعتماد الملاحظة بالمشاركة وتحليل الخطاب، إلى التعرّف على مسار ظاهرة التيّار الجهادي على ثلاثة مستويات. مستوى أوّل تمّ فيه وصف المشهد السلفي الراهن بالبلاد، ومستوى ثانٍ أضيق وأكثر تعمّقاً، يتعلّق بدراسة الحوادث التي أسهمت في تشكيل الملمح الراهن للظّاهرة السلفيّة الجهاديّة في تونس، ومستوى ثالث، وهو تتبّع مجهري لسيرة حياة شابّ سلفي جهادي.
ولعلّ أهمّ قسم من أقسام هذه الدراسة هو تناولها المجهري لسيرة شخصيّتين جهاديّتين في تفاعلهما مع عدد من الوقائع والأحداث سواء منها العامّة أو الخاصّة بالتاريخ الشخصي لكلّ منهما. وقد سعى الباحث إلى تركيبها جميعاً بحيث غدت جميع الأحداث والمعطيات التي تمّ رصدها حول الظاهرة السلفيّة الجهاديّة ببعض الأحياء الشعبيّة بالعاصمة مثيل صور متحركّة أمام أعيننا، وهو مكّن من الكشف عن التناغم والترابط بين جميع تلك الأحداث والوقائع والبيانات والعوامل، وبين الشخصيّتين مجال الدرس بوصفهما من الفاعلين المؤثّرين في الظاهرة.
وبتجاوز الدراسة مرحلة استكشاف مسار التيّار السلفي الجهادي في تونس ودخولها مدار الاستشراف، طرحت علينا فرضيّتين تتعلّقان باتّجاهين مدعومين بحزمة من المعطيات المرصودة. أولاهما، إمكانيّة تشتّت الظاهرة ونزوعها نحو حدّها الأعنف بمقتضى الاندماج في حركة الجهاد المعلوم وما يفرزه من أعمال فرديّة غير قابلة للتنبّؤ أو الحصر واستدامة هذه الحالة. والثانية، إمكانيّة بروز نمط من المراجعات يبعد بالظّاهرة عن العنف. ولعلّ هذه الإمكانيّة الثانية هي ما تعرّفنا عليه الدراسة بأكثر عمق من خلال مقابلات الباحث مع الشيخ منير التونسي الذي بدأ بعد سلسلة المراجعات صلب التيّار الجهادي على ما تثبته بعض كتاباته وخطبه الأخيرة، ممّا يفتح باباً جديداً أمام التيّار لتطوير أطروحاته والابتعاد بها عن كلّ عنف.
وفي إطار هذا العنف المراد فهمه وتفهّم دواعيه العقديّة والاجتماعيّة والنفسيّة، يتنزّل البحث النفسي الموسوم بـ"عامل العُصابيّة في الشخصيّة السلفيّة في علاقته مع بعض المتغيّرات" (العربي النفاتي)، وهو بحث يركّز على تحليل البناء النفسي للشخصيّة السلفيّة من وجهة علاقتها بالعُصاب من حيث هو عدم توافق انفعالي مزمن يجد ترجمته في احتداد مشاعر القلق والغضب والعدائيّة والاكتئاب والتقدير السلبي للذّات والاندفاع. وهو بحث يعد أيضاً بالكشف عن الفروق الجوهريّة في مكوّنات البناء النفسي للشخصيّة السلفيّة ومدى تأثّرها بعدّة متغيّرات (الحالة الاجتماعيّة والعمر والمستوى الدراسي والجنس والوسط واستهلاك الموادّ المخدّرة والسّجن) بالاعتماد على استبيان الشخصيّة، وهو ما يجعلنا أقرب إلى فهم طبيعة الشخصيّة السلفيّة في تونس، علاوة عن التفكير في صياغة إطار نظري حول موضوع السلفيّة وأن يفيد من الناحية التطبيقيّة أصحاب القرار على فهم الظاهرة والتعامل معها.
ولقد كانت إرادة الوحدة تتّجه إلى إنجاز دراسة علميّة جادّة تفكّك الظاهرة بمجالات تفسيريّة جديدة تتجاوز تلك التي تفسّرها بالعامل الواحد، فالأمر يحتاج إلى دراسة بمفاهيم جديدة وبأدوات نظريّة فعّالة تراكم ما توصّل إليه الباحثون في المسألة الدينيّة في تونس عموماً وفي ظاهرة السلفيّة الجهاديّة على وجه الخصوص. ومن الطبيعي أن تكون مثل هذه المشاريع البحثيّة، التي يتقاطع فيها ما هو بحثي أكاديمي مع ما هو إجرائي، من المواضيع الشائكة التي يكثر فيها التخبّط والتعثّر. وهذا ما جعل مجموعة الباحثين شديدي الحرص على أن تكون أعمالهم المقدّمة في هذا الكتاب للرّأي العامّ جزئيّة ومختزلة، وذلك لثلاثة اعتبارات أساسيّة كما يؤكدون على موقع المركز:
1. اعتبار منهجي يتعلّق بطبيعة الدراسة التي تراوح بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي إجرائي يتمحور حول المساعدة في رسم السياسات من خلال إنارة صاحب القرار.
2. اعتبار قانوني يتعلّق بسريّة أعمال المعهد التونسي للدّراسات الاستراتيجيّة.
3. اعتبار موضوعي يتعلّق بالتغيّرات المتسارعة الطارئة على موضوع الدراسة.
وعليه، فإنّ هذا العمل الرصدي لا يمثّل سوى خطوة أولى في طريق البحث، ولكنّها خطوة نرجو أن تكون ثابتة في سبيل البحث عن الأنساق العلائقيّة الرابطة بين الإيديولوجيا السلفيّة الجهاديّة من جهة، وبين الشخصيّة القاعديّة التونسيّة من جهة ثانية، ثمّ البحث عن آليّات نظريّة تفسّر هذا «الانزلاق« والترحال نحو الفضاءات والمجموعات «الجهاديّة« وأسباب اعتناق إيديولوجيا طوباويّة تؤمن بالعنف والإرهاب سبيلاً للتّغيير المجتمعي وتبرّر القتل وسيلة للتّغيير السياسي، وتكشف عن مواطن الخلل في منظومات تعليم وتأهيل وتشغيل وتنمية باتت ترفد صفوف هذه المجموعات بنخبة من شبابنا نرى اليوم أنّها قادرة على القيام بمراجعات تكون من العمق بحيث تعيد صياغة الظاهرة في سياقات تونسيّة محضة، بما يبتعد بها عن العنف والإرهاب والتمرّد على الدولة وعن كلّ محاولات التوظيف الخارجي، ليساهم شبابها في ما ينفع البلاد والعباد.