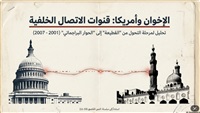لا إكراه في الدين.. ولا وجود لحد الردة
الإثنين 07/مارس/2016 - 01:15 م
طباعة
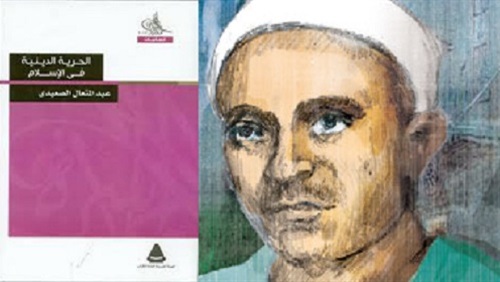
اسم الكتاب: الحرية الدينية في الإسلام
المؤلف: عبد المتعال الصعيدي
الناشر: الهيئة العامة للكتاب 2012
هذا الكتاب يأتي مع ما اتفقت عليه الشعوب جميعًا، وشرعته في دساتيرها الحديثة على حرية الاعتقاد؛ إذ أثبت فيه بأدلة عقلية ونقلية تقبل النقاش أن الحرية الدينية في الإسلام مهمة ومطلقة لا تقييد فيها، وليكون له بها فضل السبق على مشرعي عصرنا فيما شرعوه من حرية الاعتقاد، وهو فشل للإسلام عظيم الشأن في هذا الزمان.
لا يكون الدين بالإكراه ولا عنوة ولا بقطع اليد وجز الأعناق وحتى الردة عنه ليس لها عقاب دنيوي. هذه هي فلسفة هذا الكتاب صغير الحجم عظيم القيمة يرد فيه المؤلف على من قال: إن آيات عدم الإكراه الديني منسوخة بآية القتال، يرد بكلام الشيخ الإمام محمد عبده الذي أبطل هذا المفهوم بالنسخ، وهاجم هذه التفسيرات بضراوة ودفع هذه التهمة البشعة عن انتشار الدين بسطوة السيف، وقال: إن إيمان المكره باطل ولا يصح.
لم ترهب شيخنا عبد المتعال الصعيدي كلمة الإجماع وقال: إن الحق قد يكون مع الواحد دون الجماعة. كما قال ابن حزم واستدل بأبي بكر عندما كان الوحيد الذي وافق على حروب الردة برغم رأي الجماعة المضاد! مع ملاحظة أن حرب الردة كانت حرباً سياسية لاستقرار الدولة ممن يهدمون مبدأ الدولة ووحدتها وليست حرباً دينية، أما الحديث الذي يعتمد عليه البعض في قتل المرتد يقول عنه الإمام شلتوت «الحدود لا تثبت بأحاديث الآحاد، وإن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم».
هذا الكتاب كان معرضاً للمصادرة ومطارداً ولكن قدر له أن يفلت من المصادرة ويعيش ليقف حائط صد أمام جحافل الظلام.. إن الصراع ليس صراعاً بين إسلام وإلحاد فهذا لا يوجد ومن يقول بوجوده فهو يخترع أشياء لاوجود لها إلا في خياله، الصراع الحقيقي إسلام ضد إسلام، فهم إسلامي متجدد مستنير ضد فهم آخر متزمت متكلس محنط مقولب واقف عند شاطئ الماضي رقبته مشدودة إلى الخلف دائماً، يعيش أسير كبت وعقدة اضطهاد وإحساس بدونية أمام الآخر المتقدم الذي بدلاً من أن يتساءل كيف تقدم، يصر على تدميره!
ما يسجله الشيخ عبد المتعال الصعيدي- الأزهري المخضرم المولود عام 1895- في كتابه المهم هذا لن يروق بكل تأكيد للمتشددين الذين يستخدمون الإسلام وسيلة ومرجعية للاعتداء علي الآخر وقتله أيضا لو تطلب الأمر، لكنه أيضا لن يعجب أي حاكم مستبد- وما أكثرهم- كيف هذا وهو يصدر كتابه بتعريف للحرية السياسية بأنها «احترام رأي الفرد في الحكم بحيث لا تضيع شخصيته في شخصية الحاكم، بل يكون لرأيه سلطانه فيما يراه ولو تعلق بشخص الحاكم نفسه، فيكون له الحق في معارضة إسناد الحكم إليه، وفي نقد أعماله بالوسائل النزيهة في النقد».. الكتاب لا ينتصر للحرية السياسية للفرد في الإسلام في سطور قليلة وإنما يفرد لها فصلا كاملا بعنوان «الإسلام والحرية السياسية» ويكتب منحازا لمعارضة الحاكم قائلا:«ولما كانت الأمة مصدر السلطات كان لكل فرد من أفرادها حق في هذه السلطة، فيؤخذ رأيه في تنصيب الحاكم، ويكون له حق الاعتراض علي ما يري الاعتراض عليه من الحكم، ويكون له حرية تامة في ذلك، أصاب في اعتراضه أو أخطأ.. ذلك لأن الفرد كان له حق الاعتراض علي الحاكم في عهد النبوة، وهو ما هو من اتصاله بالوحي السماوي، وكان الاعتراض علي النبي صلي الله عليه وسلم من الأفراد في بعض أحكامه يتجاوز أحيانا حق الاعتراض المقبول».. أين إذن «العلماء» الذين يخرجون ليؤكدوا أنه لا خروج علي طاعة الحاكم إذا كان هناك من اعترض بالأساس علي حكم النبي صلي الله عليه وسلم وهو المعصوم من الخطأ.
ويربط “الصعيدي” بين “التوحيد” والحرية الدينية من جانب، و”الوثنية” والاستبداد والاستبعاد الديني من جانب آخر، مؤكدً أن الوثنية دين الاستعباد والاستبداد من طغاة البشر لضعفائهم، وهؤلاء الطغاة يفرضون عبادة أنفسهم وأوثانهم على الناس، فأخذ الناس بوسائل القوة وإكراههم في عقائدهم هو الوثنية ذاتها.
على أن هذا الفصل في الكتاب ليس أكثره هدمًا لأقوال راسخة مغلوطة، وإنما يصل الأمر لذروته في الفصل المعنون بـ«الإسلام والحرية الدينية»، ويتطرق المؤلف إلى قضية الجزية، والتي يفند كل أصولها، ففي نظره، لم تجب الجزية على الناس لكفرهم بل لحرابهم، فلهذا لم تجب على “النساء” و”الذراري” ونحوهم ممن لا يصلح للحرب، وهذا يفيد أن الجزية ليست إلا غرامة حربية وأنها لا شأن لها بكفرهم، فلا يكون لها تأثير في تركهم له، ولا يكون في فرضها عليهم أدنى وسيلة لحملهم على الإسلام، لأن الإسلام أكبر من أن يغري الناس على دعوته بالمال، يأخذه من غيره باسم الجزية، فإذا أسلم لم يأخذه منه، لأنه إذا أسلم أخذ منه الزكاة، وهي ضريبة تصاعدية تبلغ ما لا تبلغه الزكاة.
ويشدد صاحب “القضايا الكبرى في الإسلام” على أن الجزية تكون على من قاتل المسلمين فحسب، ولا يصح أن نقاتل من لم يقاتلنا لنأخذ الجزية منه، وإذا قاتلنا من قاتلنا منهم فإنه لا يجب أن نمضي في قتاله إلى أن نهزمه ونأخذ الجزية منه، بل يجب علينا أن نكف عن القتال إذا كف عنه وطلب موادعتنا، ولا يجب أن نأخذ منه جزية في موادعتنا له. ولذلك قيمته في عصرنا الذي يقدس حرية الاعتقاد، ويرى أنه لا يصح أخذ الناس فيه بشيء من وسائل الإكراه. فإذا أخذنا به في الإسلام بعدنا به عن توجيه مطعن من مطاعن عصرنا إليه، وبعدنا به عن المخالفة لذلك الأصل –حرية الاعتقاد- الذي تأخذ به الآن جميع الأمم، وتضعه ابتداء دساتيرها، ليعيش الناس أحرارًا في عقائدهم، ولا يكون لأحد سلطة عليهم، ولا يكون هناك حساب على العقائد إلا حسابه تعالي في الآخرة، فمن شاء آمن بهذا الحساب ومن شاء لم يؤمن.
ويتعامل الشيخ عبد المتعال الصعيدي مع الحديث النبوي الشهير:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» بوصفه من أحاديث الآحاد التي تفيد الظن الذي لا يجب العمل به في العقائد، مؤكدا أن حرية العقيدة في الإسلام هي أصل وليست فرعاً، مستشهدا بذلك بالواقعة الشهيرة التي قام بها الرسول صلي الله عليه وسلم عند فتح مكة عندما قال:«أن من دخل الكعبة ولم يقاتل فهو آمن ومن دخل داره وأغلقها عليه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قائلا بأن الرسول لم يقل حينها من أسلم فهو آمن، تأكيدا علي حرية العقيدة في الإسلام ورغبة منه- صلي الله عليه وسلم ـ في أن يكون الاعتقاد صحيحا، ومن هذه النقطة ينطلق الكتاب إلى النقطة الأكثر جدلا في تاريخ الإسلام المتعلقة بالتعامل مع المرتدين عن الإسلام، مستعرضا الأحاديث النبوية الشريفة والوقائع التاريخية في قتال المرتدين قبل أن يصل إلى القول الحسم: «المرتد يستتاب أبدا ولا يقتل» لأنه قريب مما ذهبنا إليه من أن المرتد يدعي إلى العودة إلى الإسلام بالتي هي أحسن، كما يدعي إليه الكافر الأصلي سواء بسواء، وهذا قول ينسب إلى قوم ذكر منهم ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع»، وهم عمر بن الخطاب، وسفيان الثوري، وإبراهيم النخعي.. ولا يكتفي الشيخ عبد المتعال بقول هذا وإنما يذهب إلى أن المسلمين يجب أن يشغلهم عن دنياهم ما هو أهم من عودة مرتد إلى الإسلام، واشتغالهم باستتابة المرتد أبدا يعطلهم عن مصالحهم، وسيكون له من عقاب الله في الآخرة ما يغني عن اشتغالنا باستتابته إلى هذا الحد، هل يقرأ هذه السطور إذن ويفكر فيها- لم نقل يقتنع- هؤلاء الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها عند خروج أحدهم من الإسلام؟
ويختتم الكتاب فصوله بعرض لنماذج ممن أسماهم أحرار الفكر في الإسلام، ويبدأ بعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يعتبر الشيخ الصعيدي أن له إنجازين أساسيين في حرية الفكر أولهما هو التأكيد علي أن يعمل الإنسان للآخرة وألا ينسي نصيبه من الدنيا، فاقتني الأموال وارتدي أفخر الثياب مستفيدا من ثراء الدول الإسلامية في عهده وذلك حتى لا يفهم الناس أن الإسلام مجرد تقشف ولا يتسع لوسائل الحضارة، أما الإنجاز الثاني فهو أن عثمان- رضي الله عنه- جمع المسلمين علي مصحف واحد ووزع نسخاً منه علي سائر الأمصار الإسلامية، وإذا كان الإنجازان قد يبدو أن في قراءة سريعة متناقضين، فإن المؤلف يؤكد أنهما يصبان تمامًا في معني عنوان كتابه حرية الفكر في الإسلام، فمن يقرأ إذن ويعمل عقله في ذلك المعني؟