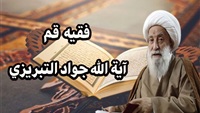تأبين "علي مبروك" ناقد العقل العربي في جامعة القاهرة
الأحد 01/مايو/2016 - 02:35 م
طباعة

نظمت كلية الآداب جامعه القاهرة في الخامسة من مساء أمس السبت 30 أبريل 2016. حفل تأبين الدكتور على مروك وقد نظمته الدكتورة هدى الخولي وأدار اللقاء الدكتور أحمد زايد عالم الاجتماع وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، كما تحدث في هذا اللقاء الدكتور هاني المرعشلي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا، متناولاً الجانب الإنساني لدى علي مبروك، وأنه واحد من أهم الذين تناولوا موضوع الخطاب الديني بالدرس والتحليل، فكان نافذًا موضوعيًا لتراثنا الثقافي، هادفًا إلى تحرير العقل من كل سلطة تقوم بتقييده. وكذلك فقد تحدثت الدكتورة رجاء أحمد رئيس مجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة عن الدكتور علي مبروك وكيف كان مثالاً للأخ والزميل والمدرس الذي يتفانى في عمله ويقدر زملاءه ومكانتهم العلمية، ويساعد كل من حوله..

وكذلك الدكتور أحمد الشربيني وكيل كلية الأداب جامعة الإسكندرية تحدث حول الصداقة التي ربطت بينه وبين الدكتور علي مبروك، وكيف أنه كان متابعًا جيدًا للشأن العام ويهتم بقضايا الوطن ويتفاعل معها ولم يقتصر دوره عن كونه أستاذًا جامعيًّا، بل كان يفتح آفاقًا جديدة للتعامل في قضايا الوطن من خلال برامج تليفزيونية أو مقالات في المجالات والجرائد، والدكتور محمد النجار الذي وضع يده على أهم ما يميز علي مبروك وهو منهجه في البحث عن إجابات لأسئلة الواقع، فكان دائمًا ما يطرح أسئلة كاشفة ويحفز طلابه على البحث عن إجابات وطرح الأسئلة، وقد قرأ رسالة من الدكتور عبدالوهاب جعفر إلى روح علي مبروك.
وتحدثت السيدة عبير خطاب زوجة الراحل علي مبروك عن سلوكه في قاعات الدرس كأستاذ جامعي وكإنسان وكيف تعرفت عليه في نفس المدرج الذي أقيم فيه حفل التأببين..
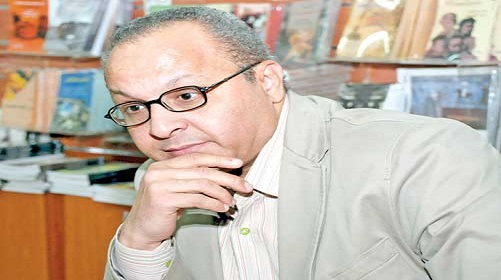
ومن بين الكلمات التي تناولت مشروع علي مبروك الفكري كلمة الدكتور أحمد سالم أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا والذي قال فيها:
كيف أرثي نفسًا قررت أن تخرج عن كل ما هو مألوف في وطن يقهر كل ما هو مختلف؟ بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد سالم أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا كلمته في تأبين الراحل علي مبروك، وقام بعرض ملامح مشروعه الفكري الذي كان يسير عكس التيار مستندًا إلى تراث أجيال متتابعة بداية من محمد عبده مرورًا بأمين الخولي وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد، إلى أن وصلت شعلة الريادة له ليكمل الطريق الصعب، سابحًا عكس تيار النقل والحفاظ على ما هو موجود، فاتحًا آفاقًا جديدةً نحو المعرفة والحرية، من خلال نقد التراث، ونزع القداسة عن ما هو ليس بمقدس، فكان علي مبروك نموذجًا لكل نفس حرة أبيه، فكان قدوتنا وإرادتنا الحرة وقبلتنا، متى كنا عاجزين عن النطق، في مواجهة جحافل الجاهلين الذين لا يبغون التغيير، فارتضى علي مبروك لنفسه أن يكون صاحب رسالة في المدرج وخارج المدرج، في الشارع، مع البسطاء ومع العلماء، كانت قضيته تنحصر في الحرية، وتحرير العقل من أي سلطة، باعتبار أن لا سلطة تعلو فوق سلطة العقل، فكان يبغي تحرير العقل من أسر النص، وتحرير العقل من سلطة الكهنوت، وأن يكون العقل قادرًا على أن يمارس الفعل الحر في التفكير؛ لأن العقل السائد هو عقل محكوم بثقافة تقليدية عفى عليها الزمن، تلك الثقافة التي تقف حائلاً ضد تأصيل الحداثة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية.
كما كان يرى ضرورة نقد العقل السائد في الثقافة، باعتبار أن العقل السائد في ثقافتنا يقف حائلاً ضد إمكانية التقدم والارتقاء، كما كان يرى أن مشكلة العقائدي ومشكلة الديني تكمن في الأساس في السياسي، فرغم سمو الرسالة الإسلامية، لكن عبر حركة التاريخ والممارسة السياسية، التي توظف الرسالة سلبًا وإيجابًا، فكان يرى أن الكلام في علم العقائد هو في العمق كلام في السياسة، وأن حركة الخلاف داخل متون وشروح وهوامش كتب العقائد هو صراع بادعاء من يملك الحقيقة، ولكنه في الحقيقة ادعاء من يملك السلطة، فيعتقدون أن الفرق الإسلامية تتصارع على ملكية الحقيقة، لكنه في حقيقة الأمر صراع على من يمتلك السلطة.
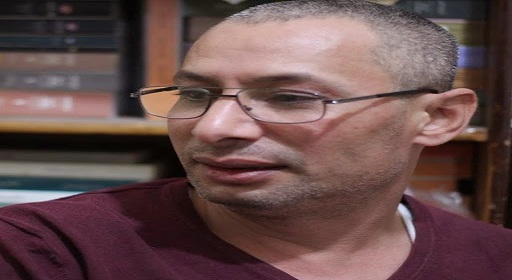
كذلك كلمة الباحث في شئون الإسلام السياسي حسام الحداد الذي تناول فيها مشروع علي مبروك الفكري من خلال كتاباته والتي جاء فيها: لم يكن أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، بل كان مشروعًا فكريَّا وثقافيًّا لم يمهله الوقت ليكتمل المشروع، فكان يفكر في قضايا وإشكاليات علمية خاصة بالمرحلة الراهنة فهو امتداد لمدرسة تشق طريقها في الفكر العربي بصعوبة شديدة، وهي مدرسة مُساءلة التراث بالعقل، فهو يربط القضايا التراثية بالواقع المعيش والحاضر، فضلًا عن عدم إغفاله للبعد التاريخي لهذه الظواهر.
وللدكتور علي مبروك الكثير من الآراء الجديرة بالالتفات والمناقشة؛ حيث يرى أن العقل العربي الراهن يعيش أزمات اقتصادية وسياسية وثقافية لكونه عقلاً غير فاعل، وعاجزًا عن إبداع حلول لمشكلات واقعه، كما أن الفكر العربي صار ناقلًا مقلدًا مكررًا بغير فهم لأفكار السلف، فلم يأت بحلول جديدة لمشاكل واقعنا العصري، وهو ما يتطلب تغيير البنية العقلية لثقافة المجتمع من خلال وسائل إعلامية وتعليمية جديدة.
كما تميز مبروك بما يعرف بـ«نقد النقد»، إذ قدم مراجعات وملاحظات على مشروعات نظرائه على طريق الفكر، ورؤيتها في إطار نقدي، اجتهد خلاله في كشف التناقضات والتباينات الفكرية في التراث والمشروعات الفكرية التي تناولته بالنقد والتحليل.
في كتابه «ثورات العرب»، قال إنه "من الضروري ترسيخ خطاب التأسيس للحداثة العربية الذي يبدأ بقراءة وإدراك الواقع وتجنب التعميم والتلفيق ومعالجة الانقسام الذي تعيشه الدول العربية وخاصة مصر، وضرورة التحرر ليس برفض الدين أو الحداثة بل بتجاوز «خطاب القوة» الذي استبد بهما والانتقال إلى «خطاب الحق» الذي جرى تغييبه عنهما".

وأكد، أن تجديد الخطاب الديني هو إصلاح الفكر الديني، أي المنتج البشري لفهم الدين والنصوص، الذي قد يكون صحيحًا أو تشوبه أخطاء.
وعن كتابه "الخطاب السياسي الأشعري" والذي طرح فيه الكثير من الأسئلة على العقل العربي يقول: "كيف يتحكم فينا التراث لهذا المدى العميق؟ كيف يحتل، وبقوة، الوعي الجمعي العربي/المسلم للدرجة التي يبدو معها وكأن هذا التراث هو أمر "طبيعي"، أمر كوني لا نملك سوى أن نسير وفقاً لصيرورته، لا نملك سوى الانقياد خلفه، فلا شيء وراء هذا التراث المهيمن ولا ثقافة غيره ... إن ما نفعله حتى الآن ليس إلا العيش على محض الأماني أملاً في تجاوز ما نحن فيه من استبداد دون أن ندرك أن بنية الاستبداد عندنا تتجاوز المستبدين كأشخاص لتصل للاستبداد كأساس في الثقافة التي هيمنت ورسخت طوال قرون من التاريخ العربي الإسلامي؛ فـ "إذ هو الانتقال - ابتداءً من أن كل ممارسة تكون مشروطة بخطابٍ يؤسس ويوجه - من عالم الممارسة إلى نظام المعنى والخطاب، فإن التعاطي مع ظاهرة الاستبداد لا بد أن يتجاوز مجرد السعي إلى إزاحة سلالة المستبدين، رغم الأهمية القصوى لذلك، إلى إزاحة الثقافة التي تنتج الاستبداد، فتنتجهم. وهنا يلزم التنويه بأن إزاحة ثقافة ما، لا يعني أكثر من أن تصبح موضوعاً لهيمنة الوعي، على نحو يقدر معه على تجاوزها، وذلك بدل أن يكون هذا الوعي هو الموضوع لهيمنتها، فتبقى مؤبدة التأثير والحضور".
ومن هنا فالاستبداد "راسخ" في تراثنا الذي هيمن، وبالتالي فهو راسخ في وعينا الذي يبدو أنه قد اكتفى بالنقل والترديد والافتخار بالمقدرة على الحفظ دون أي محاولة لإعمال العقل أو للفهم.
والحق أن "تفكيكاً لظاهرة الاستبداد العربي لا يمكن أن يتحقق خارج فضاء الأشعرية، كخطاب وثقافة، وليس كمذهب وعقيدة" .
من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب، وهو كتاب قليل في عدد صفحاته - 132 ورقة تقريباً - لكنه يجعل أعصابك ملتهبة من فرط الغضب حينما تدرك - بطريق معرفي - أن الاستبداد يستقر في الخطابات التي كُتبَ لها أن تتسيد فضاء الثقافة الإسلامية/ العربية .. عن الكيفية التي تم التعامل بها مع السياسة المستبدة على أنها شأن "طبيعي" لا راد لها ولا أمل ولا نجاة حينما تثور ضدها ... عن مسار العلاقة بين الديني والسياسي في الإسلام والمقارنة بينه وبين الوضع في المسيحية ... عن الكيفية التي صار بها الديني قناعاً للسياسي أو عن الكيفية التي أصبح الله بها (قناعاً) للسلطان المستبد ... عن الكيفية التي تم بها ترسيخ فكرة أن الحاكم/الإمام/الخليفة لا يأتي إلا بأمر من الله ولا راد لقضاء الله، فبالتالي لا راد لحكم هذا الحاكم مهما طغى واستبد.
ولعلك تندهش - بعض الشيء أو كله - إن علمت - مثلاً - أن عالم السياسة الأشعري مبني بالكامل على قاعدة الانفلات من التقيد بقانون، وإذا أدركت كذلك أن خطاب الأشعرية العقائدي هو الخطاب الذي هيمن في فضاء الثقافة الإسلامية، فلعلك تدرك أن جوهر الأزمة، التي نعاصرها الآن، تراثي بالأساس، ولا سبيل ولا مخرج إلا بنقد هذا التراث ومحاولة فهمه واستيعابه.
محاججات الكتاب كثيرة، والبحث المعرفي مكثف لمن أراد أن يفهم أو أن يقترب ولو بمقدارٍ ضئيل من الحقيقة، فهل من قارئ يرغب في الفهم؟
عن أزمة تراثية ما زالت تحيا فينا، أو نحياها ... أو لعل الوصفين صحيحان، فنحيا فيها "تاريخاً" وتحيا فينا "وعياً وثقافة وممارسة"؛ سواء كنا ندري أو لا ندري.
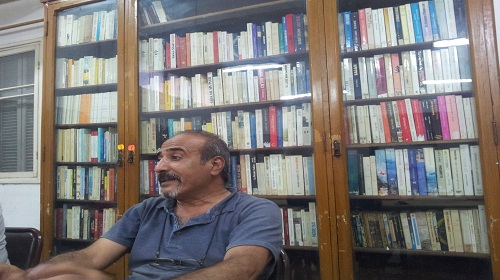
ينتقل علي مبروك إلى الثقافة ودورها في تكريس الاستبداد والعنف بسبب هيمنة الخطاب الأشعري على الفضاء الثقافي العربي فيقول: “وإن تكون الثقافة في حقل ما يؤسس للاستبداد والعنف، فإن ذلك يعني أن كافة المنضوين تحت مظلتها الواسعة – وعلى تباين انتمائهم الأيديولوجي- سوف يكونون حاملين لجرثومة الاستبداد والعنف، حتى ولو كانت في حال الخمول وعدم الفاعلية عند البعض من هؤلاء، وبحسب ذلك، فإنه ليس ثمة فارق بين الدولة والقائمين عليها وبين خصومها أدعياء الإسلام السياسي وغيرهم، وفقط فإن الفارق بينهم حسب على مبروك يتمثل في نوع البيارق التي يمارسون تحتها الفرقاء عنفهم واستبدادهم".
فإذا ظلت الدولة العربية موصومة بالتسلطية، بكل ما يصاحبها من القمع والعنف، على تنوع الأيديولوجيات الحداثية (ليبرالية، قومية، علمانية، يسارية.. الخ) التي تبرقعت بها، فإن الأمر لم يختلف حين أصبحت أيديولوجيا الإسلام السياسي هي البرقع الذي التف على رأس الدولة في مصر في أعقاب ثورتها.
وهنا يلزم التنويه كما يؤكد الكاتب بأن ما ظهر من عجز الأيديولوجيات الحديثة المتبدلة على السطح في الواقع العربي عن إخراجه من أزمة جموده وتقليديته، إنما يرتبط بخضوعها لهيمنة نظام الثقافة الذي ينتجها كنماذج لا بد من فرضها من الأعلى على نحو اكراهي، وليس كمجرد تجارب مشروطة بسياقات تاريخية ومعرفية لا فعالية لها خارجها.