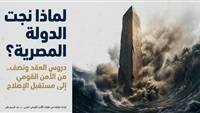بين الاجتهاد والتكفير: قراءة في الهجوم على الدكتور سعد الدين الهلالي
الجمعة 02/مايو/2025 - 12:47 ص
طباعة
من حين لآخر، تتفجر في الساحة الدينية المصرية جدالات حادة بين التيارات التقليدية والمحافظين من جهة، والتيارات المجددة والاجتهادية من جهة أخرى. أحدث هذه الجدالات كان الهجوم الحاد الذي تعرض له الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على خلفية تصريح له يرى فيه أن "الشعب إذا تصالح سلميًا على تعديل قوانين الميراث بما يخالف قاعدة 'للذكر مثل حظ الأنثيين'، فلا حرج في ذلك شرعًا". وقد أُثيرت ضجة واسعة حول هذا الرأي، بلغت حدّ وصفه بـ"الخروج عن الملة" والدعوة إلى مساءلته تأديبيًا وفصله من جامعة الأزهر.
بين الفقه والتأويل
تصريحات الدكتور الهلالي تأتي ضمن مشروع فكري وفقهي ممتد، يحاول من خلاله إعادة قراءة النصوص الدينية وفق الواقع الاجتماعي المعاصر، معتمدًا على أدوات أصولية معتبرة كالاجتهاد، ورفع الحرج، واعتبار المصلحة، وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. ورغم أن آيات الميراث وردت بصيغة قطعية في الثبوت والدلالة، إلا أن الهلالي يفتح بابًا للنقاش حول كيفية تنزيل هذه الأحكام في سياق دولة مدنية، يستند نظامها القانوني إلى التوافق المجتمعي أكثر من الاستنباط النصي المباشر.
ما يطرحه الهلالي لا يتعدى ـ بحسب فهمه ـ حدود التأويل المقاصدي، الذي يأخذ من "العدل" أساسًا للتشريع، ويرى أن العدل في زمان ما قد يوجب المساواة، لا التفاوت. إلا أن الطرف المقابل ـ في هذا السياق ـ لم يدخل معه في حوار علمي، بل واجهه بتهم جاهزة من العيار الثقيل: "خروج عن الإسلام"، و"انكار للقطعيات"، و"تبنٍ لأجندة خارجية".
من الفتوى إلى الاتهام
الردود التي واجهت الهلالي لم تتوقف عند حدود النقاش الفقهي، بل تسربلت برداء التخوين والتكفير الضمني. ووصل الأمر ببعض الأصوات إلى المطالبة بعزله من منصبه، ومحاكمته تأديبيًا، بزعم مخالفته لـ"ثوابت الإسلام". هذا التصعيد لا يعكس مجرد اختلاف فقهي، بل يعكس أزمة عميقة في قبول التعددية داخل الخطاب الديني المصري، حتى داخل المؤسسة الأزهرية نفسها.
المفارقة أن كثيرًا من المواقف التي أُدين الهلالي بسببها، ليست نتاج فكره الخالص، بل لها جذور داخل التراث الفقهي نفسه. فقد نُسبت فكرة "حق السعاية" التي تحدث عنها الهلالي في أحد مقالاته إلى قاضٍ مغربي شهير هو "ابن عرضون"، في سياق فتاوى تتعلق بالنساء العاملات في بيت الزوجية. ومع ذلك، جرى التعامل مع الهلالي كما لو أنه أتى بدين جديد، لا رأي فقهي قابل للأخذ والرد.
الطلاق الشفهي نموذجًا
ولم يتوقف الجدل عند الميراث، بل امتد إلى قضية الطلاق الشفهي، التي قال الهلالي إنها لا تقع ما لم تُوثّق. وهي مسألة خلافية حتى بين المعاصرين، وقد ناقشتها قوانين الأحوال الشخصية في أكثر من بلد إسلامي. غير أن هذا الرأي أيضًا جرى تحميله ما لا يحتمل، ووصمه بـ"الشطط"، رغم أنه يهدف في جوهره إلى حماية المرأة من آثار الطلاق العشوائي، ورفع الظلم الواقع عليها باسم الدين.
إغلاق باب الاجتهاد: خطر على الدين لا حماية له
اللافت أن معظم هذه الردود تضع خطوطًا حمراء حول "الاجتهاد" نفسه، لا فقط حول فتاوى الهلالي. وكأنها تقول ضمنيًا: "ما وجدنا عليه آباءنا هو الحق الذي لا يجوز تجاوزه"، في تكرار غير واعٍ لخطاب الجاهلية الذي جاء الإسلام لنسفه. بينما الحقيقة أن الفقه لا يكون فقهًا إلا إذا كان اجتهاديًا، متفاعلًا مع الواقع، سائلًا للنص، لا مجرد ناقل له.
لقد صاغ الأزهر تاريخيًا مكانته من خلال قدرته على استيعاب التنوع والاختلاف، لا قمعه. وإذا ما تحوّل إلى أداة في يد التيارات الرافضة لأي تجديد، فإنه سيخسر دوره بوصفه منارة للاجتهاد الرشيد، ويصبح مجرد حارس لتراث لا يُمس.
ختامًا
الجدل الدائر حول الدكتور الهلالي ليس مجرد خلاف حول مسألة فقهية، بل هو صراع على مستقبل الدين نفسه: هل يبقى أسيرًا لفهم سلفي، لا يفرق بين القطعي والظني، ولا بين الفقه والشريعة، أم يتحرر في إطار قواعده نفسها، ليخاطب الإنسان المعاصر بلغته وهمومه؟
إن الاتهام بالكفر والخروج من الملة لم يكن يومًا حجة علمية، بل سلاحًا في يد العاجز عن الحوار. وإذا كنا نريد فعلاً تجديد الخطاب الديني، فيجب أن نبدأ من الدفاع عن حق الاجتهاد، لا التحريض ضد المجتهدين.