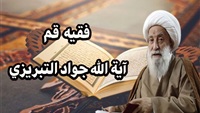بالفيديو.. مؤتمر العنف والإرهاب وقضايا المجاهدة بجامعة عين شمس
الأربعاء 11/مايو/2016 - 09:31 م
طباعة

أُقيم اليوم الأربعاء بجامعة عين شمس مؤتمر علمي بعنوان: العنف والإرهاب وقضايا المجاهدة (هوامش على مؤتمر بلجيكا 16-18 مارس 2016).
ووزعت ورقات المؤتمر البحثية على جلستين تناولتا بعض الأوراق التي قُدمت في مؤتمر بلجيكا الذي عقد في الفترة بين 16 و 18 مارس الماضي هذا بجانب أوراق بحثية قُدمت خصيصًا لهذا المؤتمر، ومن بين الأوراق المهمة التي قدمت في مؤتمر جامعة عين شمس ورقة بعنوان "غابة جهادية" خرائط تمدد أحزمة العنف والتطرف في الإقليم والعالم للباحث محمد عبدالقادر خليل وتناول فيها "بروز الفاعلين الجهاديين عبر اتجاهات مختلفة ومحاور متباينة على المستويين الإقليمي والدولي، يمثل السمة الغالبة على التطورات والأحداث والتفاعلات الأمنية والسياسية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تنامي حضور الجماعات الإرهابية "متعددة الجنسيات" ذات "الصبغة العالمية"، والتي تتسم من ناحية بكونها عابرة للحدود، ومن ناحية أخرى، بقدرتها على تشكيل خرائط معقدة لأحزمة جهادية تنطوي على دوائر متشابكة وحلقات تطرف محيطة بالدول وعبر حدود الأقاليم التي تقع بها، كما أنها تعتمد على توسيع نطاقات نفوذها المتدخلة وساحات سيطرتها الجغرافية دائمة التبدل على تكتيكات الحروب غير المتماثلة.
عمليات "داعش":

تنوعت الظواهر الإرهابية وتعددت أشكالها لتعكس تمدد نطاق العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها لتستهدف العديد من القوى الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق تباينت التقديرات بشأن عدد العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم "داعش"، خصوصا أنها لم تقتصر على الدول العربية فقط، بل امتدت إلى الدول الأوروبية. وتنوعت الأهداف التي أصابها التنظيم ما بين مساجد وفنادق في الدول العربية، ووسائل إعلامية وملاعب لكرة القدم في الدول الغربية، تأكد في بعضها مسئوليته عنها، بينما حرص التنظيم على المبادرة بإعلان تبنيه للبعض الآخر، في محاولة لإظهار قدرة الوصول إلى الأهداف البعيدة.
وقد ارتبط ذلك بمحرك تصاعد أعداد التنظيمات التي بايعت تنظيم داعش على المستويين الإقليمي والدولي، وقد أشارت تقديرات إلى أن عدد هذه التنظيمات بلغ نحو 37 جماعة وحركة متطرفة في زهاء 20 دولة مختلفة حول العالم. وقد كشف مرصد الأزهر في تقريره الصادر في ديسمبر 2015، أن 40% من الجماعات المسلحة حول العالم بايعت تنظيم "داعش"، مؤكدا أن "التنظيم الداعشي" منذ ظهوره في 2013، تطور بشكل كبير من حيث التمدد الجغرافي والديموغرافي وطبيعة النشاط العسكري والأماكن المستهدفة، وتحول من حركة محلية داخل العراق إلى إعلان ما يسمى بـ "الدولة" أو "الخلافة" العالمية.
الهشاشة الأمنية:

مثل أحد محركات تصاعد أدوار الجماعات الإرهابية استمرار عوامل الهشاشة الأمنية التي عانت منها دول إقليم الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الثورات، حيث تشكل أوضاع أمنية ساهمت في تحفيز قدرات الجماعات الجهادية التي تبنت استراتيجيات المواجهة للسيطرة على العديد من المناطق التي عانت من ضعف القبضة الأمنية، هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه قدرات الحركات الجهادية إما بفعل اختراقها من قبل أجهزة استخبارات دولية وإقليمية دعمتها، أو بسبب مخازن الأسلحة ومستودعات العتاد التي سيطرت عليها خصوصًا في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن، أو بسبب ضعف المواجهة الأمنية من قبل القوى الإقليمية والدولية التي بدت توجهاتها متعارضة ومصالحها متضاربة، وثمة صراع بالوكالة يكفي لتظل ساحات "غابة" التنظيمات الجهادية مرشحة للتوسع عبر الإقليم".
وقُدمت ورقة أخرى بعنوان: الغرب والإسلام "البحث عن عدو جديد" وقدمها الأستاذ الدكتور جمال شقرة / نائب رئيس مجلس إدارة المركز ومستشار الجامعة للشئون السياسية والاستراتيجية.
وتناولت هذه الدراسة فكرة ترشيح الإسلام كعدو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، باعتباره عدواً للغرب. وتطرح الدراسة المرتكزات الرئيسية لفكرة صراع الحضارات عند صموئيل هنتنجتون.
الإسلام العدو التاريخي اللدود للغرب:

بداية ينظر "هنتنجتون" إلى الإسلام باعتباره العدو التاريخي اللدودو للغرب، وعدَّه مصدر الخطر الكبير الذي يهدد الحضارة الغربية المعاصرة، ووفقاً لرؤيته، فإن أشد خطوط التقسيم الحضاري عنفاً هي تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه الأرثوذكس والهندوس والأفارقة والمسيحيين والغربيين. ولقد حشد الكثير من الأدلة محاولاً إثبات صحة مقولته هذه، وعدم صحة مقولة بعض المفكرين ورجال السياسة الغربيين الذين أشاروا إلى أنه لا توجد أية مشكلة بين الغرب والإسلام كدين، وإنما المشكلات قائمة فقط مع بعض المتطرفين الإسلاميين الإرهابيين، يقول "هنتنجتون": "إن أربعة عشر قرنًا من التاريخ تؤكد العكس، فالعلاقات بين الإسلام والمسيحية سواء الأرثوذكسية أم الغربية كانت عاصفة، كلاهما كان، الآخر بالنسة للآخر. وعندما قارن بين الصراع الذي دار في القرن العشرين بين الديمقراطية الليبرالية والماركسية اللينينية، وبين الصراع المسيحي - الإسلامي، كان تقديره أن الصراع الأول لم يكن سوى ظاهرة سطحية وزائلة، أما الصراع بين المسيحية والإسلام فهو صراع مستمر وعميق.
وبأسلوبه الانتقائي وعقليته المنحازه، تتبع العلاقات "العاصفة" بين الإسلام والغرب، ولم يبرز بالطبع سوى الوقائع التاريخية التي تثبت "دموية" الحضارة الإسلامية وتهديدها للغرب فهي الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك، وقد فعل الإسلام ذلك مرتين على الأقل، الأولى: في القرنين السابع والثامن الميلاديين، والثانية: في القرن الخامس عشر.
ولقد حاول "هنتنجتون" الكشف عن أسباب الصراع بين الإسلام والغرب، والعوامل التي أثرت فيه، فأشار إلى أن أسباب الصراع بين الإسلام والغرب تكمن في طبيعة الديانتين والحضارتين المؤسستين عليهما، فالصراع كان من ناحية نتيجة للاختلاف بينهما، خاصةً مفهوم المسلمين للإسلام كأسلوب حياة متجاوز يربط بين الدين والسياسة جاء ضد المفهوم المسيحي الغربي الذي يفصل بين مملكة الرب ومملكة القيصر. ومن ناحية أخرى كان الصراع نابعاً من أوجه التشابه بينهما، فكلاهما دين توحيدي، ويختلف عن الديانات الأخرى التي تقول بتعدد الآلهة، وكلاهما ينظر إلى العالم نظرة ثنائية "نحن" و"هم" وكلاهما يرى أنه العقيدة الصحيحة الوحيدة التي يجب أن يتبعها الجميع، وكلاهما دين تبشيري يعتقد أن متبعيه عليهم التزاماً بهداية غير المؤمنين، وتحويلهم إلى ذلك الإيمان الصحيح.
وجاءت الورقة البحثية للدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج وطرق تدريس علم الاجتماع جامعة عين شمس بعنوان "دور المؤسسات التربوية في تعزيز الأمن الفكري ومواجهة الفكر المتطرف والتكفيري
وتناولت فيها كيف أن مشكلة الإرهاب مشكلة يجب أن تضافر فيها جهود المؤسسات التربوية والتنشئة الاجتماعية على التوازي في تحصين الشباب من الفكر المتطرف والتكفيري من خلال قيام كل مؤسسة بعملها المنوط بها من:
- المدرسة من خلال محتوى المناهج جميعها وإدماج مفاهيم الأمن الفكري فيها ونشر قيم الوسطية تحديث وطرق التدريس التي من خلالها نوطد لثقافة الحوار والتفكير الناقد وفرز الأفكار وكافة الأنشطة الصيفية، وكذلك العودة مرة أخرى للأنشطة المدرسية ثقافية وفنية ورياضية وعلمية لتوظيف طاقات الشباب والأطفال، فيما تُستغل هذه الطاقة في النفع وتوطيد السلم الاجتماعي والتسامح، تدريب المعلمين وتوعيتهم وتحصينهم فكريا.
- الجامعة من خلال المقرر التثقيفي والندوات والأنشطة الجامعية.
- مراكز البحوث التابعة للجامعات مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس نموذجا وما يقدمه من توعية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة بل الجامعات المصرية كلها.
- الإعلام الذي يجب أن يلتزم بأيدلوجية الدولة ويكون داعمًا للسلام الاجتماعي ولا يساهم في نشر الأفكار الهدامة والفوضى، بالإضافة إلى دور الأحزاب وتوعية الشباب سياسيا ودينيا وثقافيا.
- دور المؤسسة الدينية المتمثل في الأزهر الشريف وكذلك وزارة الشباب والنوادي الاجتماعية.
- وعدم الدفع فقط بالمؤسسة الأمنية في المقدمة بل أن دورها يأتي لمواجهة من انخرط فعليًا في سلوك عنيف وعمليات إرهابية وكذا تتضافر جميع المؤسسات في عملية تعزيز الأمن الفكري للنشء والشباب بل للأفراد جميعا حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في براثن الفكر المنحرف.
وقرأ الدكتور نشأت الديهي ورقة بعنوان "الأفكار الجهادية المنحرفة بين التناول الإعلامي والتوجيه الاستخباراتي، جاء فيها "ما كان يدور في الخفاء ويبدأ وينتهي دون أن يطلع عليه إلا القليلون، أصبح الآن يتم في العلن وعلى الهواء مباشرة، كنا فيما مضى نسمع – فقط – عن قيام الأجهزة الاستخباراتية لدولة ما بتشكيل خلية ما في دولة ما لتحقيق هدف ما، لكن الآن بات الأمر مختلفًا وإلى حد كبير، فأجهزة الاستخبارات أصبحت تعمل بشكل شبه علني وأصبح مسئولو الأجهزة الاستخباراتية يجلسون جنبا إلى جنب بجوار الساسة ومتخذ القرار وأمام الجماهير وتنقل وسائل الإعلام أخبارهم كما السياسيين والشخصيات العامة، وفي الآونة الأخيرة تعددت الأنشطة الاستخباراتية ومن ثم تنوعت الأدوات المستخدمة لتصل إلى ما يسمى (صناعة التوجه الأيدولوجي وإدارته).
ويعد النموذج المثالي لصناعة توجها مؤدلجا وإدارته استخباراتياً هو تنظيم الإخوان المسلمين الذي أنشأته المخابرات البريطانية ثم تنظيم القاعدة الذي أنشأته المخابرات الأمريكية وبعدها حزمة التنظيمات الجهادية التي انبثقت جميعها من قاعدة (الأكار الجهادية المنحرفة)، وصولاً إلى تنظيم داعش وأخواتها.
القاسم المشترك بين هذه التنظيمات أنها صنيعة أجهزة المخابرات الغربية عدا القليل منها تم صناعته إقليميماً لخدمة المخابرات الغربية كذلك.
لكن اللافت للنظر هو ذلك الدور الإعلامي المتعاظم خلال العقود الأخيرة، فالإعلام بات أداه هامة وخطيرة في يد الأجهزة الاستخباراتية التي تصنعها وتديرها على غرار التنظيمات الجهادية.
والسؤال الذي يحتاج إلى إجابات علمية من يصنع الآخر؟

التنظيمات الجهادية تصنع إعلامها؟ أم أن الإعلام الموجه استخباراتيا هو من يصنع هذه التنظيمات من العدم؟
ما هي النماذج الحالية التي توضح الاستهداف المخابراتي في دول بعينها ضد دول أخرى بعينها من خلال صناعة دوائر جهادية منحرفة أو من خلال صناعة دوائر إعلامية موجهة عن بعد؟
وتدقيقا للمصطلح والمفاهيم جاءت ورقة الدكتورة إنجي محمد جنيدي، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر جامعة عين شمس وعنوانها "الأصولية والإرهاب" وجاء فيها "الأصولية هي الارتكاز على اصول القيم والمبادئ التي دعت إليها كافة الاديان، تلك الأصولية لا تنحرف عن التفكير المستقيم الذي يجعل العلماني والمسلم والمسيحي واليهودي والملحد أسوياء أمام القانون.
والمعروف أن السماحة هي لغة الأديان. فلا يوجد دين يدعو إلى العنف، إلا أن التحجر الفكري هو العدو الرئيسي للبشرية وهو الداعي الرئيسي لاستخدام العنف، خاصة بانسحابه إلى الأديان، وهذا التحجر هو ما أنتج الأصولية بمعناها الحالي، التي تتدعي امتلاكها للحقيقة المطلقة. والاصولية ليست قاصرة على دين معين وأنما شملت كل الأديان.
ورغم أننا في عصر الانفتاح، إلا أن الأصولية حفرت لنفسها موطأ قدم له جذور عميقة وراسخة في المجتمعات؛ ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية، تضافرت معا وأنتجت الفكر الإرهابي. فالإرهاب هو أعلى مراحل الأصولية، وقد أصبح الإرهاب مرض العصر، الذي هدد ويهدد كل المجتمعات على حد سواء.
أن أزمة الإرهابي الأصولي ليست في امتلاكه لفكرة مطلقة فحسب، بل تكمن في أنه يريد فرض مسلماته على الآخرين، حيث أنه لا يطيق أن يحيا في عالم مختلفة ولا يتحمل أن يوجد في هذا العالم حقائق أخرى غير حقيقته، فهو يصف نفسه بالاصطفاء والنقاء والطهر وهو في مكانة تؤهله للاستعلاء على الآخرين، لذلك من السهل جدا أن يدمر نفسه ويدمر الآخرين معتقدا أنه بذلك قد حقق خلاصه النهائي.
من أجل ذلك يلهث الجميع للتوصل إلى حل جذري يقضي على الإرهاب. فهل من سبيل إلى ذلك؟