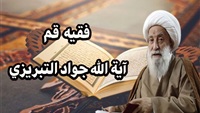سرديات الفشل المصنعة: كيف يخدم إعلام الخارج أجندات مشبوهة؟
الإثنين 04/أغسطس/2025 - 12:40 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
في لحظة سياسية واجتماعية معقدة، تتسابق التيارات الراديكالية والإعلام الموجه لتقديم قراءاتها الخاصة عن الواقع المصري. وفي هذا السياق، كتب محمد إلهامي -المصنف كقيادي في حركة "حسم" الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين- منشورًا يتبنى فيه سردية تهدف إلى صناعة الفوضى، وزعزعة الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وخلق انطباع زائف بقرب الانهيار. هذا المقال يهدف إلى تحليل هذا الخطاب، وتفكيك بنيته اللغوية والأيديولوجية، والكشف عن الرسائل الخفية التي يسعى لإيصالها، ومصالح الجهة التي تقف خلفه.
بنية الخطاب وخطاطة السقوط الداخلي
يعتمد محمد إلهامي في نصّه على ما يُعرف في تحليل الخطاب بـ"خطاطة السقوط الداخلي"، وهي بنية خطابية نمطية تُستخدم بكثافة في أدبيات الجماعات الراديكالية، خاصة في مراحل ما قبل التحريض المباشر أو التمهيد لتمرد أو عنف منظم. تقوم هذه الخطاطة على تقديم الدولة أو النظام السياسي المستهدف بوصفه كيانًا مهزوزًا، يترنح تحت وقع الأزمات الداخلية، تمهيدًا لغرس فكرة أن لحظة الانهيار وشيكة ولا مفر منها. وهي صيغة خطابية ذات طبيعة إسقاطية أكثر من كونها تحليلًا عقلانيًا.
يبدأ الخطاب بتوصيفات سوداوية متعاقبة للنظام المصري: "مأزوم، مرتبك، مضطرب". هذه الكلمات، على بساطتها، تُستخدم لتوليد شعور عام بأن الدولة تعيش حالة انهيار مستمر، دون الحاجة إلى تقديم مؤشرات واقعية أو بيانات تُثبت ذلك. هذه الطريقة تتسم بالتكرار والانفعال أكثر من التحليل، وهي تقنية معروفة في التأثير الخطابي تهدف إلى تكييف المتلقي نفسيًا لقبول فكرة الانهيار كأمر واقع.
في مواضع لاحقة، يُدخل إلهامي عبارات مثل "تسريبات"، "انفلات"، "تعذيب"، "مهاجمة مكتب أمن الدولة"، دون تقديم أي وثائق أو مصادر محايدة. وهذا النمط من السرد التصعيدي يُستخدم لصناعة حالة من الذعر الذهني والانطباع بوجود فوضى شاملة، بينما هي في الواقع إما حوادث فردية، أو أخبار منقولة عن مصادر معادية للدولة المصرية، تُعاد تدويرها في خطاب جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية كأدوات لبث التوتر.
ينتهي الخطاب بعبارات من قبيل: "ولاّت حين مناص!"، وهي جمل تحمل دلالة نبوئية تكرس الإحساس بأن النظام انتهى أو على وشك الانهيار. هذه الصيغة الخطابية تُستخدم عادة لتسويغ العنف وتبرير الانقلاب على مؤسسات الدولة، باعتبارها – في زعمهم – قد فقدت شرعيتها ولم تعد قادرة على البقاء. الأهم من ذلك أن الخطاب يخلو تمامًا من أي مرجعية معلوماتية أو منهج نقدي، بل يعتمد على الاستثارة والانفعال، مما يُضعف مصداقيته ويفضح طبيعته التعبوية والدعائية.
الخلفية الأيديولوجية لصاحب الخطاب
لا يمكن التعامل مع محمد إلهامي بوصفه مجرد محلل سياسي أو مفكر مستقل؛ بل يجب وضعه في سياقه الحقيقي كأحد المنظرين البارزين في التيار التكفيري الدعوي، الذي يمثل حلقة وصل بين الفكر الحركي للجماعات الإسلامية المتشددة وخطابها الدعائي. خطابه لا ينطلق من موقف أكاديمي أو معرفي محايد، بل ينبني على خلفية أيديولوجية واضحة تتبنى رؤية صراعية ضد الدولة الحديثة، وتُكفّر خصومها السياسيين.
من أبرز السمات التي تميز خطاب إلهامي هي اعتماده المستمر على ما يُعرف بـ"استراتيجية المظلومية"، حيث يستخدم حوادث القمع أو التضييق – سواء كانت حقيقية أو مبالغًا فيها – لتبرير اللجوء إلى العنف المسلح، باعتباره ضرورة شرعية وأخلاقية. هذا النمط في التفكير هو ذاته الذي اعتمدته الجماعات الجهادية في تجنيد الأتباع وتبرير العمليات الانتحارية والهجمات ضد مؤسسات الدولة.
لا تقتصر خطابات إلهامي على التنظير العام، بل تتضمن إشارات صريحة ومتكررة لدعم أعمال إرهابية وقعت بالفعل، مثل محاولات اغتيال مسؤولين أمنيين، وتفجير منشآت حيوية، وعلى رأسها دعمه غير المباشر لمحاولة اغتيال النائب العام المساعد عام 2016. هذا الدعم – ولو بلغة رمزية أو تأويلية – يكشف انخراطه الفعلي في المعركة الفكرية التي تخوضها الجماعات المتطرفة، باعتباره جزءًا من آلة التبرير لا المراقبة أو التحليل.
من هنا، فإن أي قراءة لخطاب محمد إلهامي يجب أن تنزع عنه عباءة الحياد أو التحليل النزيه. هو ليس شاهدًا يصف المشهد، بل لاعب ضمنه، يستخدم أدوات اللغة والرمز والتاريخ في خدمة أجندة أيديولوجية تهدف إلى إعادة إحياء مشروع سقط شعبيًا، بعد أن افتُضح وجهه الحقيقي في العنف والفوضى والتكفير. إن خطابه لا يمثل قراءة للأحداث، بل محاولة لتوجيهها نحو انفجار جديد.
استراتيجية صناعة "قصة بديلة" عن الدولة
يُوظف محمد إلهامي في خطابه ما يُعرف استراتيجيًا بـ"السردية البديلة" أو "القصة الموازية"، وهي تقنية دعائية تقوم على تقديم رواية مشوهة للواقع، يتم فيها تصوير الدولة المصرية ككيان منهار أو على شفا الانفجار الداخلي. يسعى من خلال هذه التقنية إلى تجريد مؤسسات الدولة من الشرعية والفاعلية أمام الجمهور، عبر مبالغات مقصودة في توصيف الأزمات وتجاهل متعمد للمؤشرات الإيجابية، وهو ما يُعد من سمات الدعاية التحريضية.
يتعمّد الخطاب تجاهل السياقات العالمية التي أثرت على اقتصادات كبرى، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم العالمي، وتداعيات جائحة كورونا، ويختزل كل المشكلات الاقتصادية في الدولة المصرية فقط، ليخلق انطباعًا مضللًا بأنها تعاني وحدها دون غيرها، في تجاهل للواقع الإقليمي والدولي. بذلك، يتحول النقد من كونه تحليليًا موضوعيًا إلى كونه سلاحًا في معركة نفسية.
وتُبرز هذه السردية البديلة نفسها بشكل أكثر كثافة عندما تترافق مع حملات إعلامية من قنوات وجماعات إخوانية في الخارج، تكرر العبارات ذاتها تقريبًا، في ما يشبه "غرفة صدى" موحدة. يتكرر توصيف "الدولة المنهارة" أو "النظام المرتبك" بنفس الألفاظ، ما يؤكد أن الأمر ليس تحليلًا متنوع المصادر، بل خطة متعمدة لتشويه الصورة الذهنية لدى المواطنين.
تتمثل خطورة هذه الاستراتيجية في قدرتها على زعزعة الثقة العامة، لا من خلال عرض أدلة دامغة، بل من خلال التكرار المنظم والموجه لمفردات معينة تصنع مناخًا من الشك واللايقين. وهو أسلوب يتقاطع مع تقنيات "الحرب النفسية" التي تعتمد على الإرباك وتفكيك الرابط بين المواطن ومؤسسات بلده، تمهيدًا لخلق حالة فراغ نفسي تُستثمر لاحقًا في التحريض أو الاستقطاب السياسي أو حتى التجنيد.
توظيف العاطفة لا العقل
يعتمد محمد إلهامي في خطابه على تعبيرات مشحونة بالعاطفة، مثل "بغض عميق" و"تعذيب أسبوعي" و"انفلات"، دون تقديم بيانات موثقة أو مصادر تدعم هذه الادعاءات. هذا النوع من التعبير يُقحم القارئ أو المستمع في حالة وجدانية مشبعة بالغضب أو الحزن أو الكراهية، بعيدًا عن التحليل العقلاني أو النقاش الموضوعي.
لا يشير إلهامي إلى أي تقارير رسمية، أو دراسات مستقلة، أو حتى شهادات ميدانية تُعزز روايته، بل يكتفي بإلقاء أحكام نهائية على الوضع في مصر. هذا التجاهل المتعمد للواقع يساهم في بناء صورة ذهنية مزيفة، تتغذى فقط على الاستثارة العاطفية، وتفتقر إلى أدنى درجات المصداقية أو التحقق.
الخطاب يُصاغ بقصد خلق ردة فعل لا وعيّة لدى الجمهور، عبر اللعب على مشاعر الخوف أو الظلم أو الغضب. هذا يتفق تمامًا مع ما يُعرف في علم تحليل الخطاب بـ emotive language manipulation، وهي تقنية تُستخدم بكثرة في خطاب الجماعات الشعبوية والمتطرفة، لتجنيد المؤيدين لا عبر الإقناع، بل بالتحريض الانفعالي.
عبر هذا النمط العاطفي، لا يهدف إلهامي إلى إقناع المتلقي، بل إلى دفعه نحو اتخاذ مواقف سريعة وغير مدروسة، تُترجم غالبًا إلى مواقف سلبية من الدولة أو المجتمع. وهذا الأسلوب، في مضمونه، يعكس استخفافًا بعقل الجمهور، ويُحول الخطاب إلى أداة تهييج لا تختلف عن الدعاية السياسية في أحلك صورها.
خامسًا: التوظيف الدعائي للحوادث الفردية
يعتمد الخطاب الدعائي لمحمد إلهامي على ما يُعرف في علم الاتصال والتأثير الإعلامي بـ"التمثيل التضخيمي للحوادث الفردية"، أي تحويل حوادث معزولة إلى رموز عامة يُبنى عليها تعميم شامل ضد الدولة. إذ لا يُطرح الحدث كمعلومة بحاجة للتحقيق، بل كدليل نهائي على ما يصفه بـ"طبيعة النظام القاتلة"، متجاوزًا بذلك كل معايير التقييم الموضوعي والمنهجي.
فمثلًا، تُستغل حوادث وفاة بعض المحتجزين – سواء كانت بسبب الإهمال الطبي أو أي سبب آخر – ليُعاد تقديم الدولة المصرية وكأنها تنتهج "سياسة قتل ممنهجة"، رغم أن هذه الوقائع، حتى إن ثبتت، لا يمكن فصلها عن السياق العام لأي دولة تعاني من اختناقات إدارية أو أزمات في منظومة العدالة. لكن إلهامي لا يهتم بالسياق، بل يوظف الواقعة كأداة تأليب وتحريض.
الأخطر أن هذا النوع من الخطاب لا يقدم أي إحصاءات مقارنة، فلا يُقارن مثلًا بمعدلات الوفيات في مراكز الاحتجاز بدول أخرى، ولا يعترف بتحسن مؤسساتي أو وجود آليات رقابة برلمانية وقضائية داخل مصر. بل يُقدّم حادثة مفردة كمقياس نهائي لحكمٍ كلّي، وهو ما يُعد إخلالًا معرفيًا ومنهجيًا متعمدًا.
هذا التوظيف الانتقائي للحوادث يهدف بالأساس إلى خدمة أجندة سياسية، لا إنسانية. فهو لا يسعى إلى تحسين أوضاع المحتجزين ولا إلى كشف أوجه القصور لتحسينها، وإنما يسعى إلى تثبيت صورة قاتمة تُستخدم لاحقًا في الدعاية الدولية ضد مصر، وتُوظف في خطاب الجماعات التي تتخذ من "الدم والدموع" وقودًا لاستعادة مشروعها المأزوم.
غياب المشروع البديل وازدواجية المعايير
يتضح من مضمون خطاب إلهامي أن النقد الموجه للدولة لا يرافقه أي طرح بديل أو مشروع إصلاحي متكامل. فهو يكتفي بتوصيف الأزمات، دون تقديم حلول عملية أو حتى إشارات لمبادرات سياسية ممكنة. هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تُميز كثيرًا من خطابات المنتمين إلى جماعة الإخوان، حيث يسود نمط "الاعتراض لأجل الاعتراض" دون الدخول في تعقيدات الواقع أو المساهمة الجادة في تطويره.
ما يُثير القلق في هذا النوع من الخطاب هو التلويح الدائم بـ"السقوط الوشيك" و"الانفجار الكبير"، وكأن المتحدث يتمنى انهيار الدولة بدلًا من إصلاحها. وهو توجه ينقل الخطاب من خانة النقد إلى خانة التحريض، ويغيب عنه تمامًا أي أفق للبناء المشترك أو التعايش الوطني. لا توجد إشارات إلى الحوار، أو الإصلاح التدريجي، أو دعم مسارات الدولة الدستورية.
من اللافت أن إلهامي، كغيره من رموز التيار الإخواني، يتجنب تمامًا الإشارة إلى ممارسات الجماعة العنيفة في الماضي القريب. فلا نجد أي اعتذار عن التفجيرات التي استهدفت الكنائس، أو محاولات الاغتيال السياسي، أو عمليات استهداف رجال الأمن. هذا الغياب لا يمكن تفسيره إلا باعتباره إنكارًا متعمدًا أو تهرّبًا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن فترة سوداء في تاريخ الجماعة.
المفارقة الأشد وضوحًا تكمن في استخدام الخطاب الأخلاقي كأداة سياسية ظرفية، وليس كمبدأ دائم. فحين يُدين الكاتب ما يعتبره "قمعًا" في الدولة، يتجاهل تمامًا ممارسات أشد قسوة تورط فيها التنظيم الذي ينتمي إليه. هذه الازدواجية في المعايير تنزع عن خطابه المصداقية، وتُحيله إلى نوع من الدعاية المغلّفة بثوب أخلاقي، بينما هو في الحقيقة لا يعكس التزامًا حقيقيًا بقيم الحرية أو حقوق الإنسان.
خاتمة
ما يكتبه محمد إلهامي ليس قراءة تحليلية أو تعبيرًا عن رأي، بل هو جزء من مخطط تعبوي يعيد إنتاج سردية جماعة لفظها الشارع المصري منذ أكثر من عقد. ومثل هذه الخطابات لا تهدف إلى الإصلاح، بل تسعى إلى تقويض الدولة، وتبرير العنف، وتهيئة الذهن الشعبي للفوضى تحت غطاء المظلومية.
إن تفكيك هذا الخطاب واجب وطني، لأنه يُمثل محاولة لإعادة بث السم في وعي الأمة، وتشويه الواقع لخدمة مشاريع العنف والتقسيم.