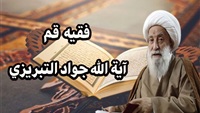المستشار الإعلامي للجولاني والإخوان في سوريا: نقد ذاتي أم تصفية حساب سياسي؟
الأحد 24/أغسطس/2025 - 05:07 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
نشر أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع، مقالًا مثيرًا للجدل بعنوان: "متى ستحل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا نفسها؟"، دعا فيه الجماعة إلى إعلان نهايتها التنظيمية، مستندًا إلى حجج تاريخية وسياسية، وإلى مقارنات مع تجارب عربية وإسلامية أخرى في العراق والمغرب وتركيا. ورغم ما يبدو في مقاله من نبرة إصلاحية ونقد ذاتي، إلا أن القراءة المتأنية تكشف عن جملة من التناقضات والانتقائية، فضلًا عن أبعاد سياسية أبعد من مجرد "نصيحة فكرية" لجماعة الإخوان.
فالمقال يبدأ من تجربة الكاتب الشخصية مع الجماعة ليمجّد ماضيه النضالي في صفوفها، قبل أن ينقلب عليها مطالبًا بحلها، وهو ما يعكس تناقضًا صارخًا بين الاعتزاز بالانتماء القديم والرغبة في إلغائه اليوم. ثم ينتقل إلى تصوير المشهد السوري الراهن وكأن كل الفصائل والأجسام السياسية قد ذابت في إطار "الدولة الوليدة"، متجاهلًا الانقسامات القائمة، والمشاريع المتوازية التي تتصارع على الأرض.
كما أن تركيزه على الإخوان وحدهم بوصفهم "العقدة المركزية" يختزل تعقيدات المشهد السوري، متغاضيًا عن النزاعات الطائفية والإثنية، وعن التدخلات الإقليمية والدولية التي تشكل ملامح الأزمة السورية اليوم. وإلى جانب ذلك، فإن مقارناته بتجارب تركيا أو المغرب أو العراق تبدو مبتورة عن سياقاتها التاريخية والسياسية، وتهدف أكثر إلى شرعنة دعوته الحالية من أن تقدّم دروسًا موضوعية قابلة للتطبيق في سوريا.
وسنحاول في هذا المقال تقديم قراءة نقدية معمقة لمقال زيدان عبر ستة محاور أساسية: أولها التناقض بين الماضي والحاضر في خطابه، وثانيها التعميم وتزييف الواقع السوري، وثالثها تجاهل الانقسامات الطائفية والإثنية، ورابعها الانتقائية في قراءة التجارب المقارنة، وخامسها الدلالات السياسية الكامنة خلف المقال، وسادسها التناقض في مفهوم "الدولة الوليدة" التي يدعو الجميع إلى الانضواء تحتها. وقبل الخوض في هذه المحاور، سنتوقف عند خطورة دور الإخوان المسلمين أنفسهم في عسكرة الثورة السورية وتشابكاتهم مع الفصائل المسلحة، وهو البعد الذي لا يمكن القفز فوقه عند مناقشة أي دعوة لحل التنظيم.
جماعة الإخوان والثورة السورية
وإذا كان أحمد موفق زيدان قد طرح في مقاله مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بوصفها "العقدة المركزية" أمام استقرار الدولة الوليدة، فإن تناول هذه الفكرة لا يمكن أن يتجاهل إشكالية الجماعة نفسها ودورها خلال الثورة. فمنذ اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، لم تتعامل جماعة الإخوان باعتبارها جزءًا من حراك شعبي وطني جامع، بل كقوة تسعى إلى استثمار الثورة لخدمة مشروعها الأيديولوجي. سعت إلى السيطرة على خطاب المعارضة وتوجيهه، ليس فقط بهدف إسقاط النظام، وإنما بهدف إعادة إنتاج تجربة الإسلام السياسي ضمن صيغة سلطة موازية تحفظ لها النفوذ في مستقبل سوريا. وهنا بدأ الانقسام بين تيارات تنادي بدولة مدنية ديمقراطية وتيارات أخرى أرادت توظيف الدين في إدارة الصراع.
أخطر ما قامت به الجماعة كان دفع الثورة من السلمية إلى العسكرة. تحت شعار "حماية الثورة"، شُجّع الشباب على الانخراط في تشكيلات مسلحة، الأمر الذي سرعان ما حوّل الحراك من احتجاج جماهيري واسع إلى ساحة حرب مفتوحة، ما أفقده الكثير من التعاطف الإقليمي والدولي. بهذا، وفّرت الجماعة الأرضية لظهور فصائل متشددة، بل وأسهمت في تبرير اللجوء إلى السلاح، وهو ما فتح الباب أمام جماعات عقائدية أكثر تطرفًا لاستقطاب المقاتلين تحت شعارات دينية عابرة للحدود.
إلى جانب ذلك، لم يكن الإخوان مجرد قوة سياسية أو فكرية، بل تورطوا في شبكة تحالفات متشابكة مع فصائل مسلحة مختلفة، بعضها يُقدَّم كـ"إسلام معتدل"، وبعضها الآخر قريب من جماعات جهادية كجبهة النصرة. هذا التداخل جعل من الصعب رسم خط فاصل بين الفصائل ذات الطابع الثوري والفصائل ذات المرجعية العقائدية، وأسهم في تشويه صورة الثورة نفسها على المستوى الدولي. فالعالم بدأ ينظر إلى المشهد السوري باعتباره ساحة صراع أيديولوجي أكثر من كونه انتفاضة شعبية ضد الاستبداد.
ثم جاءت المظلة الإقليمية لتضاعف هذا التشابك، إذ استفادت الجماعة من دعم بعض القوى الإقليمية التي رأت فيها ورقة ضغط على النظام السوري وحلفائه. والنتيجة أن مساحات واسعة من سوريا تحولت إلى مناطق نفوذ متداخل، تتحكم فيها الفصائل المسلحة المدعومة بغطاء سياسي إخواني. هذا كله لم يُضعف المعارضة أمام النظام فحسب، بل قدّم للنظام نفسه ذريعة ذهبية لتسويق خطابه بأن ما يجري "مشروع إخواني إرهابي". وهكذا، لعبت الجماعة دورًا مزدوجًا: من جهة أسهمت في عسكرة الثورة وتشظيها، ومن جهة أخرى قدمت للنظام السردية التي احتاجها لتبرير جرائمه أمام الداخل والخارج.
التناقض بين الماضي والحاضر
يبدأ أحمد موفق زيدان مقاله باستدعاء ذكرياته داخل جماعة الإخوان المسلمين، مُمجداً تجربته معهم، وواصفاً نفسه بـ"المناضل والمكافح والمهاجر ضد نظام الأسد". هذا التقديم لا يترك مجالاً للشك في أن الرجل قد بنى جزءاً كبيراً من وعيه السياسي وهويته الفكرية من خلال الجماعة، وأن تجربته معها ليست عابرة بل شكلت أساساً لمسيرته.
غير أن المفارقة سرعان ما تتبدى حين يطالب في نفس المقال الجماعة نفسها بحل تنظيمها وطي صفحتها. فكيف يمكن الجمع بين الاعتزاز بتجربةٍ يعتبرها الكاتب شرفاً ووساماً على صدره، وبين المطالبة اليوم بإنهاء الكيان الذي كان وعاءً لهذه التجربة؟ هذه المفارقة لا تقتصر على المستوى الشخصي، بل تكشف عن إشكالية عميقة في طريقة التعامل مع التاريخ السياسي السوري.
إذ يبدو أن زيدان يحاول إعادة كتابة سيرته الذاتية بما يتناسب مع موقعه الجديد كمستشار للرئيس، عبر تقديم الإخوان بوصفهم مرحلة انتهت صلاحيتها، بينما يظل هو "الناجي" الوحيد الذي خرج منها مبرَّأً من العيوب. هذه الرغبة في تبرئة الذات من الماضي من خلال إلقاء المسؤولية على الآخرين تكشف عن ميل واضح إلى تحميل الجماعة وزر كل ما فات، وكأنها مجرد شماعة لتصفية الحساب مع التاريخ.
وبهذا المعنى، فإن تناقض الكاتب ليس مجرد تناقض فكري، بل هو محاولة لتشييد سردية جديدة تمنحه شرعية سياسية على حساب رفاق الأمس. فبدلاً من الاعتراف باستمرار الحاجة إلى مراجعة جماعية شاملة لكل القوى، نجده يركز على حل الإخوان وحدهم، وهو ما يجعل دعوته أقرب إلى إقصاء سياسي منه إلى نقد موضوعي أو إصلاح وطني جامع.
التعميم وتزييف الواقع السوري
يدّعي أحمد موفق زيدان أن جميع الأجسام السورية ــ من فصائل ومعارضة ومجالس وهيئات ــ قد سارعت إلى حل نفسها ووضع إمكاناتها تحت تصرف "الدولة الجديدة". هذه الصياغة التي يقدمها الكاتب توحي للقارئ بأن سوريا دخلت مرحلة وحدة وطنية غير مسبوقة، وأن جميع القوى السياسية والعسكرية والمدنية قد ذابت في بوتقة واحدة. غير أن هذا التصوير أقرب إلى الرغبة السياسية منه إلى الواقع الملموس على الأرض.
فالانقسامات داخل صفوف المعارضة ما زالت حاضرة بقوة. شمال سوريا يشهد تجاذبات بين فصائل ذات توجهات متباينة، بعضها إسلامي وبعضها قومي، بينما الجنوب يعيش صراعاً مختلفاً تحكمه اعتبارات مناطقية وعشائرية. وفي كلتا الحالتين، لم تُحلّ الفصائل نفسها كما يوحي زيدان، بل ما تزال قائمة بكياناتها وتناقضاتها، الأمر الذي ينفي مقولة "الذوبان الكامل" في الدولة الوليدة.
أما على مستوى القوى الكردية، فإن المشهد أكثر تعقيداً. فالمشروع الكردي في شمال وشرق سوريا يسير في اتجاه مغاير تماماً لما يطرحه خطاب "الوحدة تحت راية الدولة"، إذ أن لهذه القوى مشروعاً سياسياً وإدارياً قائماً على الحكم الذاتي والفيدرالية، وهي لم تُبدِ أي استعداد للتنازل عنه بسهولة. وبالتالي فإن الإيحاء باندماج هذه القوى في الدولة المركزية الجديدة، كما يصوره زيدان، هو تجاهل متعمد لطبيعة الصراع الإثني والسياسي القائم.
حتى الفصائل العسكرية التي يفترض أنها الأقرب للذوبان في أي كيان موحد، ما تزال تعاني انقسامات داخلية مرتبطة بالولاءات المناطقية والأيديولوجية، وتتنافس فيما بينها على النفوذ والموارد. وعليه، فإن خطاب "الإجماع الوطني" الذي يقدمه زيدان ليس سوى صياغة دعائية تهدف إلى إظهار الدولة الجديدة بمظهر المنتصر الجامع، بينما الحقيقة أن الواقع السوري ما زال مفككاً ومليئاً بالتصدعات التي لا يمكن إنكارها.
تجاهل الانقسام الطائفي والإثني
يقدم أحمد موفق زيدان في مقاله جماعة الإخوان المسلمين على أنها العقبة المركزية أمام استقرار سوريا، وكأن البلاد لا تعاني سوى من وجود هذا التنظيم. هذا التركيز المفرط على الإخوان يتجاهل الواقع المعقد الذي يعيشه السوريون اليوم، حيث لا تقتصر التحديات على فصيل واحد، بل تشمل شبكة متشابكة من الصراعات الطائفية والإثنية والسياسية.
فالميليشيات الطائفية ما زالت ناشطة في عدة مناطق سورية، بعضها يعمل بغطاء داخلي وبعضها الآخر مدعوم من قوى إقليمية. هذه المجموعات المسلحة لا تقل خطراً على السلم الأهلي عن أي تنظيم سياسي، بل إنها تُسهم في تأجيج النزاعات وزرع بذور الثأر والكراهية، مما يهدد أي محاولة لبناء دولة جامعة. تجاهل هذا الواقع مقابل تضخيم خطر الإخوان يعكس انتقائية متعمدة في قراءة المشهد.
إلى جانب ذلك، هناك نزاعات إثنية لا يمكن القفز فوقها. العرب والأكراد والآشوريون وغيرهم من المكونات يعيشون حالة من الشك المتبادل والبحث عن ضمانات لحقوقهم السياسية والثقافية. المشروع الكردي في الشمال الشرقي مثلاً لا يزال قائماً على رؤية مغايرة تماماً للدولة المركزية، بينما الأقليات الأخرى تبحث عن تمثيل وحماية في ظل تجربة تاريخية مثقلة بالتهميش. هذه الانقسامات العرقية ليست تفصيلًا ثانوياً يمكن تجاهله بتركيز الضوء على الإخوان وحدهم.
وفوق ذلك كله، فإن التدخلات الإقليمية والدولية تملي إلى حد بعيد اتجاهات الصراع السوري. القوى الكبرى والإقليمية لا تنظر إلى الإخوان باعتبارهم الخطر الأكبر، بل تتحرك وفقاً لمصالحها الاستراتيجية المرتبطة بالنفط، والممرات الجغرافية، وموازين القوى الإقليمية. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل حل الإخوان كتنظيم سيُنهي هذه التصدعات العميقة؟ أم أن هذا التركيز عليهم ليس سوى محاولة لإيجاد كبش فداء سياسي تُلقى عليه مسؤولية التعثر القادم، بينما تبقى المشكلات البنيوية الحقيقية بلا معالجة؟
الانتقائية في قراءة التجارب
يحاول أحمد موفق زيدان أن يدعم دعوته لحل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عبر الاستشهاد بتجارب تاريخية للحركات الإسلامية في دول أخرى، مثل العراق والمغرب وتركيا. في الظاهر، تبدو هذه المقارنات منطقية، لكنها في الحقيقة انتقائية تتجاهل السياقات المختلفة التي أحاطت بكل تجربة. فالتغييرات التي شهدتها هذه الدول لم تكن مجرد قرار بحل التنظيمات، بل جاءت نتيجة مسارات اجتماعية وسياسية معقدة لا علاقة لها بالظرف السوري الحالي.
ففي تركيا مثلاً، لم تنجح الحركة الإسلامية في الخروج من أزمتها إلا بعد أن وفرت لها البيئة السياسية قدراً من الديمقراطية الانتخابية النسبية، التي سمحت بظهور أحزاب جديدة مثل حزب العدالة والتنمية. لولا وجود صناديق اقتراع حقيقية وفضاء سياسي مفتوح نسبياً، لما تمكن الإسلاميون الأتراك من التحول إلى قوة فاعلة. أما في سوريا، فالوضع مختلف جذرياً، إذ لا وجود بعد لبنية سياسية أو مؤسسات ديمقراطية يمكن أن تحتضن تحولاً مماثلاً.
وفي المغرب، تمكّن الإسلاميون من المشاركة السياسية بفضل منحهم شرعية رسمية من قبل الدولة، ما أتاح لهم تأسيس حزب العدالة والتنمية ودخولهم الانتخابات وصولاً إلى رئاسة الحكومة. هنا أيضاً كان السياق قائماً على اعتراف متبادل بين النظام والحركة الإسلامية، بينما في سوريا ما بعد الحرب لا تزال ملامح الدولة نفسها غامضة ومحل صراع بين قوى متعددة، مما يجعل المقارنة غير ذات معنى.
أما في العراق، فقد جاءت تحولات الإسلاميين بعد 2003 ضمن ظروف استثنائية تمثلت في سقوط الدولة المركزية تحت الاحتلال الأميركي، وظهور فراغ سياسي هائل فتح الباب أمام إعادة تشكيل القوى السياسية من جديد. هذه الظروف لا يمكن إسقاطها على الحالة السورية، لأن سوريا لم تشهد انهياراً كاملاً لمؤسساتها بقدر ما تعيش حالة تفكك وتنازع بين سلطات متعددة. وبالتالي، فإن استدعاء هذه النماذج يهدف فقط إلى إضفاء مشروعية على دعوة زيدان، من دون أن يستند إلى شروط موضوعية تجعل المقارنة واقعية.
الدلالة السياسية للمقال
يمكن قراءة مقال أحمد موفق زيدان على أنه موجّه بعدة رسائل متزامنة، كل منها يخاطب جمهوراً محدداً. على الصعيد الداخلي، يسعى المقال إلى إضعاف مكانة الإخوان المسلمين، عبر تصويرهم كالعائق الأبرز أمام استقرار الدولة الوليدة. هذه الرسالة تستهدف بالدرجة الأولى الشارع السوري الداعم للسلطة الجديدة، لتشكيل قناعة عامة بأن استبعاد الإخوان أو حلهم أمر ضروري لحماية "المكاسب الوطنية". لكن في الواقع، هذا الخطاب لا يفتح الباب أمام شراكة سياسية حقيقية، بل يكرس عقلية الإقصاء وإعادة إنتاج الأحادية تحت غطاء جديد.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فالمقال يتعمد استدعاء صورة "الإخوان المسلمين" كتنظيم يثير القلق لدى أطراف عديدة، من عواصم عربية إلى عواصم غربية. فالتلويح بحل الإخوان وتهميشهم يُراد له أن يقدم القيادة السورية الجديدة كحكومة "براغماتية" تنأى بنفسها عن المشاريع الأيديولوجية المثيرة للجدل، وتسعى لبناء علاقات طبيعية مع المحيط. بهذا الشكل، يصبح المقال أداة علاقات عامة موجهة للخارج، أكثر منه تحليلاً سياسياً للداخل السوري.
على المستوى الشخصي، يبدو المقال أيضاً محاولة من زيدان لتلميع صورته وإبراز نفسه كصاحب "شجاعة فكرية" قادرة على نقد الماضي والحاضر. فهو يذكر بمقالاته السابقة، ويحرص على تقديم نفسه كصوت مستقل لا يخشى الخروج عن الإجماع. غير أن هذه "الشجاعة" المزعومة لا تُترجم إلى رؤية إصلاحية شاملة، بل إلى دعوات انتقائية تصب في خانة تعزيز موقعه السياسي الجديد. إنها أقرب إلى تبرير تحوّل شخصي من موقع المعارضة إلى موقع السلطة، عبر تقديم نفسه كمن يملك مفاتيح الحل.
لكن النتيجة النهائية للمقال تكشف فراغاً كبيراً في الرؤية السياسية. فبدلاً من طرح تصور متماسك لمستقبل الحياة السياسية في بلد ممزق بالانقسامات الطائفية والإثنية والجغرافية، يكتفي زيدان بتكرار خطاب إقصائي جديد يضع الإخوان وحدهم في خانة "المشكلة". بهذا، لا يقدم المقال أي إجابة عن سؤال أساسي: كيف يمكن بناء نظام سياسي تعددي يضمن مشاركة مختلف القوى؟ بل يكتفي بإعادة إنتاج منطق إلغاء الآخر الذي كان سبباً رئيسياً في مآسي سوريا المعاصرة.
التناقض في مفهوم الدولة
يطرح زيدان في مقاله فكرة "الدولة الوليدة" بوصفها الكيان الذي ينبغي أن تذوب فيه جميع التنظيمات والأحزاب والفصائل. لكنه لا يقدم أي تصور واضح عن طبيعة هذه الدولة: هل هي دولة مدنية تعددية قائمة على التمثيل السياسي والمشاركة المجتمعية؟ أم أنها مجرد سلطة جديدة تحمل اسم "الدولة" لكنها تفتقر إلى مقوماتها المؤسسية والدستورية؟ هذا الغموض يجعل الدعوة أقرب إلى خطاب تعبوي عاطفي منه إلى رؤية سياسية محددة المعالم.
فالحديث عن دولة بعد ثورة يفترض بالضرورة وجود قواعد جديدة للعبة السياسية، تتيح لكل القوى ـ بما فيها الإسلامية، والقومية، والليبرالية، والأقليات ـ المشاركة في صياغة المستقبل. أما إذا كان المقصود "تسليم الجميع" لسلطة مركزية تحتكر القرار، فإننا أمام إعادة إنتاج لنمط الإقصاء القديم، مع استبدال أسماء وألوان، لكن من دون تغيير في الجوهر. وهنا تكمن المفارقة: المطالبة بحل الإخوان بدعوى أنهم يرفضون التكيف، بينما تُطرح الدولة الوليدة نفسها ككيان يرفض التعددية منذ البداية.
الأكثر إشكالية أن الكاتب، وهو يتهم الإخوان بـ"الديناصورية" والتشبث بأفكار متقادمة، يستخدم هو ذاته لغة أيديولوجية تقليدية لا تقل جموداً. فخطابه يقوم على ثنائية "الاندماج الكامل أو الإقصاء التام"، وكأن السياسة لا تعرف الحلول الوسط أو التسويات التوافقية. في هذه اللغة، لا يُنظر إلى الإخوان كتيار سياسي يمكن أن يشارك ضمن قواعد جديدة، بل كعقبة ينبغي اجتثاثها، وهي نفس المقاربة التي طالما اتبعها النظام البعثي في الماضي تجاه خصومه.
وبذلك يصبح خطاب زيدان متناقضاً من الداخل: فهو يهاجم الآخر باعتباره أسير الماضي، لكنه في الوقت نفسه يعيد إنتاج أدوات الماضي نفسها في نفي الآخر وإقصائه. وإذا كانت الثورة قد قامت أصلاً لإنهاء منطق الاستبعاد والاحتكار، فإن العودة إلى هذا المنطق تحت مسمى "الدولة الوليدة" لا تمثل خطوة إلى الأمام، بل إعادة دوران في حلقة مفرغة من الاستبداد.
خاتمة
المقال الذي كتبه أحمد موفق زيدان ليس مجرد نص فكري أو نقد تنظيمي، بل هو بيان سياسي يستهدف إخراج الإخوان من المعادلة السورية الجديدة. غير أن التركيز على حل الجماعة بمعزل عن بقية التعقيدات يختزل الأزمة السورية إلى "مشكلة تنظيم"، بينما الحقيقة أنها أزمة بنيوية شاملة تشمل الطائفية والتدخلات الخارجية والانقسام المجتمعي وغياب عقد وطني جامع.
إن أي دعوة للحل أو الإقصاء لا يمكن أن تؤسس لسوريا مستقرة، بل تعيد إنتاج الاستبعاد الذي كان جوهر مأساة العقود الماضية.