العنف بين سلطة الدولة والمجتمع
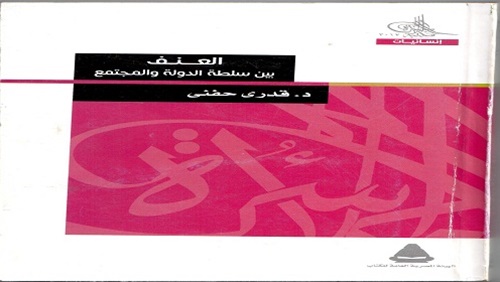
اسم الكتاب: العنف
بين سلطة الدولة والمجتمع
اسم المؤلف: د. قدري
حفني
دار النشر: الهيئة
المصرية العامة للكتاب
نحن من نزرع سلوك العنف في الفرد المكون والخلية الأساسية لأي مجتمع، النشأة الأسرية والثوابت الثقافية والتقاليد والعادات، وغيرها من العوامل التي يتعرض لها الإنسان أثناء تشكيل شخصيته حتى يصبح عنصرا فاعلا في المجتمع، والتي تشكل تصرفاته وردود فعله، بالإضافة إلى العوامل الخارجية وتأثره بالمجتمع والأشخاص المحيطين به، والظروف الاجتماعية والاقتصادية كل هذه تساعد وتساهم في قابليته أن يكون عنيفا أو لا، هذا ما يناقشه كتاب " العنف ... بين سلطة الدولة والمجتمع"، لمؤلفه الدكتور قدري حفني المعالج النفسي وأستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس، الكتاب صدر عن الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة "إنسانيات" والمعنية بتاريخ دراسة الإنسان ونشأته وبيئته، ويقع الكتاب في 366 صفحة، يحاول فيه حفني طرح عدة قضايا ومناقشة العديد من المفاهيم منها قضايا العنف والتعذيب السياسي، وأسبابهما، وتعامل المجتمع معهما وكيفية صناعة الفتن، وأيضا تحليل فكر الطاعة والعنف لدى الجماعات الإرهابية.
يبدأ الكتاب بمقارنة عقدها المؤلف بين سلوك الجلادين في فترة السبعينيات والوقت الحالي، وذلك من خلال تجربته الشخصية، ففي فترة السبعينيات، كان الجلادون ينكرون أي ممارسة من ممارسات التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، والتي كانت تحدث في سرية وإنكار ممارستها، على عكس مما يحدث الآن من الجهر بتعذيب المواطنين في المعتقلات وإذاعة فيديوهات التعذيب على الملأ، ويقول حفني: "استوقفتني ظاهرة فريدة تمثلت في انتقال التعذيب من الأقبية المظلمة، والزنزانات الرطبة، ومحاولات التخفي خلف الأسوار العالية، والسعي الحثيث إلى إنكار اقتراف تلك الجرائم بل استنكارها والتبرؤ منها، إلى تعذيب أشد بشاعة يحرص مرتكبوه على اقتراف جرائمهم في وضح النهار، وعوضا عن تسجيلها رغما عنهم تلصصا، وتسريبها خلسة، يقوم الجلادون أنفسهم بتسجيل ما ارتكبوه وإذاعته علنا لمن لم تتح لهم مشاهدته، متفاخرين بما اقترفوه باعتباره بطولات تنم عن مدى تمسكهم بالمبادئ الأخلاقية والوطنية بل والدينية الرفيعة" ص33.
ويتطرق المؤلف إلى سلوك الطاعة لدى عساكر الأمن المركزي في تأدية مهام تعذيب وضرب المعتقلين دون التفكير، مشيرا إلى حرص الدولة بعدم تعليمهم أو إعطاءهم أي قدر من التعليم بشكل متعمد، أو التهيئة الفكرية مثلما يحدث مع الجلادين في الدول العقائدية، فيقول :" عندما وصلت دفعة جديدة من المعتقلين، كان أول من استقبلتهم هي فرقة اللواء همت وانهالوا عليهم الجلادين بالعصى وهم يصرخون طالبين منهم سب آل البيت، مكررين آخر خبرة لهم وكانت تعذيب المعتقلين من الإخوان المسلمين؛ وحين صرخ فيهم قائدهم منبها "دول شيوعيين كفرة" تحولت الصرخات فورا إلى "قولوا لا إله إلا الله يا كفرة". ص37
يعرف حفني العنف بأنه العنف المقصود هو سلوك بدني جماعي تلقائي مؤقت يتسم بالعدوانية الصريحة التي تستهدف إلحاق تدمير بنماذج بشرية ومادية للسلطة"، وهو خاصية بشرية طبيعية، مارسه ويمارسه البشر منذ وجدوا، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، ويرجع المؤلف أسباب انتشار العنف في المجتمع والتغاضي عنه أو الحث عليه لوجود ما يسمى ثقافة تقديس العنف وتقديس الطاعة، وخلق مبررات لدى فئات المجتمع لتبرير أفعال العنف ضد شريحة معينة من المجتمع، ويرجع حفني سلوك العنف عند الفرد وإلحاق أضرار مادية وجسدية ضد الآخرين، إلى غرس قيم تقديس العنف وربطها كثقافة بأنها نوع من أنواع الاحترام، وتأتي من خلال عملية تدريب اجتماعي بتأكيد أن الشخص القوي والقادر على إلحاق الأذى بالآخرين هو الشخص "المحترم" في مقابل أن الشخص الهادئ المسالم الذي يلتزم بالقانون ويلجأ إليه للشكوى ورد الاعتداء شخص ضعيف لا يستحق الاحترام، هذا بالإضافة في زرع ثقافة تقديس الطاعة، متطرقا لسلوك الطاعة لدى جلادي الدولة أو الجماعات الإرهابية، فهم يستجيبون لأوامر رؤسائهم استجابة تتسم بقدر كبير من الخضوع، ولا يناقشون هذه الأوامر ولا حتى يفكرون فيها، بل يطيعون رؤساءهم وأمراءهم طاعة عمياء وينفذون أوامرهم بالتعذيب دون تردد، وغالبا ما يكون هؤلاء من الذين يسهل إقناعهم والإيحاء لهم بأن ما يفعلونه فيه مصلحة للبلد أو للبشرية أو لقضية ما.
كما يحاول حفني في الفصل الأول والذي تطرق فيه لذكرياته مع التعذيب في السجن في تحليل ومواجهة فكرة التعذيب كسلوك عنيف انتشر بين أفراد المجتمع، وأن يطرح حلولا لانحسار موجة العنف المتولدة بطبيعة الحال مع انتشار الفقر والجهل، فيقول: " لا يمكن أن يتراجع العنف بشكل أساسي إلا إذا أصبح سلوكا مرفوضا بحق وبعمق وبدون استثناء من القطاع الغالب من أبناء المجتمع، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتجفيف منابع ذلك القبول الدفين أو المعلن لممارسة التعذيب بكشف زيف الشعارات والمبررات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية لتعذيب الآخرين مهما كانت جرائمهم الوطنية أو الأخلاقية أو الدينية".
ويحلل حفني في دراسة له
العلاقة بين تفاوت درجات العنف وبين طبقات المجتمع وفئاته الممارسة له، ويتساءل
قائلا: "هل لكل طبقة عنفها المتميز؟ أي هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه عنف
الفقراء في مقابل ما يمكن أن نطلق عليه "عنف الأغنياء"؟ وهل لكل من هذين
النوعين من العنف خصائصه المتميزة؟ أم أن العنف سمة تختص بها طبقات اجتماعية دون
غيرها؟، ومن ثم فإنه يكون لصيقا بالفقراء دون غيرهم؟ ولماذا يميل الفقراء في
مجتمعنا وفي المرحلة التاريخية التي شهدتها مصر عقب 25 يناير إلى ممارسة هذا النوع
من العنف التلقائي؟ ترى هل هي سمة عامة على المستوى الحضاري تشمل مجتمعنا ضمن غيره
من المجتمعات؟".ص78
ويستخلص حفني من نتيجة
الدراسة أن العنف التلقائي الجماهيري الموجه للسلطة في بلادنا هو عنف يمارسه الفقراء
دون غيرهم؛ ولعل "جماهيرية" هذا العنف قد حددت منذ البداية انتماءه
الطبقي، وهو رد فعل تلقائي نتيجة الشحن المستمر الذي تعرض له فقراء المجتمع من
استفزاز طبقي من الدولة في تقديم الخدمات لهم، وعدم تلقي أي قدر من الاحترام من
الدولة لهم سواء في تقديم الخدمات أو المعاملات في مؤسساتها، بدءا من مؤسسات
التضامن الاجتماعي وصولا إلى أقسام الشرطة، إلى أن الثورات تسبقها عادة فترة من
النمو الاجتماعي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الطموح يليها فجأة انهيار حاد يؤدي إلى
انخفاض مستوى القدرة على الانجاز.
العنف في دائرة المجتمع:
ينتقد المؤلف في الفصل الثالث سلوك المجتمع، الذي يحصن نفسه
باستمرار على ممارسة العنف بل ويدين من يحجم عن هذه الممارسة مهما كانت دوافعه
كالتصدي عنفاً للعدوان الفردي أو الجماعي أو القومي، لتشكيل مناخ يقدس العنف،
ويشجع الإرهاب ويلتمس المبررات لمن يمارسونه، سلوك ينتقد السلام ويضع صاحبه تحت
وطأة تفسير سلوكه "الغريب" إذا ما تحدث عن مزاياه، وهو نفس المجتمع الذي
خلق مناخ يدعو فيه إلى إبادة من يخالفه الرأي، وإخراس أي أصوات معارضة له، وإلا فالتطاول
على معارضيه سواء بالسب والإهانة والتشويه له ولمن يدافعون عنه و احتقارهم جميعا
هو الحل.
ويقول حفني أن هذا النمط السلوكي يعد نوعا من أنواع
العنف الفردي والجماعي يمارسه المجتمع من خلال غرس قيم العنف في أفراده وتنشئته على
ممارسته ودفعهم بكافة أساليب الثواب والعقاب إلى هذه الممارسة، فيقول: "تاريخيا
لعل ذلك ما حدث تحديداً عقب هزيمتنا عام 1967، حيث تم رفع شعار "إن ما أخذ
بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" ولم نقصره على صدام الجيوش، بل جعلناه أسلوبنا
المفضل في حل كافة الخلافات، ساخرين من فكرة التفاوض، أو اللجوء إلى القانون، أو
الاعتماد على الرأي العام وأساليب الاحتجاج المدني، مؤكدين أن القوة وحدها هي الحل
وكل ما عداها ضعف وهوان واستسلام، ودأبنا على تعميق ذلك خلال عمليات تشكيل الوعي
الاجتماعي التي مارسناها جميعاً دون استثناء، وبالتراكم شيئاً فشيئاً أصبحت تلك
الشعارات والممارسات بمثابة ضمير الأمة: "كن قويا خشنا عنيفا مرهوب الجانب
تحظى باحترام الجميع وتضمن ألا يعتدى عليك أحد، لا تسلك كالضعفاء فتلجأ للقضاء أو
تتعلق بأوهام الرأي العام والاحتجاج المدني والتفاوض"، ليستمر الحرص على
تعميق ذلك التوجه حتى بعد انتصار أكتوبر الذي لم يكن كافيا للقضاء على ثقافة
الهزيمة لأسباب داخلية وإقليمية وعالمية لا يتسع المقام لتفصيلها".ص 182
تدرج العنف من المجتمع إلى الدولة:
واحدا من أسباب العنف المجتمعي هو التصنيف الدائم للآخر،
والتصنيف دائما ما يقوم على أساس عرقي، أو جغرافي (فلاحيين – صعايدة – مدنيين)، أو
ديني (مسلم – مسيحي)، طبقي (فقير – غني)، ويتخذ في السلطة وأوساط السياسة وفقا
لانتماءات الفرد السياسية وأفكاره ( يساري – ديني- علماني – ليبرالي.... إلخ ) هذه
التصنيفات، ولو ألقينا نظرة
إلى الخطاب السياسي الرسمي والشعبي في العالم العربي كفيلة بالكشف عن أن قضية
تدريج الانتماءات تدخل في نطاق الأمور المسكوت عنها بحيث تبدو تلك الانتماءات كما
لو كانت خطوطا متوازية، فنحن عرب ونحن منتمون لدولنا العربية، ونحن منتمون
لدياناتنا، فضلا عن أننا بشر وشرق أوسطيون، ووفقا لتلك التصنيفات يتم على أساسها
غرس قيم العنف والتعامل مع ذلك الآخر، الأمر الذي يقتضي منا تزويد أطفالنا
بالمهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع "الآخر"، بصورة الثلاث التي
أشرنا إليها: صديقاً، أو عدواً، أو مجهولاً. فضلاً عن أنه ينبغي تزويدهم أيضاً
بتلك المهارات اللازمة لإتقان اختيار الأداة المناسبة في الموقف المناسب تبعاً
لهوية ذلك "الآخر"، بحيث لا تكون أداة التعامل مع "الأخر
العدو" هي المقاطعة مثلاً، في حين تكون أداة التعامل مع "الأخر
الصديق"، أو حتى مع فريق من أعضاء جماعة الـ"نحن" هي ممارسة العنف
فوراً وبلا تردد.
من هذا المنطلق يتدرج العنف في المجتمع ليدخل في نطاق
أوسع من فردي أو مجتمعي إلى عنف سلطوي قائم على التفريق السياسي، ويعرف قدري العنف
السياسي على أنه نوعٌ من أنواع
العنف الداخلي يجري بين أطراف ثمة ما يجمع بينها، ويدور حول السلطة ويتميّز
بالرمزيّة، والجماعيّة، والإيثاريَة عنف توجهه وتحركه أفكار، ودوافع، تتجاوز – في
صورتها المعلنة على الأقل – المصالح الفردية المباشرة لمن يمارسونه من كلا
الجانبين ، كما يتسم بالإعلانيّة"،. ص221.
ووفقا لهذا التعريف يرى قدري أن العنف السياسي يتخذ مسارين أساسيين، الأول، موجهٌ إلى الممسكين بالسلطة، ويمارسه أصحابه، بهدف
انتزاعها من بين أيديهم، أو بهدف مشاركتهم في الإمساك به، أما الثاني فهو موجه من رموز السلطة إلى من ينازعونهم إيّاها، بهدف
الاستمرار في الإمساك بها وإحكام قبضتهم عليها، ليكون العنف السياسي عنف متبادلٌ بالضرورة، وإن كان لا يستهدف
أشخاصاً لذواتهم، بل يستهدفهم لصفاتهم الاجتماعية، أو الفكرية، أو الدينية، أو
العرقية، وبالتالي فإنه
لا يقتصر على الممثلين الرسميين للجماعة المستهدفة، بل يوجه أيضًا إلى جمهور تلك
الجماعة بدرجة أو بأخرى، وعليه فإن المجتمع أو بمعنى أدق يجب التعرف على جمهور تلك الجماعة لتمييزهم عن جمهور جماعة
الـ"نحن"، وتكريس ما يمكن أن نطلق عليه تعبير "العلامات الظاهرة
للانتماء لتلك الجماعة الأخرى". والتعريف بكافة الخصائص المرئية أو المسموعة
التي يمكن من خلالها تبيّن انتماء الفرد إلى جماعة معينة دون غيرها. ص225
وتتعدد تلك
العلامات. فمنها ما يتعلق بالخصائص البدنيّة الموروث منها أو المصطنع، ومنها ما يتعلق
باللهجة وطريقة النطق، ومنها ما يتعلق بالملابس، ومنها ما يتعلق بالعادات أو رفع
الشعارات.
"إن الوجه
الأحمر، والانف المعقوف، والبشرة السوداء، والشعر الأصفر، والعيون المائلة.. إلى
آخره؛ وكذلك اللحية، وطريقة تصفيف الشعر، وعلامة الصلاة.. إلى آخره؛ وكذلك أيضاً
لثغة الراء، والعجز عن نطق بعض الحروف، والميل لإخراج الكلمات من الأنف.. إلى
آخره؛ وأيضاً الملابس العسكرية، والنقاب، والحجاب، واللحية المهذبة أو المطلقة دون
تهذيب، والعقال، والقبعة، والملابس الرياضية، والكوفيّة.. إلى آخره؛ هذه كلها مجرد
نماذج لعلامات تُستخدم لتمييز انتماءات الأفراد، ولقد لعبت بالفعل، وما زالت تلعب
دوراً حاسمًا في تحديد أفراد الجمهور المستهدفين للعنف السياسي". ص228
أنواع العنف السياسي:
يتنوع العنف السياسي إلى عدة أنواع منها العنف السياسي القومي الذي تتمايز فيه الجماعات تمايزًا قوميّا، حيث تكون السلطة في
يد ممثلي قومية معينة، في حين ينتمي من ينازعونها تلك السلطة إلى قوميّة أخرى
مختلفة، وهذا النوع من العنف تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة.
أما النوع الثاني فهو العنف السياسي الاقتصادي ويكون الهدف النهائي منه، هو تغيير النظام الذي تتبعه
السلطة لإشباع احتياجات المواطنين. وتكون قناعة ممارسيه من الساعين للاستيلاء على
السلطة، هو أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا بإزاحة الممسكين بزمام السلطة عن مواقعهم
وهو ما حدث في ثورة الخامس والعشرون من يناير، أما ما نشاهده اليوم
وعقب ثورة 30 يونيو فهو النوع الثالث من العنف ويسمى بـ"العنف السياسي الديني"، والذي أصبح الأعلى ضجيجاً في عالم اليوم، ومن ثم في منطقتنا أيضاً، ومن
المفهوم، أن أطراف العنف السياسي الديني لابد وأن تكون مستظلة بعلم واحد، أي
منتمية لدولةٍ واحدة، يستهدف الصراع سلطتها، وإلا تحول العنف السياسي الديني، إلى
حرب دينية شأن الحروب الصليبيّة على سبيل المثال.
ولعله مما ينبغي
أن يستوقف النظر، أن مثل هذا النوع من أنواع العنف، رغم توجيهه إلى جماعة مختلفة
دينيّا، فإن مثل تلك الجماعة قد لا تكون مستهدفة لذاتها، بل لكونها تعيش في كنف
السلطة التي يستهدفها العنف أساساً.
العنف لدى الجماعات الإرهابية المسلحة:
ينتقل الدكتور
حفني في نهاية الكتاب إلى تعريف وتحليل السلوك الإرهابي للجماعات الدينية الإرهابية
المسلحة، فيعرفه قائلا: "هو سلوك
اختياري، مخطط بدقة ودراسة عميقة للهدف؛ يلحق أضرارا بالمدنيين، ويتضمن مخاطرة
بحياة من يقوم به، ويكون إطاره التفسيري من وجهة نظر صاحبه إطارا فكريا أو سياسيا
أو عقائدياً، وبذلك فإن الفعل الإرهابي يختلف من هذا المنطلق السلوكي النفسي عن
أفعال عديدة قد تماثله في ظاهر السلوك، بل وقد لا تقل عنه في فداحة النتائج"، ويرجع حفني في كتابه
بأن أغلب العمليات الإرهابية اتسمت بكونها انتحارية، خاصة وأن ليس مألوفا أن يقدم المرء مختارا على إعلان مسئوليته عن
عمل قام به، وهو يعرف مقدّمًا أنه بإعلانه هذا، إنّما يعرّض نفسه لأذى قد يصل إلى
حدّ الموت، ولذلك فإن أصحاب السلوك العدواني لا يعترفون بما فعلوا إلا مضطرّين،
ويستثنى من تلك القاعدة، على سبيل الحصر، جرائم الثأر، والشرف، والحرب، وكذلك
الأفعال الإرهابية، بل إن أطراف الإرهاب، يتسارعون للإعلان عن مسئوليتهم عن
أفعالهم، حتى إننا قد نشهد فردين، أو جهتين، أو تنظيمين، يتنافسان منافسة شديدة في
نسبة عمل من أعمال الإرهاب إلى أحدهم، وذلك لأن تلك الجماعات استطاعت عبر مجتمعها المغلق من
تهيئة أفرادها لتقديس الطاعة دون مناقشة وهذا ما أوردناه في بداية الدراسة". ص
277















