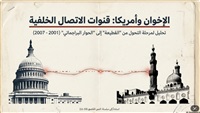تأثير الخطاب الديني في العقل والسلوك الجمعي
الأربعاء 11/فبراير/2015 - 07:17 م
طباعة
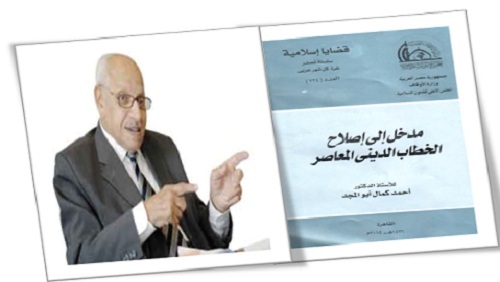
• اسم الكتاب- مدخل إلى إصلاح الخطاب الديني المعاصر
• الكاتب- الدكتور احمد كمال ابو المجد
• الناشر – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – القاهرة سلسلة قضايا اسلامية 2015
في بداية كتابه (مدخل إلى إصلاح الخطاب الديني المعاصر).. يحدد الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد الخطاب الديني، بأنه خطاب الدعاة والوعاظ والخطباء والمفتين والباحثين، حين يقدم إلى جمهور الناس على أنه الوصف السليم والفهم الصحيح للإسلام في عقيدته ونظامه الأخلاقي وآدابه وشريعته.
ولهذا الخطاب الديني ـ بتعريفه هذا ـ دور أساسي في تكوين "العقل المسلم" و"الوجدان المسلم"، ومنه يتلقى عامة الناس تصورهم للإسلام، وللعالم في ظله.. وتزداد أهمية ترشيد هذا الخطاب في ظل أمرين تكاد تشترك فيهما جميع البلاد الإسلامية.. أولهما انتشار الأمية بمعناها العام، والأمية الدينية بوجه خاص.. وهو ما يحول دون الاتصال بمصادر المعرفة الدينية الصحيحة، من المراجع المعتمدة في التفسير وفى علوم الحديث والسيرة والفقه.. وما يجعل الخطاب الديني بمعناه الذى بيناه المصدر الأساسي إن لم يكن الوحيد للمعرفة الدينية.. والمسئول الأول عن تحديد معالم "التدين" ورسم صورة "المتدينين" لدى الأفراد ولدى الجماعة، ولدى الغير.. ثانيهما: تعاظم موجة التدين احتجاجًا على المادية التي آل إليها أمر الحضارات المعاصرة.. وما صاحبها من تراجع في "نوع" العلاقات الإنسانية السائدة، وفسادٍ لذات البين داخل الجماعة الواحدة، وداخل المجتمع الدولي كله، وهو التراجع المسئول ـ مع أسباب أخرى ـ عن انتشار ظواهر الأنانية والانحصار على الذات، وظواهر العنف الفردي والجماعي، الذى يتخذ أشكالاً متعددة باختلاف ميادينه، بدءًا بالعنف الفردي والحكومي، وانتهاء بالإرهاب الداخلي والدولي، ووصولاً إلى الحروب الأهلية والإقليمية والدولية. أن الصورة الغالبة للخطاب الديني المعاصر تحتاج إلى النقد، وإلى المراجعة الهادئة في غير مبالغة أو تهويل.وحدد ابو المجد سبعة عناصر مظاهر انحراف الخطاب الديني عن توجيهات الاطار المرجعي الثابت للدين وهى:
العنصر الأول: الترهيب والتخويف:
أول عناصر الخطاب الديني المعاصر، وأكثرها انتشارًا، وأشدها حاجة للمراجعة، الدعوة للإسلام عن طريق الترهيب والتخويف، وإغفال الدعوة إليه عن طريق الترغيب والتبشير.. وقد كان من ثمرات هذا الخلل أن وجدنا كثيرًا من المتدينين يقبلون على التدين "مذعورين" مخوفين، تلاحقهم صيحات الوعيد، وما ينتظرهم يوم القيامة من عذاب أليم مهين.. وهو ذُعر يملأ النفوس قلقًا، ويحول بينها وبين السكينة والرضا.. وقد يحول بين أصحابه وبين التوجه للعمل البنائي الصالح الذى هو رسالة المسلمين في الدنيا وطريقهم إلى السعادة في الآخرة.. ذلك أن الخائفين المذعورين لا يصلحون لبناء الحضارات العظيمة، وحمل تبعات هذا البناء.. ومخالفة هذا التوجه لصحيح الإسلام لا تحتمل الجدل الكثير.
إن الترغيب، والتبشير يظلان معًا المدخل الأساسي لجذب النفوس إلى الحق.. وهما يفعلان فعل السحر عند أكثر الناس، ويشيعان في النفوس جوّاً من الطمأنينة والسكينة والرضا، ويفجران ينابيع الخير والتوجه إليه انطلاقًا من حقيقة وجودية وإيمانية كبرى مؤداها أن الله تعالى خلق عباده كلهم "حنفاء" كما يقول الحديث القدسي، وحين تتفجر ينابيع الخير تتفجر معها طاقة العمل والقدرة على الإبداع والبناء والتعمير، وهى غايات كبرى من غايات الوجود الإنساني على هذا الكوكب "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" (61ـ هود). إن الخوف وحده يبعث على التراجع والانكماش.. أما الاطمئنان والثقة فإنهما يبعثان على الحركة والتقدم والانتعاش.
العنصر الثاني: الميل إلى التشديد على الناس:
جوهر التشديد التوسع في إيجاب الواجبات والتضييق في إباحة المُباحات واختيار أعسر الأمور وأجلبها للمشقة وأدعاها إلى وقوع الحرج مع وجود البديل الذى يرفع الحرج ويجلب التيسير.
والمتشددون ـ في كل زمان ـ يصدرون في تشددهم عن تصور خاطئ لمهمتهم وحدودها، فهم يتصورون أنفسهم وصاة على الدين وعلى الناس، وهم لذلك في خوفٍ دائم مقيم أن يؤدى التيسير على عباد الله إلى الخروج على حدود الله وتكاليف الشريعة. وينسى هؤلاء أنهم دعاة ومبلغون، وليسوا أوصياء على أحدٍ من الناس.. إذ تظل الطاعة والمعصية أمورًا منوطة باختيار الأفراد والمكلفين، يسألون عنها بين يدى خالقهم الذى علمهم أنه "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (256 ـ البقرة). وعلمهم رسوله (صلى الله عليه وسلم) أن ما يلقونه يوم الحساب لا يعدو أن يكون ثمرة أعمالهم "ترد إليهم".
كذلك يتصور المتشددون أن تشددهم من شأنه أن يقفل أبواب الشر والعوج، وأن يسد الذرائع في وجه الانفلات من تكاليف الشريعة.. وينسون أن سد الذرائع طريق احتياطي من طرق التشريع والإفتاء.. وأنه كما يسد مداخل الشر، فإنه يفتح أبواب الخير.. كما ينسون أن المرجع في حل الأفعال والتصرفات وتحريمها إنما هو إلى الخالق سبحانه.. وأن الوصول في التشديد إلى الاقتراب من تحريم الحلال لا يقل إثمًا عن الوصول إلى تحليل الحرام، يشهد لذلك ويقرره قوله سبحانه: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام" (116 ـ النحل)
والتشديد ـ فوق ذلك كله ـ من شأنه أن يصور للناس أن طاعة الله أمر عسير، وأن التدين يحمِّل أصحابه عناءً ومشقة.. مما يغرى كثيرين "بالإعراض عن جملة الشريعة" كما يقول ابن قيم الجوزية.
والتشديد ـ في حقيقته ـ هو الاجتهاد الأسهل وليس الاجتهاد الأفضل، إذ الأمر كما قال الفقيه الكبير سفيان الثوري عليه رحمة الله: "ليس العلم في التشديد، فإنه يحسنه كل أحد، إنما العلم الرخصة من ثقة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه كما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ويحتاج الدعاة والخطباء والمتحدثون والمفتون إلى أن يعرفوا معرفة لا شك فيها، ولا مكابرة معها أو جدال. أن شريعة الإسلام قد بنيت على التيسير ورفع المشقة ورفع الحرج، ولم تبن أبدًا على التعسير والمشقة والحرج.. وهذا من أصول الإسلام الكبرى التي تشهد لها نصوص عديدة في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي لا ترد.. يقول الحق سبحانه: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (185 ـ البقرة). ويقول: "هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج" (78 ـ الحج). ويقول: "الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا" (66 ـ الأنفال). .
إن موقف المسلم من الحياة قضية بالغة الأهمية لابد أن ينتبه إليها المشتغلون بالخطاب الديني، إذ إن الخلل فيها هو أول أبواب الانحراف الذى تقع فيه جماعات من الشباب، الذين يبدأون تدينهم بالعزلة عن المجتمع، وفى العزلة يلقنون كراهية الحياة وكراهية الناس، ويقيمون في أنفسهم حربًا باردة يحاكمون فيها مخالفيهم.. وبعيدًا عن نور المعرفة وإشراقات السماحة تكون مفاصلة المجتمع، واتهام أهل الزمان كلهم جميعًا بالكفر، ووصف العصر كله بالجاهلية.. وهى آفات خطيرة نبه إليها العلماء المحققون، فوجدنا ابن القيم يقول في أمثال هؤلاء:
"ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلم بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت فى الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم.. وسموا دارهم دار هجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب".
العنصرالثالث:
الغفلة عن مقاصد الشريعة والوقوف عند ظاهر النصوص وحروفها..
وهذا المنهج النصي الخالص الذى لا يلتفت إلى المقاصد يسميه البعض تجاوزًا أو خطأ بـ"السلفية"، وهى كلمة حمالة أوجه استعملها ابن تيمية وغيره في ميدان العقائد والإلهيات إشارة إلى منهج الالتزام بالنصوص القرآنية المتضمنة لأمور العقيدة، وهى نصوص تنفى عن الخالق سبحانه مشابهة مخلوقاته ولا يتكلف أصحابها تكلف الفلاسفة الذى وصل بالبعض منهم إلى مقولات من التشبيه والتجسيد، أو الحلول، أو وحدة الوجود التي يندمج فيها الخالق بالمخلوق.. أما في مجال الشريعة والاجتهاد في استنباط أحكامها فإن ابن تيمية قد تحرر من المنهج الحرفي، وكانت له اجتهادات رائعة أوصله إليها بصره بالمقاصد القائمة وراء النصوص.. ولذلك عده مؤرخو الفقه من المجددين، بل عدوه شيخ المجددين.. وأصحاب هذا النظر الحرفي الضيق للنصوص القرآنية والنبوية يسيئون الظن بكل مذهب أو اجتهاد يدعو إلى التجديد واستخدام العقل في فهم النصوص وتفسيرها وتطبيق حكمها على الوقائع المتجددة بدعوى أن ذلك يفتح باب الحكم بالهوى.. ودعوى أن المؤمن الصالح متبع لا مبتدع.. وهذا كله لا حجة فيه، فالاتباع الذى أمرنا به إنما هو اتباع العقلاء المبصرين لا اتباع المقلدين المنقادين.. والابتداع الذى نهينا عنه هو أن ندخل في الدين ما ليس منه إضافة إليه أو حذفًا منه، أو قولاً فيه على الله بغير علم
ولا غنى لأحدٍ من المشتغلين بالخطاب الديني، والممارسين له، عن معرفة ما قرره علماء الأصول في كيفية رعاية هذه المصالح التي تتفاوت مراتبها ويحتاج الأمر إلى منهاج دقيق للتوفيق بينها عند تعارضها، ولتقديم الفقيه أو المفتي أو القاضي بعضها على بعض عند تزاحمها، فقد قرر علماء الأصول قواعد عديدة في هذا الشأن في مقدمتها القاعدة المعروفة من أن درء المفسدة، في موقف معين، مقدم على جلب المنفعة فيه ومنها أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. وأن مصلحة الكثرة تقدم على مصلحة القلة. وأن المصلحة الدائمة تقدم على المصلحة العارضة أو المؤقتة.
العنصر الرابع :
الغفلة عن ترتيب الأولويات ومراتب الواجبات الدينية
والواقع أن من أعقد المشاكل التي تواجه حركات التغيير الفكري والاجتماعي تحديد نقطة البداية في هذا التغيير وترتيب الأولويات في برامج الإصلاح وتتخذ هذه المشكلة طابعًا أشد تعقيدًا في خصوص الخطاب الديني، وفى إطار العمل الإسلامي حيث تتنازع هذا الترتيب اعتبارات مختلفة ومعايير عديدة، فهو ليس قائمًا على تقدير الأهم والمهم من حيث المصلحة الاجتماعية فحسب، وإنما يتداخل في تحديده عنصران إضافيان:
أولهما: ترتيب القيم في إطار التصور الاعتقادي الشامل الذى يقوم على الإسلام، وهو ترتيب قد لا يتطابق بالضرورة تمامًا مع الترتيب القائم على رعاية المصلحة الاجتماعية كما يراها الناس، أو كما تراها أكثريتهم العددية.
ثانيهما: ملاحظة درجة الثبوت، وقطعية المصدر الذى يستند إليه الحكم محل البحث، فما ثبت بدليل قطعي يكون عادة أوفر نصيبًا من الطلب والإلحاح في برامج الإصلاح، بينما تتراخى في الترتيب أمور أخرى إذا لم يحمل ثبوتها درجة اليقين التي تحملها نصوص أخرى ربما كانت تعالج أمورًا أقل أهمية أو أقل اتصالاً بالمصلحة الاجتماعية الظاهرة.
ويقول ابو المجد ـ مع ذلك ـ أن درجة ثبوت الدليل الجزئي لا يجوز أن تكون العنصر الأساسي الحاكم في تحديد مراتب الأعمال.. فقد يثبت دليل جزئي ثبوتًا قطعيا دون أن يؤثر ذلك على نوع الحكم التكليفي الذى يقرره ذلك الدليل، مما يتعين معه الرجوع إلى معيار موضوعي مستمد من مجموع النصوص لا من واحد منها فحسب.
العنصر الخامس:
الغفلة عن دور العقل وأهمية العلم في بناء التصور الإسلامي:
وهذه الغفلة تقع في ميدانين، أولهما: الميدان العام الذى يجعل للعقل الإنساني دورًا أساسيا إلى جانب دور النقل، أي النصوص القرآنية والنبوية.. وذلك في مقام فهم الطبيعة التي تحيط بنا، وسائر أمور المعاش التي يشترك فيها المسلمون مع غيرهم من سائر خلق الله أما الميدان الثاني، فهو ميدان الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال الناس، أفرادًا وجماعات. والواقع أن قضية دور العقل مع وجود النقل أي النصوص التي مصدرها الوحى الإلهي المنزل على الأنبياء والمرسلين قضية قديمة في الفكر الإنساني وفى تاريخ الأديان السماوية، فإن واهب العقل هو الموحى بـ "النقل" وأن الرواية في أمور الدين لا تكفى وحدها ولا تغنى أبدًا عن التعلم والفقه والدراية. وأن قضية العلم قد تراجعت مكانتها في عقول كثير من المتدينين وأنه إذا كانت آفة الدنيا من حولنا أن بعض الناس قد تصوروا أن العقل يستطيع ـ بغير النقل وهداية الوحى.ـ أن يهدى إلى الرشد، فإن آفتنا ـ نحن المسلمين ـ أننا عطلنا العقول وركنت عامتنا وخاصتنا إلى المنقول، فتوقف كثيرون عن إعمال العقول، وتوقف بعضهم عن السعي وإحسان العمل، واختلط التوكل بالتواكل، وامتزجت القناعة بالخمول، كما اختلطت العفة بالعجز، فتقدم الناس وتأخرنا، وتحركت الدنيا وتجمدنا.. ولا خير اليوم في خطاب ديني لا يتصدى لهذه الثغرة، ولا يعالج هذا الخلل.
العنصر السادس:
مداومة الحديث عن الماضي، والذهول عن الحاضر، والخوف من المستقبل:
إن استقراءً سريعًا للخطاب الديني السائد عندنا يكشف على الفور عن ظاهرة شديدة الغرابة تتمثل في أن الجانب الأكبر، والوحيد أحيانًا، في هذا الخطاب يتصل بالماضي ويكاد يقف بالسامعين والمشاهدين عند عصر النبوة وعصر الصحابة وقليل من التابعين.. حتى صار الإسلام في تصور العامة هو تاريخ هذه الحقبة وحدها، وسيرة الخلفاء الأربعة الراشدين، وقد يضاف إليهم الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز وتلك آفة بالغة الخطورة على جيلنا كله.. فقد التوت أعناق هذا الجيل وهو مشدود أبدًا إلى الوراء، منكفئ على الماضي، مشغول بالذات.. وحجتهم الحاضرة ـ ولا غناء فيها ـ أن من يقطع صلته بماضيه لا رجاء له في مستقبله، وتلك حجة داحضة، أو هي كلمة حق يراد بها باطل، فإن أحد من العقلاء الأتقياء لا يقول بقطع الصلة بالماضي ولا يتصور ـ من حقه ـ أن يعرض عن جملة التراث، أو أن يهون من قدسية النصوص التي نزل بها الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يغض من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عاشوا معه، وتلقوا منه الحكمة، وتأسوا بسيرته، وكانوا همزة الوصل بين عصره ومن جاء بعدهم... ولكن يبقى أن نذكر أمرين:
أولهما: أن الماضي ـ بكل ما فيه ـ ليس من صنعنا نحن، وأمجاده ماض نعتز به ولكن لا فضل لنا فيه.. ثم إن الماضي على امتداده ساحة هائلة اجتمع فيها الحق والباطل، والهدى والضلال وتصارع فيها العدل مع الظلم، والإسلام مع الكفر والنفاق.. ومن ثم فليس كل قديم نافعًا.. وليس كل ما مضى خيرًا نجتره ونلتزم به واهمين.
ثانيهما: أن الاستغراق في الماضي يشغل عن معالجة "الحاضر" واستشراف المستقبل والإعداد له والاحتفال بأمره.. ولست أدرى كيف ينسى بعض الخطباء والمتحدثين والمفتين أن يذهلوا عن السرعة الهائلة التي تتحرك بها العلوم والمعارف الإنسانية بأشكالها وصورها التي لم تكن تخطر على بال الأقدمين.. وكيف يستطيع هؤلاء أن يعزلوا عقولهم ووجدانهم ومعهم عقول المخاطبين والسامعين عن الإيقاع السريع لحركة الحياة من حولهم.
لقد آن الأوان لتكون النغمة الغالبة على الخطاب الديني المعاصر دعوة للجيل كله، يرفع بها أصابعه عن آذانه، ويزيل غشاوة الرتابة والجمود عن عيونه ويشحذ الهمة لعمل كبير، وجهاد طويل بخطو سريع يمد بها أبصاره إلى المستقبل، ويرتحل ـ ولو قليلاً ـ عن الماضي الذى حصر نفسه فيه، ووقع في أسره وهو يظن أنه يتقرب ـ بهذا كله إلى الله.
العنصر السابع علاقة المسلمين بالغير
"العلاقة بالآخر" تقع في نطاقين متميزين:
أولهما: النطاق الداخلي، أي خلاف المسلمين بعضهم مع بعض، والآخر: علاقة المسلمين مع غيرهم ممن لا يدينون بالإسلام، وينتسبون لعقائد وثقافات أخرى. فأما الأمر الأول: فيقتضى ملاحظة أن الفرد المسلم ليس وصيا على الفرد المسلم الآخر، وأن اختلاف الأفكار والمواقف العملية بين أفراد المسلمين، وتحت مظلة الدين الواحد الذى يدينون به، أمر وارد تمامًا، وهو ـ في النهاية ـ نافع لمجموع الأمة.. ولا يجوز أن تضيق به الصدور أو أن يكون سبيلاً للتفرقة والقطيعة وتبادل الاتهام، كما أنه لا يقتضى ـ أبدًا ـ أن يكون أحد أطرافه مؤمنًا، والآخر فاسقًا ومارقًا.. إذ الصواب والخطأ في الاجتهاد غير الاستقامة والخطيئة، والقرآن يذكرنا ـ وقلما نتذكر ـ بأن وحدة الأمة لا تحول دون وقوع الخلاف بين أفرادها، بل يظل المؤمنون ـ رغم خلافهم ـ "كالبنيان يشد بعضه بعضا".
وحتى إذا استفحل أمر الخلاف ووصل إلى حد الاقتتال المنهى عنه، فإن الفريقين المختلفين يظلان "إخوة" ويظلان "مؤمنين". "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله" (9ـ الحجرات) لذلك نلح في الرجاء على المشتغلين بالخطاب الإسلامي أن يراجعوا أنفسهم وأن يعيدوا التأمل في آيات الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرفوا ـ من جديد ـ كيف اعتبر الإسلام التنوع وتعدد الآراء واختلاف الثقافات نعمة تستوجب شكرها "بالتعارف" الذى يشير إليه قوله تعالي: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا"، (13ـ الحجرات) ثم ليقفزوا ـ بعد ذلك ـ قرونًا من الزمان ليسمعوا الإمام أباحنيفة وهو يقول: "علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلناه"، ثم ليسمعوا الإمام الشافعي وهو يقول: "رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب".. وليذكروا بعد ذلك أن الصحابة وهم حواريو النبي صلى الله عليه وسلم الذين لازموه وأخذوا منه الدين والعلم والعمل، قد اختلفوا فى أمور عديدة، وأن التابعين من بعدهم كانت بينهم خلافات في الرأي أكثر من اختلافات الصحابة..
وأن الأئمة أصحاب المدارس الفقهية الكبرى فى تاريخ التشريع الإسلامي.. كانت لهم أصولهم الفقهية، واجتهاداتهم الخاصة بهم فى فروع الفقه وفيما انتهوا إليه من رأى.. فما ذكر أحد منهم أحدًا بسوء.. فضلاً عن أن يتهمه فى خلق أو دين..
إن هذا السجل المشرف أثر من آثار البصر الدقيق بالأصول الاعتقادية الكبرى للإسلام وعثرة من عثرات الإيمان بأن الحكمة ليست حكرًا على أحد.. وإنما هي موزعة بين الأفراد، مبثوثة فيهم جميعًا.. وأن على طالبها أن يبحث عنها عند الآخرين ولو كان هؤلاء الآخرون غير داخلين في الإسلام بحدوده الجغرافية أو التاريخية.
أما غير المسلمين فقد علمنا القرآن الكريم أن نجادلهم بالتي هي أحسن "فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم" (34ـ فصلت) كما بين لنا أن العدل معهم، والبر بهم (والبر تقديم ما يجاوز حد العدل) هو أقوم السبيلين.. "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" (8 ـ الممتحنة) وحين يتصل الأمر باختلاف العقائد الدينية، فإن القاعدة الذهبية الكبرى التي لا يتصور ورود النسخ عليها أو تبديلها هي قوله تعالي: "لا إكراه في الدين وهى قاعدة بين القرآن مظهرها العملي بقوله تعالى على لسان المؤمنين: "قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون" (25ـ سبأ). كما تردد صداها في آيات أخرى عديدة: يقول تعالى لنبيه: "أفأنت تكره النــاس حتـى يكـونـوا مؤمـنـيـن"(99ـ يونس) ويقول له: "فذكّر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر". (21:22ـ الغاشية).
ويبدو أن الإحساس المرير بالتراجع السياسي والاقتصادي والعسكري للشعوب الإسلامية المعاصرة قد دفع كثيرًا من الدعاة إلى التورط في تحريض المسلمين على مخاصمة الدنيا كلها، والدخول مع الناس "الآخرين" في معركة مواجهة ورغبة في الاستبعاد والإقصاء.. ولازلت أذكر ـ في دهشة يمازجها الأسف الشديد، خطيبًا أديت خلفه صلاة الجمعة منذ عشرين سنة، ختم خطبته بدعاء على "الكافرين" أن يحصيهم الله تعالى عددًا، وأن يهلكهم بددًا، ويجعلهم وأموالهم غنائم للمسلمين.. ثم بدا له أن يفصل اللعنة التي صبها عليهم مستعرضًا علمه بأسماء بعض البلاد، فأخذ يذكرهم بجنسياتهم وأقطارهم، حتى لم يترك بلدًا من البلاد الأوروبية إلا وقد أدخله باسمه في "لعنته" العامة التي ختم بها خطبته.
إن هذا كله انحراف صارخ عن جادة الإسلام الصحيح ومخالفة واضحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأدبه في الدعوة إلى الله.