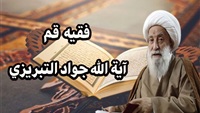ما بعد مفهوم النص.. القرآن من النص إلى الخطاب
السبت 15/أكتوبر/2016 - 10:06 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
عقد تحت هذا العنوان المؤتمر الثاني لمؤسسة الدكتور نصر حامد أبو زيد للدراسات الإسلامية يومي 14، 15 أكتوبر الجاري، وقد شارك باحثون من مصر والجزائر وبولندا بأوراقهم البحثية التي قدموا فيها رؤيتهم وقراءتهم الخاصة للكتاب المحوري في الثقافة الإسلامية "القرآن الكريم"، مقدمين مفهومهم للنص والخطاب من خلال آليات ومناهج البحث الحديثة خصوصا مناهج البحث في علوم اللغة واللسانيات والسيميوطيقا وغيرها من المناهج التي تساعد الباحثين على تقديم تأويلات جديدة للنصوص الدينية.

ومن بين الاوراق البحثية المهمة التي تم تقديمها في هذا المؤتمر تلك الورقة البحثية للباحث المصري "اشرف البولاقي" والتي كان عنوانها "قراءة في آليات الانتقال من النص إلى الخطاب" حيث جاء فيها "في كتابه (مفهوم النص) 1993 هل كان د. نصر حامد أبو زيد يكرِّس للقرآن على أنه (نص)؟ وهل كانت فكرة (الخطاب) غائبة عنه؟ انفجر هذان السؤالان في رأسي فاضطررتُ لقراءة الكتاب مجددًا لأكتشف أن د. نصر انطلق من الفكرة المحورية في الثقافة العربية في تعاملها مع القرآن، بغض النظر هنا عن إيمانه هو بها، واكتشفتُ أنه من الظلم الزعم أن فكرة التعامل مع القرآن كـ (خطاب) كانت غائبة، يمكن القول إنها كانت مضَمرة أو مستتِرة .. لكنها كانت تنضج وتنمو في ذهنه وذاكرته، كان المفكر الراحل مشغولا بتبيان آثار التعامل مع القرآن باعتباره (نصًا)، كما كان مشغولا أكثر بالتركيز على المنهج، ولعل الباب الأول في (مفهوم النص) كان أكثر الأبواب سيطرة على مشروعه في الكتاب، باب (النص في الثقافة – التشكل والتشكيل -)، ثم راح في باقي الأبواب والفصول يَستعرض علومَ القرآن عِلمًا عِلمًا ليبيّن حجم المآزق والإشكاليات التي تعرض لها القرآن باستسلام الثقافة العربية والإسلامية لنتائج فكرة (النص) .. ويمكن لنا أن نشير هنا في عجالة إلى أن مفردة (النص) مفردة حديثة ظهرت في القرن التاسع عشر تقريبا كحقل معرفي من حقول علم اللغة، ولم ترِد عند القدماء من مفسرين أو نقاد أو بلاغيين في أي من كتبهم، وإنْ وردت مشتقاتها في أبيات شعرية عند بعض الشعراء كانت تشير فقط إلى معناها المعجمي كقول امريء القيس مثلا:
وجيدٍ كَجِيدِ الرئْمِ ليس بِفاحِشٍ .. إذا هي نَصَّتهُ ولا بِمُعَطَّلِ
وإذا تتبعنا كتابات علماء العربية القدماء سواءٌ أكانوا فقهاء أو متكلمين أو مفسرين أو بلاغيين فسنجدها داخلة أو تنتظمها عندهم سياقات متعددة في الجملة تارة، أو النظم تارة، أو في تقسيم الكلام تارات أخر .. إلى أن ظهرت كمفهوم مستقل معرف بالألف واللام في كتاب (التعريفات) للجرجاني، حيث يقول " النص ما ازداد وضوحًا على المعنى الظاهر لمعنى في نفس المتكّلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى كما يقال أحسِنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي كان نصًا في بيان محبته,وأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا وقيل ما لا يحتمل التأويل"( (ت 816 هـ تقريبا).
ولعل أشهر ورودها كان المبدأ الفقهي لا اجتهاد مع النص، والذي يبدو سيفا مصلتا في وجه أي محاولة فهم أو تأويل .
ولعلها لم تختلف كثيرًا بعد تعريفات الجرجاني في كتابات مَن جاؤوا بعده، خاصة السيوطي (ت 911 هـ تقريبا) إلى أن أشرق القرن التاسع عشر بانفجار علوم اللغة واللسانيات حتى اتخذ مفهوم وتحليل النص مكانه ليحتل الصدارة في كتابات عدد كبير من المستشرقين ومن المثقفين والأكاديميين العرب.
حتى ظهر كتاب (مفهوم النص) – المشار إليه - للدكتور نصر حامد أبو زيد بمنهجه ومادته ونتائجه ليصبح الكتاب علامة على المفهوم، وليتحول الكتاب إلى أيقونة كتابات مؤلفِه بعد الضجة التي أثارها – وما يزال – في كل الأوساط السياسية والدينية والثقافية والأكاديمية أيضًا. والمتتبِع لكتابات د. نصر لن يحتاج إلى كبير عناء ليدرك أنه انتقل انتقالةً كبيرة وواسعة من (النص) إلى (الخطاب)، الأمرُ الذي أعلنه وصرّح به أكثر من مرةٍ في أبحاثه وكتاباته، وقدّم للمكتبة العربية جهدَه في ذلك .. وها هو نفسه يقول في بحثه المعنوّن بـ " مقاربة جديدة للقرآن: من النص إلى الخطاب نحو تأويلية إنسانوية " وهو البحث الذي كان في الأصل محاضرة اعتلائه كرسي ابن رشد للإسلام والهيومانيزم بهولندا : " أريد في البداية تأكيد أن مجال التجديد الفكري يمثل أفقا مفتوحا للباحث، يستطيع فيه مراجعة نفسه. ولأني سأنتقل هنا نقلة ليست يسيرة في التعامل مع القرآن لا بوصفه نصا – كما هو الأمر في كتابي " مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن" بل بوصفه خطابا"
ففي الفصل الأول - من الاب الأول - وعنوانه " مفهوم الوحي" من كتاب (مفهوم النص) وفي الفقرة المعنونة بـ " اتصال البشر بالجن" يظهر مستوى من مستويات (الخطاب) لا (النص) عندما يتعرض د. نصر لتحليل سورة (الجن) ص 29 من كتابه، عندما يلاحظ النص وهو يصوغ الواقع بطريقة بنائية خاصة تعيد تركيبه في نسق جديد، عندما يشير إلى التداخل الدلالي في استخدام الضمائر في السورة حيث يشر ضمير المتكلمين في السورة كلها إلى الجن، (وأنا – ظننا) وفجأة (وأنهم ظنوا كما ظننتم) فضلا عن فعل المخاطَب (قل) إلى آخر ما أشار إليه. وتعدد الأصوات مستوىً مِن مستويات (الخطاب) الأمر الذي يؤكد أن مفهوم (الخطاب) لم يكن غائبا عن ذهن الباحث حتى وهو يتناول مفهوم النص .. لكنه احتاج سنواتٍ طويلة في جدٍ وبحثٍ لينتقل من (النص) إلى الخطاب.

كما تناول الباحث المصري حسام الحداد في ورقته البحثية والتي كانت بعنوان "من النص إلى الخطاب.. نصر حامد أبو زيد نموذجا" تطور نصر حامد أبو زيد في رؤيته للقرآن من كونه نصا الى كونه خطاب حيث جاء في ورقته "إن مفهوم الخطاب يعد من المفاهيم الحديثة والجديدة في مجال الدراسات اللسانية وبالأحرى الدينية، فلقد تسرب هذا المفهوم إلى منظومة الفكر الإسلامي وتم تداوله دون ضبط عميق له، بل إن تداوله تجاوز العادة في الفكر الإسلامي الحديث، ونعني بها التأصيل "بأثر رجعي بالتراث الإسلامي، على الرغم من أن في التأصيل ممارسة فكرية خطيرة وبالغة الضرر على الفكر الإسلامي نفسه، إلا أن هذه العادة لم تمارس فيما يخص هذا المصطلح الذي أصبح مفتتح في الكتابات الإسلامية، وأنه لمن الضروري أن تتم دراسة هذا المصطلح وفهمه من مصادره الأصلية الغربية.
ولأن الخطاب دومًا يمثل فعلاً اجتماعيًا لا يمكن فهمه بمعزل عن تأثيره وتداخله في العلاقات الاجتماعية في الفاعلين. وأن ارتباطه بالنسق الاجتماعي يحيلنا إلى موضوع السلطة ورؤية العالم، يكون الخطاب بهذا المعنى يكمن في عدة نصوص على أن يكون الربط بينها أنها جميعًا صادرة من جهة واحدة (حقيقية أو اعتبارية) وموجهة لجهة واحدة محددة (حقيقية أو اعتبارية) وعندما تقول "جهة" فإننا نعني أن المخاطب أو المخاطب يمكن أن يكون شخصًا، ويمكن أن يكون جهة اعتبارية (مثل المؤسسة أو غير ذلك) ومن خلال هذا المنطلق سوف يقوم الباحث بتتبع مشوار نصر حامد أبو زيد من انطلاقه في دراسة القرآن كـ"نص" إلى أن تناول القرآن الكريم كخطاب أو عدة خطابات لمجموعة من المخاطبين (النبي، المؤمنون، المشركون، أهل الكتاب، الصائبين.. الخ
ويؤكد الحداد على انه عادة ما يقصد بالنص اللغوي بأنه كلام مكتوب، أو خطاب مدوّن. ويقصد بالخطاب بأنه قول مشافه، كالذي عليه الألسنيات الحديثة، وكما يقول بول ريكور: إن النص خطاب أثبتته الكتابة، أو أن النص مؤسس بواسطة تثبيت الكتابة. وبحسب هذا المعنى يكون الخطاب سابقاً للنص من الناحية الإنثروبية. واستناداً إلى هذين المعنيين فإن النص هو نوع من الخطاب الموجّه، وأن الخطاب هو نوع من النص الموجّه أيضاً، لكن التوجيه لديهما مختلف في الغالب، فالجهة التي يستهدفها الخطاب جهة اجتماعية حاضرة ومشخصة ولها حدود، مما يجعل العلاقة بين المخاطِب والمخاطَب علاقة تواصلية حيث التفاعل والجدل والتعاطي المتبادل، وبالتالي فإنها تعبّر عن المعنى الاجتماعي بحكم هذا التفاعل المباشر. في حين أن النص يستهدف جهة انسانية لا تتصف بالحضور المباشر والتشخيص ولا بالحدود، وهي بالتالي جهة مجهولة، مما يجعل العلاقة بين الكاتب والقارئ علاقة انفصالية نيابية غير تواصلية، أي على خلاف الحالة التي يتصف بها الخطاب. فما موجود هو الأثر المكتوب المعبّر عنه بالنص، أما صاحبه فقد غاب وانتهى. فعلاقة القارئ المباشرة إنما هي مع النص دون الكاتب، وهي قائمة على التلقي دون التفاعل والجدل، أي خلاف ما يجري في حالة الخطاب
ومن حيث التكوين النفسي أو الذاتي فإن الخطاب هو أصل للنص وسابق عليه، لأن كل أثر مكتوب لا بد من ان يكون نتاج قول أو كلام، وهو ما نعبّر عنه بلغة الأشاعرة بالكلام النفسي. فمن حيث التكوين الذاتي يكون الفكر سابقاً للكلام، والكلام سابقاً للنص، خلافاً لأدبيات ما بعد الحداثة كما تتمثل في اتجاه جاك دريدا. أو لنقل إن الفكر هو علة الخطاب، والخطاب علة النص أو الأثر المكتوب. ويؤيد هذا المعنى ما يراه عالم النفس التكويني بياجيه من ان البناء المعرفي لدى الطفل سابق على اللغة كما في الحس الحركي، فالتنسيق الذي يعتمده الطفل في مستوى الفعل يشكل قاعدة تتأسس عليها البنيات المنطقية لاحقاً، وبالتالي فان الجذور المنطقية للتفكير تتقدم على اللغة زماناً."

وجاءت الورقة البحثية المقدمة من الدكتورة ابتهال يونس بعنوان "صوت الانسان في الخطاب الإلهي" والتي جاء فيها "انطلاقا من مفهوم القرآن كخطاب أو عدة خطابات، يدور هذا البحث حول صوت الإنسان في الخطاب الإلهي حيث ينقسم صوت الإنسان إلى اربعة أنواع داخل القرآن الكريم.
النوع الأول يظهر فيه صوت الإنسان من خلال الحوار المباشر مع الله حيث نجد صوت ابراهيم وموسى وعيسى على سبيل المثال.
النوع الثاني هو صوت الإنسان في السرد من خلال القصص القرآني حيث نجد اصوات الشخصيات التي تدور حولها القصص مثل يوسف وفرعون وذو القرنين على سبيل المثال.
النوع الثالث هو صوت الإنسان الذي يلي الأمر الإلهي "قل"، ما يمكن اعتباره صوت النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
النوع الرابع هو ما يمكن ان نسميه الدعاء والصلوات والابتهالات المتضمنة داخل آيات القرآن ويمكن اعتباره صوت البشرية بصفة عامة دون شخصنة. وهو ما نجده في الفاتحة وأخر سورة البقرة على سبيل المثال.
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل ماهية ووظيفة هذه الانواع الاربعة من صوت الإنسان داخل الخطاب الإلهي المتجلي في القرآن الكريم.

أما ورقة الباحث الشريف منجود والتي كان عنوانها "القرآن بين صنمية التراث ونقدية العقل" جاء فيها "يمثل المصطلح جزء أصيل في مشكلة البحث ومنهجه كونه العتبة الأولى التي يمر من خلالها الباحث لإجراء مبحثه خاصة في العلوم الانسانية لما يكثر فيها من إشكاليات أساسها تعدد الرؤى والتناول، لذا قبل الدخول إلى موضوع الدراسة فإننا نحاول تحديد أهم المصطلحات التي قامب استخدامها نصر حامد أبو زيد، موضوع دراستنا، والمفاهيم التي ارتاح إليها واتخذها نقطة انطلاق، وهذا يساعدنا في إبراز النتائج المرجوه من تلك الدراسة.
تتقدم مصطلحات (النص – الخطاب – التأويل – التجديد) قائمة المصطلحات التي يستخدمها بعض الباحثين المعاصرين لقراءة القرآن أيما كانت مناهجهم وتناولهم، وهو ما يمكن إيضاحه، فالدلالة اللغوية لكل مصطلح على حدا هي أساس النمط الثقافي اللغوي؛ "لأن اللغة تمثل النظام المركزي الدال في بنية الثقافة بشكل عام".
وقال الشريف منجود أن لمصطلح النص عدة مدلولات منها المعاصر الذي اشتملت عليه الدراسات الحديثة في علوم اللغة، ومنها التاريخي المعجمي ذو الدلالة الأساسية وهي الظهور والانكشاف ولا تزال بارزة في الاستخدام اللغوي المعاصر، وقد أدرج أبوزيد في دراسة بعنوان "النص والتأويل في اللغة والثقافة" تلك المدلولات مستعرضا أهمها بداية من – الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية في المعجم العربي مستخلصا "أن الدلالة المركزية انتقلت من الحسي إلى المعنوي ودخلت في الاصطلاحي دون أن يعتورها تغيير كبير وذلك ظلت تتداول بهذه الدلالة في مجال العلوم الدينية".
وأضاف "لم يكن استخدام مصطلح الخطاب عند أبوزيد متعلقا في مباحثه حول القرآن ذلك الكتاب، بالمعنى الخاص الموحى به ن الله، إذ أن استخدام مصطلح الخطاب لديه منصب في أبحاثه العديدة حول الخطاب الديني المعاصر، بمعناه الأيديولوجي الناسوتي الذي بين الإنسان والإنسان، ولعله انشغل بذلك كثير لإيجاد طريق يدحض به الخطاب الديني الأصولي المتغلغل في مجتمعاتنا العربية والإسلامية بلا أدنى شك منذ زمن بعيد، فربما كانت هي إحدى أهدافه الأساسية لمشروعه الفري الذي بدأه منذ أطروحاته الأكاديمية ومرورا بالمقالات والسجالات والنقاشات التي تؤكد اهتمامه الأول بالشارع كأحد أعمدة فك الحصار الفكري على المجتمع، حتى أصابته المحنة وهي نتاج تلك الأطروحات الثورية على الخطاب الأصولي المعاصر، الذي أسس له في نقد الخطاب الديني والإمام الشافعي والتفكير في زمن التكفير وسوى ذلك من مباحث ومقالات توصلنا بمرمى أبوزيد الثوري، وهو النقاش والخروج من دائرة الصراع إلى اعتبار الاسلام دين علماني لو أحسنا الفهم والتدبر: تدبر النصوص والتاريخ والواقع في الوقت ذاته. حتى أن تناوله النص / القرآن كان أساسه محاورة الخطاب الديني الأصولي المسيطر، والكشف عن ألاعيبهم التي يتحكمون من خلالها بعقول البسطاء، وطرح كثير من هذه الامور في مبحثه (مفهوم النص) وما تلى ذلك، إذ يطلب الرجوع والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا، حتى لا يجرفنا الطوفان.

أما ورقة الباحث حمدي الشريف فقد جاءت تحت عنوان " القرآن بين النص والخطاب في رؤية محمود طه ونصر ابو زيد" ويقول الباحث تقتضي دراسة القرآن والحديث عن فعل التجديد، التمييز بين مفاهيم عديدة، من بينها التمييز بين "النص" و"الخطاب" القرآني، بين الدين والفكر الديني، بين تجديد الدين وتجديد الخطاب الديني، بين الكلام عن التجديد وممارسة التجديد. فلا معنى للحديث عن تجديد الدين فهو ما أتمّه الله وأكمله ولا نقصان فيه ولا انحراف ولا تقصير. لكن باب الاجتهاد في تناول الخطاب الديني (وهو كل ما يحيط بالنّص القرآني وصحيح السنة من تفاسير وشروحات ومساجلات وخطب ومواعظ ومؤلّفات وغير ذلك) مفتوح. يقودنا هذا إلى ضرورة التمييز بين النّص والخطاب. على سبيل التبسيط، القرآن الكريم الذي نقرأه ونسمعه ونتعبّد به هو النّص. أمّا الخطاب فهو كل ما يحيط بهذا النص الإلهي من ظروف تنزيله وتلقّيه وتفسيره وتناوله وتطبيقه. الكلام عن عيوب أو ثقوب في النص الإلهي الخاتم هو من قبيل الشطح والتشدق وانحراف العقل لكن لا تثريب على الكلام في أمور التفسير والتأويل والتطبيق. من جهة أخرى لا تثريب على كل من "يتكلم" في ضرورة التجديد وأسبابه ودوافعه وثماره إلى غير ذلك، أما "ممارسة" التجديد فينبغي أن تبقى قاصرة على من يملكون أدواته – من علم عميق باللغة العربية وتاريخها وتطورها وتغيُّر دلالاتها وعلم بأسباب النزول والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من أدوات قراءة النص القرآني وتفسيره واستخلاص المبادئ والأحكام والفتاوى منه.
ويُعَدُّ المفكر السوداني "محمود محمد طه" (1909 – 1985) وكذلك المفكر المصري "نصر حامد أبو زيد" (1943- 2010) من أبرز رواد تجديد الخطاط الديني في الإسلام، وبين الاثنين أكثر من وشيجة معرفية وفكرية في دراستهما للقرآن كنص والقرآن كخطاب. وتقارب هذه الدراسة بين مفهومي "النص" و"الخطاب" عند "محمود طه" و"نصر أبو زيد"، وتركز بوجه خاص على مفهوم الخطاب القرآني عند كل منهما.

وقدم الباحث سعد محمد صبري ورقة بعنوان "القرآن الكريم بين الشفهية والتدوين.. دراسة في ضوء اللسانيات الحديثة" جاء فيها "
"تحول النص من المُشافهة إلى التدوين من التغيُّرات التاريخية في شكل الرسالة النصية التي تمثل إشكالية من الإشكالات المتعلقة بعملية التلقي؛ إذ إن البنية النصية في صورتها الشفاهية الحية ليست كما هي تمامًا في حالتها الكتابية؛ لأن كثيرًا من عناصر سيميولوجيا الخطاب الشفاهي التي تمثل السياق التداولي للخطاب، كالإشارات الجسدية للمتكلم وتعبيرات وجهه، وكذلك كل ما يمارسه على الصوت اللغوي من عمليات فونولوجية كالنبر، والتغيم، ومط الصوت، والفصل والوصل ...إلخ، لا تظهر في حالة التدوين، إلا إذا حاول المدونون إظهارها باستخدام بعض آليات الكتابة، كعلامات الترقيم، والتعليقات التي تصف الهيئة الجسدية للمتكلم، وتعبيرات وجهه، وطريقة نطقه للأصوات.
ومن المعروف أن تلك العناصر المُصاحبة لعملية التلفظ تشاركُ الألفاظ في إنتاج البنية الدلالية للخطاب، فكلُّ إشارة أو علامة تشير إلى مدلولات في النسق الثقافي الذي في إطاره تتم عمليات التواصل بين المتكلم والمتلقي، فالإشارات أو العلامات أو الرموز في إطار علم السيميولوجيا تُعد أدلة على معان أو دوالاً على مدلولوات داخل هذا النسق أو ذلك النظام المتعارف عليه.
ومن سمات العلامات الدالة أو الإشارة أنها تكون مصاحبة للألفاظ، فالمتلكم يستخدمها ملازمة لكلامه؛ لأنها تساعده على التعبير عن أفكاره ومشاعره، ومن غير الطبيعي سواء للمتكلم أو للمخاطب أن يعبر المتكلم عن قصوده مرسل اليدين، شاخص الرأس والعينين.

وقدم الباحث الجزائري سعيد تومي ورقة بحثية بعنوان "التاريخانية في مفهوم نصر حامد أبوزيد من خلال كتابه "مفهوم النص" والتي جاء فيها "اكتسب مصطلح التاريخية المشروعية العلمية، وأسس لنفسه أدوات البحث وآلياته، فصدرت الكثير من الكتب والمؤلفات التي خصصت له، مثل: (تاريخية الفكر العربي الإسلامي) لمحمد أركون، و(تاريخية الدعوة المحمدية) لهشام جعيط .. وغيرهما وتحولت الفكرة إلى مثار للجدل في الأوساط الفكرية الإسلامية، بين مدافع عنها ومعارض لها، فراهن عليه الكثيرون كخيار هام لفهم النّص الديني وخصوصًا القرآن الكريم فهما حداثيًا يتماشى وروح العصر، بينما لم يخف كتاب آخرون وهم الأصولوين أو السلفيون كما ينعتون أنفسهم رفضهم لهذه الفكرة بل وصل بهم الأمر كما يرى الجابري إلى: "تحرجهم من استعمال عبارة "أسباب النزول" مع أنّها عبارة إسلامية أصيلة، خوفاً من أن يفهم لفظ "الأسباب" بالمعنى الفلسفي الذي يجعل اسبب علة في وجود المسبب، بينما هو عندهم وعند الأشاعرة عموماً مجرّد مناسبة".
فبناء على هذا الاختلاف في الرؤية انتظمت إشكالية هذه الدراسة التي تسعى جاهدة إلى متابعة مفهوم هذا المصطلح في الحقل المعرفي العربي الإسلامي المعاصر من خلال جهود الدكتور نصر حامد أبوزيد في اشتغاله على النص القرآني. فما هي الدلالات الجوهرية التي يحيل إليها مفهوم التاريخية عند هذا الباحث؟ هل للمرجعية الغربية أثر في توظيف وتوجيه المصطلح في تطبيقاته على النص القرآني؟ أي أنها تراعي الفرق الأنطولوجي بين النص القرآني والنصوص الأدبية البشرية؟ كيف نفهم النص ونؤوله في سياقه التاريخي من المنظور الزيدي؟ وما هي الآليات التي يتوسلها الباحث للوصول إلى الهدف؟"
بينما كان عنوان الورقة البحثية التي قدمها الباحث عبد الرحمن ابو المجد هل القرآن خطاب سامي؟! دراسة في أعمال ميشيل كوبيرس أنموذجًا" والتي جاء فيها "افترض علماء اللغويات أن اللغة الساميّة (Proto-Semitic) الأم كانت موجودة في حقبة الألفية الرابعة ق.م في نفس الفترة التي يفترض وجود اللغة الهندي – أوروبية الأم فيها أيضًا واللغات السامية تسمىة حديثة نسبيًا أطلق هذا الاسم عالم اللاهوت لوتسر (Schlozer) سنة 1781م في أبحاثه وتحقيقاته في تاريخ الأمم البعيدة لتكون عَلمًا على عدد من الشعوب وشاعت هذه التسمية وأصبحت علمًا لهذه المجموعة من الشعوب عند عدد كبير من العلماء على الرغم من أن هذه التسمية لا تستند إلى واقع تاريخي أو إلى أسس علمية عرقية متفق عليها أو وجهة نظر لغوية مدَعمة بنظريات لغوية تقوم عليها.
اختلف علماء الساميّات حول الموطن الأصلي للغة الساميّة وأشهر الىراء في هذا الباب هي الخمسة التالية: أرض أرمينية وكردستان وأرض بابل في العراق أي جنوب العراق وأرض افريقيا وشمال سورية (بلاد آمورو) كما كانت تسمى في النقوش القديمة وجزيرة العرب.

كما قدم الدكتور هاني المرعشلي ورقة بعنوان "تضاريس قارة عقلية (2) رحلة السندباد الأخيرة الجنان والوجدان في بحار القرآن" والتي سرد فيها محطات الدكتور نصر حامد ابو زيد الفكرية وقد قال " بوفاته، توقف عقل نصر أبو زيد عن الغوص في أعماق بحار القرآن، ليخرج لنا في كل حين لؤلؤة أو أكثر من الضياء..
فماذا كانت آخر لؤلؤة قدمها لنا، والتي تشكل رؤيته الأخيرة؟
هل جاءت تلك الرؤية مستقلة، أم كانت واحدة في حلقات التطور الكشفي لبحث نصر أبوزيد؟
هل جاء القرآن محطة في وسط هذا المحيط اللجي الذي مثله فكر نصر أبوزيد، أم أن القرآن كان هو البحر الذي سبح فيه نصر منذ البداية؟ هذا ما نحاول الكشف عنه.

وتناولت ورقة الدكتور وليد الخشاب "الإسكندر وقارون في القرآن: خطاب الإسلام وتاريخ العالم" والتي جاء فيها ننحي جانباً السجال حول هوية كل من ذي القرنين وقارون في القرآن ونعتمد على مقدمة تعتبر أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني نفسه وأن قصة قارون – رغم كونه في القرآن من بني إسرائيل – تشبه قصة الشخصية الإغريقة المعروفة باسم قرزوس أو كريزوس.
في المصحف العثماني، على الحال التي وصلتنا، تتميز قصة الإسكندر الأكبر بكونها من نوادر المأثورات الإغريقية بالقرآن. ونفترض أن استرجاع تاريخانية قصة الإسكندر وإغريقيتها يعزز مفهوم النص القرآني المفتوح على ثقافات مغايرة لكل من الشائع في الجزيرة العربية في القرن السابع وللوارد من "الشقيقة الكبرى" فارس. كذلك نفترض أن تشابه قصتي قارون وقرزوس تعزز فكرة التوافق بين الموروث السردي القرآني وموروثات سردية غير عربية / سامية، كما في مثال قصة الثري الذي غرق قصره وكنزه بعد أن فشل في مقاربة ثروته مقاربة أخلاقية، هو خط مشترك بين قصتي قارون وقرزوس.
بالتالي، يسهم هذا المفهوم للنص القرآني بوصفه نصًا مفتوحاً في نقد فرضية العروبة الخالصة. ويطرح فرضية العروبة بوصفها استيعابًا لمفردات محلية وأخرى واردة، أو بوصفها صعيداً تتقاطع معه خطوط سردية وخطابية غير عربية، تتولى العروبة صهرها جميعاً في خطاب واحد.
تعضد فرضيتنا الأطروحة التالية:
أن فاعلية القرآن في إطار الخطاب التأسيسي لما صار يُعرف بـ"الإسلام" – فيما بعد عصر النبوة – هو عملية معرفية وبلاغية في آن، تستولد قصص الأمم الخالية لتدرج الحضارة الإسلامية الناشئة في سياق حكاية طويلة، تمتد من زمن "أساطير الأولين"، مروراً بأخبار الأمم السابقة، وصولاً إلى زمن الوحي والبعثة. بذلك، تتولى هذه العملية منح الحضارة الوليدة شرعية التاريخ القديم، وتجعل من الجزيرة العربية مربعاً ضمن لوحة حضارات العالم وحقلاً ثقافياً يتمثل رموزاً حضارية "كوكبية" وتاريخاً للعالم ككل.