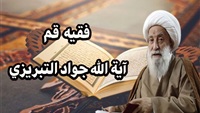ظلال الساحل السوري على المشهد العراقي. ...إخطار التكرار
الإثنين 17/مارس/2025 - 01:11 م
طباعة
 روبير الفارس
روبير الفارس
هل ما حدث في سوريا من قتال طائفي ومذهبي مازال ينزف قابل للتكرار في العراق .
في هذا التقرير نرصد وجهات نظر قلقة
في البداية قال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم مجموعات تعريفات أساسية
الوطن، هو مساحة من الارض محددة، تسمى البلد Country، ننتمي اليه ونحمل اسمه ونعيش فيه.
الوطن، يحتضن جميع بناته وابنائه على حدٍّ سواء. يحترم تنوع الأعراق والأديان والطوائف، الذي يُشكِّل بالنسبة لنا النسيج العراقي المتعدد الألوان على مرِّ القرون. المواطنون ليسوا نمطاً واحداً جامداً، لكنهم متنوعون، لذا ينبغي الاعتراف بحقهم في الاختلاف، ومساعدتهم على إدارة علاقاتهم ليعيشوا بكرامة وحرية وتناغم ومساواة. الشراكة والاخوة والتضامن توفر لهم السلم المجتمعي، والإستقرار والطمأنينة.
وقال البطريرك
الدولة، كيان معنوي لا دين لها، الدينُ للأفراد. اليوم لا يمكن قبول حكم مسيحي أو إسلامي أو يهودي إحتراماً لواقع التنوع والتعددية، كما هو الحال في الغرب بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر (1789 – 1799)، حيث فصلت الكنيسة عن الدولة ليتفرغ الدين لرسالته الروحيّة السامية وعدم السماح لاستغلاله وتشويهه كما حصل في تاريخ الأديان!
على الدولة ان تكون حيادية، وان تفصل الدين عن الدولة اسوة بالدول المتطورة، حتى يشعر الكل انهم في بيتهم، يتمتعون بنفس الامتيازات والواجبات. الدولة تقوم على الفرد، وليس على الغالبية والأقلية ولا على المكونات!
وعن المواطنة، Citizenship، قال تشير الى انتماء الفرد الى بلده والشعور بعضويته فيه وحمل جنسيته، والتمتع بكامل الحقوق والامتيازات التي تكفلها الدولة له، والواجبات التي يتعيّن عليه الالتزام بها بدقة. ينبغي تطبيق مفهوم المواطنة لانها توحد الجميع وتشجع التعاون، وهي واقعيًّا مستقبل البلد وتطوره.
المواطنة، مجموعة من القواسم المشتركة، والقيم والأخلاق تتمثل بحبّ الوطن والتمسك بالهوية الوطنية الشاملة، والاخلاص والأمانة والنزاهة، والمروءة للدفاع عنه وحمايته والسعي لتطويره. هذه القيَم مردودُها سيكون كبيراً على البلاد والعباد.
واضاف ساكو
من المؤسف ان العديد من الأشخاص يحملون جنسية وطنهم، لكن ولاءهم ليس له، ويتدحثون باسم الدين المسلم او المسيحي، لكن لا يلتزمون باخلاق الدين الحميدة، انما يبحثون عن مصالح خاصة لا علاقة لها بمصلحة الوطن، ويخالفون مقتضيات المواطنة الصالحة التي هي أساس التغيير والتقدم نحو الأفضل.
الدستور، Constitution التأسيس، لا حلَّ الا بدولة ديمقراطية، وبدستور مدني متقدم كما في البلدان المتطورة، يقوم على الأسس الوطنية والثوابت الإنسانية، يخدم الصالح العام. لا ينبغي ان يكرّس التمييز الديني والمذهبي والعرقي الذي يناقض مبدأ الديمقراطية والمواطنة الكاملة. كيف يمكن لبلد متعدد الأعراق والأديان والطوائف ان يتبنى دستوراً يكون فيه الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، أي من المذاهب الفقهية الاربعة؟ تبَنّي كذا موضوع شديد الحساسية، يجعل القوانين الأخرى رهينة بالتفسير الديني، وتدخل في الحريات الشخصية وقوانين الأحوال الشخصية. المسؤول في الدولة هو في خدمة الجميع من دون إستثناء، لان السلطة خدمة إنسانية ووطنية وأخلاقية، بعيداً عن العقلية السلطوية الفردية والفئوية المتطرفة!
الدستور، ينبغي ان يكفل الحرية والكرامة والمساواة لجميع المواطنين، وحق المشاركة في إدارة الدولة والعملية السياسة. لنتعلم من الدول الغربية كيف يُسمح للمهاجرين المتجنسين تبوأ مناصب كرئيس الوزراء ووزارة .. الخ. وكذلك على الدستور ان يكفل حقوق المرأة والطفل، وحرية الرأي والتعبير.
للأسف أن الواقع على الأرض مختلف، بسبب الطائفية والمحاصصة، والفساد وترديّ الخدمات. لذلك هاجر العديد من العراقيين الى الغرب ومن ضمنهم أصحاب الكفاءات، والمسيحيون الذين هم جزء أصيل من هذه الأرض منذ آلاف السنين. لقد عانوا كثيراً من الإرهاب والتهميش والإقصاء، بحيث هاجر الثلثان.
واستطرد البطريرك قائلا
بعد خبرة أكثر من عشرين سنة لسقوط النظام، أجد ان الوقت قد حان لتنظيم طاولة حوار حضاريّ راقٍ، تضم أصحاب الكفاءات العلمية والقانونية، يفقهون آليات السياسة والقانون الدولي لمراجعة الدستور الحالي وإصلاح بعض الثغرات وتعديل بعض المواد ليعكس الواقع الحالي المتنوع، لا سيما ان للعراق حضارة وثروة ثقافية كبيرة يمكن الاستناد اليها. من الأهمية بمكان حماية هذه المبادئ الحيوية والاخلاقية، والإلتزام بها نُصرةً للعراق والعراقيين.
هذا ما يطالب به غالبية المواطنين
في البداية قال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم مجموعات تعريفات أساسية
الوطن، هو مساحة من الارض محددة، تسمى البلد Country، ننتمي اليه ونحمل اسمه ونعيش فيه.
الوطن، يحتضن جميع بناته وابنائه على حدٍّ سواء. يحترم تنوع الأعراق والأديان والطوائف، الذي يُشكِّل بالنسبة لنا النسيج العراقي المتعدد الألوان على مرِّ القرون. المواطنون ليسوا نمطاً واحداً جامداً، لكنهم متنوعون، لذا ينبغي الاعتراف بحقهم في الاختلاف، ومساعدتهم على إدارة علاقاتهم ليعيشوا بكرامة وحرية وتناغم ومساواة. الشراكة والاخوة والتضامن توفر لهم السلم المجتمعي، والإستقرار والطمأنينة.
وقال البطريرك
الدولة، كيان معنوي لا دين لها، الدينُ للأفراد. اليوم لا يمكن قبول حكم مسيحي أو إسلامي أو يهودي إحتراماً لواقع التنوع والتعددية، كما هو الحال في الغرب بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر (1789 – 1799)، حيث فصلت الكنيسة عن الدولة ليتفرغ الدين لرسالته الروحيّة السامية وعدم السماح لاستغلاله وتشويهه كما حصل في تاريخ الأديان!
على الدولة ان تكون حيادية، وان تفصل الدين عن الدولة اسوة بالدول المتطورة، حتى يشعر الكل انهم في بيتهم، يتمتعون بنفس الامتيازات والواجبات. الدولة تقوم على الفرد، وليس على الغالبية والأقلية ولا على المكونات!
وعن المواطنة، Citizenship، قال تشير الى انتماء الفرد الى بلده والشعور بعضويته فيه وحمل جنسيته، والتمتع بكامل الحقوق والامتيازات التي تكفلها الدولة له، والواجبات التي يتعيّن عليه الالتزام بها بدقة. ينبغي تطبيق مفهوم المواطنة لانها توحد الجميع وتشجع التعاون، وهي واقعيًّا مستقبل البلد وتطوره.
المواطنة، مجموعة من القواسم المشتركة، والقيم والأخلاق تتمثل بحبّ الوطن والتمسك بالهوية الوطنية الشاملة، والاخلاص والأمانة والنزاهة، والمروءة للدفاع عنه وحمايته والسعي لتطويره. هذه القيَم مردودُها سيكون كبيراً على البلاد والعباد.
واضاف ساكو
من المؤسف ان العديد من الأشخاص يحملون جنسية وطنهم، لكن ولاءهم ليس له، ويتدحثون باسم الدين المسلم او المسيحي، لكن لا يلتزمون باخلاق الدين الحميدة، انما يبحثون عن مصالح خاصة لا علاقة لها بمصلحة الوطن، ويخالفون مقتضيات المواطنة الصالحة التي هي أساس التغيير والتقدم نحو الأفضل.
الدستور، Constitution التأسيس، لا حلَّ الا بدولة ديمقراطية، وبدستور مدني متقدم كما في البلدان المتطورة، يقوم على الأسس الوطنية والثوابت الإنسانية، يخدم الصالح العام. لا ينبغي ان يكرّس التمييز الديني والمذهبي والعرقي الذي يناقض مبدأ الديمقراطية والمواطنة الكاملة. كيف يمكن لبلد متعدد الأعراق والأديان والطوائف ان يتبنى دستوراً يكون فيه الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، أي من المذاهب الفقهية الاربعة؟ تبَنّي كذا موضوع شديد الحساسية، يجعل القوانين الأخرى رهينة بالتفسير الديني، وتدخل في الحريات الشخصية وقوانين الأحوال الشخصية. المسؤول في الدولة هو في خدمة الجميع من دون إستثناء، لان السلطة خدمة إنسانية ووطنية وأخلاقية، بعيداً عن العقلية السلطوية الفردية والفئوية المتطرفة!
الدستور، ينبغي ان يكفل الحرية والكرامة والمساواة لجميع المواطنين، وحق المشاركة في إدارة الدولة والعملية السياسة. لنتعلم من الدول الغربية كيف يُسمح للمهاجرين المتجنسين تبوأ مناصب كرئيس الوزراء ووزارة .. الخ. وكذلك على الدستور ان يكفل حقوق المرأة والطفل، وحرية الرأي والتعبير.
للأسف أن الواقع على الأرض مختلف، بسبب الطائفية والمحاصصة، والفساد وترديّ الخدمات. لذلك هاجر العديد من العراقيين الى الغرب ومن ضمنهم أصحاب الكفاءات، والمسيحيون الذين هم جزء أصيل من هذه الأرض منذ آلاف السنين. لقد عانوا كثيراً من الإرهاب والتهميش والإقصاء، بحيث هاجر الثلثان.
واستطرد البطريرك قائلا
بعد خبرة أكثر من عشرين سنة لسقوط النظام، أجد ان الوقت قد حان لتنظيم طاولة حوار حضاريّ راقٍ، تضم أصحاب الكفاءات العلمية والقانونية، يفقهون آليات السياسة والقانون الدولي لمراجعة الدستور الحالي وإصلاح بعض الثغرات وتعديل بعض المواد ليعكس الواقع الحالي المتنوع، لا سيما ان للعراق حضارة وثروة ثقافية كبيرة يمكن الاستناد اليها. من الأهمية بمكان حماية هذه المبادئ الحيوية والاخلاقية، والإلتزام بها نُصرةً للعراق والعراقيين.
هذا ما يطالب به غالبية المواطنين
وكتب الباحث العراقي علي محمود الأبرز تحت عنوان
العراق والطائفية: دوامة لا تنتهي.. أحداث الساحل السوري نموذجا يقول
"لا وطنٌ يضمّنا، ولا هوية تجمعنا، نعيش على هامش التاريخ في دوامة الصراع الطائفي"، بهذه الكلمات وصف المفكر العراقي علي الوردي أزمة الطائفية التي تستنزف العراق منذ عقود. فالصراع الطائفي لم يكن مجرد عارضٍ تاريخي، بل أصبح بنية تحتية متجذرة في المشهد السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل داخلية وخارجية، وتجعل من العراق ساحةً دائمة للاحتقان والتوتر.
ظلال الساحل السوري على المشهد العراقي
لم تكن التطورات في الساحل السوري مجرد أزمة محلية تخص سوريا وحدها، بل وجدت طريقها إلى العراق، حيث تفاعل معها الشارع العراقي بحدة، وانقسمت مواقفه وفق الاصطفافات الطائفية التقليدية. الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والمكوّن العلوي هناك أعادت إلى الأذهان مشاهد الصراع الطائفي في العراق، وحفّزت موجةً من الخطابات المتشنجة التي اجتاحت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
من جديد، أُعيد فتح الجروح القديمة، وكأن العراق لم يخرج بعد من مستنقع الحرب الطائفية التي كادت تفتك به قبل سنوات. التعليقات الملتهبة والتحليلات التي تستحضر الماضي الدامي كشفت أن الشرخ الطائفي لا يزال قائمًا، وأن أي حدث خارجي يمكن أن يعيد إشعال فتيل الأزمة من جديد.
الانتخابات العراقية: مزاد الطائفية المفتوح
كلما اقترب موعد الانتخابات، عاد الخطاب الطائفي ليأخذ موقعه في الصدارة. الأحزاب السياسية، التي كان يُفترض أن تقدم برامج تنموية واقتصادية تعالج الأزمات المتراكمة، فضّلت العودة إلى استثمار التوتر الطائفي لضمان تأييد جماهيرها.
وكما في كل دورة انتخابية، تُستخدم مصطلحات التخويف والتعبئة الطائفية كأدوات مضمونة لاستقطاب الناخبين، إذ تدرك القوى السياسية أن تأجيج المخاوف من "الآخر" هو وسيلة ناجعة لحشد التأييد الشعبي. وهكذا، تتحوّل الانتخابات في العراق إلى منافسة في صناعة الأزمات، بدل أن تكون فرصةً لحلها.
المرجعية الدينية: صمت محسوب أم موقف حذر؟
لطالما كانت المرجعية الدينية في النجف لاعبًا رئيسيًا في تهدئة الأوضاع، خصوصًا خلال الفترات الأكثر دموية في تاريخ العراق الحديث. لكنها اليوم تتخذ موقفًا أكثر حذرًا، مكتفيةً بمراقبة المشهد دون التدخل المباشر.
هل هو إدراكٌ بأن أي خطوة قد تُفسّر سياسيًا وتجرّ المرجعية إلى صراعٍ غير مرغوب فيه؟ أم أن المرجعية وصلت إلى قناعة بأن الحل ليس بيدها، وأن الطبقة السياسية باتت تستخدمها كصمام أمان لا أكثر؟ الأيام المقبلة ستكشف إن كانت ستتدخل بقوة، أم أنها ستبقى في موقع المراقب الذي يكتفي بإصدار البيانات التوجيهية.
الحكومة العراقية: وعود بلا أفعال
على الورق، ترفع الحكومة شعار "رفض الطائفية"، لكن في الواقع لا توجد خطوات ملموسة لوقف التحريض أو محاسبة المسؤولين عن تأجيجه. بل إن بعض القوى المتنفذة داخل مؤسسات الدولة نفسها تغذّي هذا الخطاب حين تجد فيه أداةً مناسبة لحماية نفوذها.
ما تزال التصريحات الرسمية حول "تعزيز الوحدة الوطنية" حبرًا على ورق، إذ تغيب أي سياسات جدّية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، أو لمحاسبة الإعلاميين والسياسيين الذين يكرّسون الطائفية عبر منابرهم.
الإعلام والتواصل الاجتماعي: وقود الفتنة
أصبحت وسائل الإعلام العراقية، سواءً التقليدية أو الرقمية، ميدانًا مفتوحًا للمزايدات الطائفية. القنوات الحزبية لا تتردد في تكريس الانقسام، وبرامج "الحوار السياسي" تحوّلت إلى منصات للتراشق، حيث يُطلق الضيوف اتهامات متبادلة دون أي ضوابط مهنية.
أما وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تحولت إلى ساحةٍ أشد خطورة، حيث يمكن لأي خطاب تحريضي أن ينتشر كالنار في الهشيم. تغريدات ومنشورات مليئة بالكراهية تجد جمهورًا واسعًا مستعدًا لإعادة تدويرها، مما يزيد من تعقيد المشهد العراقي.
"الكراهية التي تُزرع اليوم، ستُزهر دماءً غدًا"، عبارة قد تلخص واقع الإعلام العراقي، الذي يبدو بعيدًا كل البعد عن دوره المفترض في تعزيز الوعي وتقديم خطاب جامع.
إلى أين يتجه العراق؟
إذا استمر هذا النهج، فإن العراق سيبقى عالقًا في دوامةٍ لا نهاية لها. الأزمات الطائفية المتكررة ليست مجرد أحداث معزولة، بل هي انعكاس لفشل مستمر في بناء مشروع وطني جامع.
العراق والطائفية: دوامة لا تنتهي.. أحداث الساحل السوري نموذجا يقول
"لا وطنٌ يضمّنا، ولا هوية تجمعنا، نعيش على هامش التاريخ في دوامة الصراع الطائفي"، بهذه الكلمات وصف المفكر العراقي علي الوردي أزمة الطائفية التي تستنزف العراق منذ عقود. فالصراع الطائفي لم يكن مجرد عارضٍ تاريخي، بل أصبح بنية تحتية متجذرة في المشهد السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل داخلية وخارجية، وتجعل من العراق ساحةً دائمة للاحتقان والتوتر.
ظلال الساحل السوري على المشهد العراقي
لم تكن التطورات في الساحل السوري مجرد أزمة محلية تخص سوريا وحدها، بل وجدت طريقها إلى العراق، حيث تفاعل معها الشارع العراقي بحدة، وانقسمت مواقفه وفق الاصطفافات الطائفية التقليدية. الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والمكوّن العلوي هناك أعادت إلى الأذهان مشاهد الصراع الطائفي في العراق، وحفّزت موجةً من الخطابات المتشنجة التي اجتاحت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
من جديد، أُعيد فتح الجروح القديمة، وكأن العراق لم يخرج بعد من مستنقع الحرب الطائفية التي كادت تفتك به قبل سنوات. التعليقات الملتهبة والتحليلات التي تستحضر الماضي الدامي كشفت أن الشرخ الطائفي لا يزال قائمًا، وأن أي حدث خارجي يمكن أن يعيد إشعال فتيل الأزمة من جديد.
الانتخابات العراقية: مزاد الطائفية المفتوح
كلما اقترب موعد الانتخابات، عاد الخطاب الطائفي ليأخذ موقعه في الصدارة. الأحزاب السياسية، التي كان يُفترض أن تقدم برامج تنموية واقتصادية تعالج الأزمات المتراكمة، فضّلت العودة إلى استثمار التوتر الطائفي لضمان تأييد جماهيرها.
وكما في كل دورة انتخابية، تُستخدم مصطلحات التخويف والتعبئة الطائفية كأدوات مضمونة لاستقطاب الناخبين، إذ تدرك القوى السياسية أن تأجيج المخاوف من "الآخر" هو وسيلة ناجعة لحشد التأييد الشعبي. وهكذا، تتحوّل الانتخابات في العراق إلى منافسة في صناعة الأزمات، بدل أن تكون فرصةً لحلها.
المرجعية الدينية: صمت محسوب أم موقف حذر؟
لطالما كانت المرجعية الدينية في النجف لاعبًا رئيسيًا في تهدئة الأوضاع، خصوصًا خلال الفترات الأكثر دموية في تاريخ العراق الحديث. لكنها اليوم تتخذ موقفًا أكثر حذرًا، مكتفيةً بمراقبة المشهد دون التدخل المباشر.
هل هو إدراكٌ بأن أي خطوة قد تُفسّر سياسيًا وتجرّ المرجعية إلى صراعٍ غير مرغوب فيه؟ أم أن المرجعية وصلت إلى قناعة بأن الحل ليس بيدها، وأن الطبقة السياسية باتت تستخدمها كصمام أمان لا أكثر؟ الأيام المقبلة ستكشف إن كانت ستتدخل بقوة، أم أنها ستبقى في موقع المراقب الذي يكتفي بإصدار البيانات التوجيهية.
الحكومة العراقية: وعود بلا أفعال
على الورق، ترفع الحكومة شعار "رفض الطائفية"، لكن في الواقع لا توجد خطوات ملموسة لوقف التحريض أو محاسبة المسؤولين عن تأجيجه. بل إن بعض القوى المتنفذة داخل مؤسسات الدولة نفسها تغذّي هذا الخطاب حين تجد فيه أداةً مناسبة لحماية نفوذها.
ما تزال التصريحات الرسمية حول "تعزيز الوحدة الوطنية" حبرًا على ورق، إذ تغيب أي سياسات جدّية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، أو لمحاسبة الإعلاميين والسياسيين الذين يكرّسون الطائفية عبر منابرهم.
الإعلام والتواصل الاجتماعي: وقود الفتنة
أصبحت وسائل الإعلام العراقية، سواءً التقليدية أو الرقمية، ميدانًا مفتوحًا للمزايدات الطائفية. القنوات الحزبية لا تتردد في تكريس الانقسام، وبرامج "الحوار السياسي" تحوّلت إلى منصات للتراشق، حيث يُطلق الضيوف اتهامات متبادلة دون أي ضوابط مهنية.
أما وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تحولت إلى ساحةٍ أشد خطورة، حيث يمكن لأي خطاب تحريضي أن ينتشر كالنار في الهشيم. تغريدات ومنشورات مليئة بالكراهية تجد جمهورًا واسعًا مستعدًا لإعادة تدويرها، مما يزيد من تعقيد المشهد العراقي.
"الكراهية التي تُزرع اليوم، ستُزهر دماءً غدًا"، عبارة قد تلخص واقع الإعلام العراقي، الذي يبدو بعيدًا كل البعد عن دوره المفترض في تعزيز الوعي وتقديم خطاب جامع.
إلى أين يتجه العراق؟
إذا استمر هذا النهج، فإن العراق سيبقى عالقًا في دوامةٍ لا نهاية لها. الأزمات الطائفية المتكررة ليست مجرد أحداث معزولة، بل هي انعكاس لفشل مستمر في بناء مشروع وطني جامع.