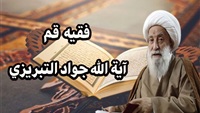من الدعوة إلى الهيمنة: قراءة في تأثيرات السلفية على المجتمع المصري
الإثنين 14/أبريل/2025 - 03:29 ص
طباعة
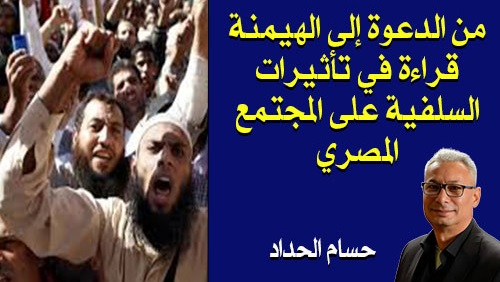 حسام الحداد
حسام الحداد
شهدت مصر في العقود الأخيرة صعودًا ملحوظًا للتيار السلفي، خاصة بعد تأسيس جماعة "الدعوة السلفية" في مدينة الإسكندرية. هذا التيار، الذي كان في البداية محصورًا في فئات قليلة من المجتمع، سرعان ما انتشر إلى جميع المحافظات، وبدأ يؤثر في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والدينية. تأسس هذا التيار على أفكار دينية متشددة تركز على العودة إلى ما يُعتقد أنه النموذج الأمثل في فهم الدين، وهو ما يعكس توجهًا متشددًا تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية. وقد ساهم هذا التوسع في انتشار الدعوة السلفية في تفعيل خطاب ديني يثير الانقسام داخل المجتمع، ويخلق صراعات بين الأطياف المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في السنوات الأخيرة.
امتد تأثير الدعوة السلفية ليشمل العديد من جوانب الحياة المصرية، بدءًا من الفضاء العام، مرورًا بالثقافة والتعليم، وصولاً إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية. من أبرز آثار هذه الدعوة هو تكريسها لأنماط تدين جامدة، تركز على المظاهر الشكلية وتضع قيودًا على حرية الأفراد في التعبير عن معتقداتهم. كما أن تأثيرها السلبي على قضايا المرأة كان واضحًا، حيث ساهمت في ترويج مفاهيم تقليدية تحد من دور المرأة في المجتمع، وتقيّد خياراتها الشخصية والمهنية.
من ناحية أخرى، كان لانتشار الدعوة السلفية أثر كبير في تفكيك الروابط الاجتماعية، إذ عززت من مبدأ "الولاء والبراء" الذي يسبب انقسامات داخل المجتمع، ويسهم في تقليل التواصل بين مختلف الفئات. هذا الخطاب أدى إلى تكوين مجتمعات مغلقة، تشكك في الآخر، وتبتعد عن قيم التعايش والتسامح التي كانت سائدة في المجتمع المصري قبل هذا التحول. كما أن الدعوة السلفية لعبت دورًا في تقويض المسار التعليمي والثقافي، حيث اعتمدت على نشر فكر يعتمد على التلقين والحفظ، مع تحذير واضح من المناهج الحكومية التي يُنظر إليها باعتبارها علمانية.
تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية لخطورة هذا التيار على البنية الاجتماعية في مصر. فهي تتناول تأثيراته على المستوى الفردي والجماعي، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية. كما ستسلط الضوء على كيفية استخدام الدعوة السلفية للعمل الخيري كأداة للهيمنة الاجتماعية والسيطرة على الطبقات الفقيرة، فضلاً عن تأثيراتها في تعزيز التوجهات المتطرفة، وصولًا إلى علاقتها بتنامي ظواهر الإرهاب. من خلال هذا التحليل، تسعى الورقة إلى تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي قد تطرأ على المجتمع المصري بسبب هذا التيار، وتقديم رؤى لكيفية التصدي لها.
أولاً: نمط التدين السلفي وأثره على المجتمع
تبنت الدعوة السلفية في مصر فهماً متشدداً للتدين الإسلامي يركّز بالأساس على المظاهر الخارجية والشكلية، معتبرة أن الالتزام الديني يُقاس من خلال المظهر العام مثل إطلاق اللحية للرجال وارتداء النقاب للنساء. وقد ترافق هذا الفهم مع رفض واضح لأي مظهر من مظاهر الحداثة الثقافية أو الاجتماعية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والمسرح، والتي يُنظر إليها باعتبارها لهوًا محرّمًا يؤدي إلى الانحراف عن طريق الاستقامة الدينية.
من خلال هذا الخطاب، تم نقل التدين من كونه علاقة روحانية شخصية إلى كونه ممارسة رقابية اجتماعية، تُفرض على العامة تحت غطاء "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وفي أوساط الأحياء الشعبية والمناطق الريفية، أدى هذا الخطاب إلى تكوين بيئات مغلقة، لا تقبل التنوع، وتشعر بالتهديد من كل ما هو مختلف دينيًا أو ثقافيًا، حتى داخل الطيف الإسلامي ذاته.
ساهم هذا النموذج السلفي في فرض معايير دينية صارمة على الحياة اليومية، بدءًا من طريقة السلام والجلوس والحديث، إلى رفض المشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلطة، مما أدى إلى تحجيم دور المرأة، وتفكيك البنية التشاركية للأسرة والمجتمع المحلي. وقد ترتب على ذلك انسحاب قطاعات من المواطنين من الحياة العامة، لا سيما النساء والشباب، في ظل شعور عام بالوصاية الدينية.
تظهر هذه السمات بوضوح في الدراسة التي أعدها الدكتور عمرو الشوبكي بعنوان: "الدعوة السلفية في مصر: النشأة والتطور والمسار السياسي"، والمنشورة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في يوليو 2011، حيث يشير في الصفحة 7 إلى أن "السلفية المعاصرة تمثل نموذجًا لنمط ديني محافظ، يعيد تعريف الدين كأوامر ونواهٍ، ويقيس التدين بالمظهر، ويزرع شكلاً من أشكال العزلة الفكرية والاجتماعية بين الفرد ومجتمعه".
ثانيًا: أثر السلفية على قضايا المرأة
تُظهر الرؤية السلفية تجاه المرأة ميولاً محافظة تُعيد إنتاج أدوار تقليدية صارمة تُقصر وجودها على المنزل ودورها الإنجابي والتربوي فقط. حيث تُعتبر أي محاولة لتمكين المرأة اقتصاديًا أو سياسيًا مخالفة لما تصفه السلفية بـ"الوظائف الفطرية" للمرأة. وفي أدبيات الدعوة السلفية، يُنظَر إلى عمل المرأة خارج البيت بشبهة شرعية ما لم يكن ضمن شروط قاسية تتعلق بالحجاب الكامل، ومنع الخلوة، والفصل التام بين الجنسين.
وقد ترتب على هذا الخطاب إحباط جهود تمكين المرأة في عدة مناطق مصرية، خاصة في الصعيد والدلتا، حيث تزايدت الضغوط المجتمعية على الفتيات لترك التعليم بعد سن معينة، أو لرفض فرص العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، بدعوى الحفاظ على الشرف والعفة. كما يتم تشويه صورة النساء العاملات في الإعلام أو الفنون بوصفهن "داعرات العصر"، وهو خطاب يتكرر في خطب دعاة سلفيين معروفين.
ترفض الدعوة السلفية القوانين الرامية لحماية حقوق المرأة باعتبارها مستوردة من الغرب، وتتنافى مع أحكام الشريعة. ففي تقارير ومواقف منشورة لرموز سلفية، يتم رفض قانون تجريم ختان الإناث باعتباره "تدخلاً في سنة نبوية"، كما يتم رفض تجريم العنف الأسري بحجة أن تأديب الزوجة حق شرعي للرجل، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التمييز وتبرير العنف ضد النساء.
وفي السياق ذاته، تشجع السلفية على زواج القاصرات وتعتبره من السنن المهجورة، استنادًا إلى مرويات تتعلق بزواج النبي من السيدة عائشة، رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل هذا النوع من الزواج مضرًا نفسيًا واجتماعيًا بالفتيات. وتُظهر دراسة لـ"هيومن رايتس ووتش" عام 2012 أن الخطاب السلفي المحافظ ساهم في إبطاء جهود الدولة في مكافحة زواج الأطفال وختان الإناث، خاصة في المناطق التي يهيمن فيها التيار السلفي.
ثالثًا: تفكيك الروابط الاجتماعية
تقوم الدعوة السلفية على مبدأ عقائدي يُعرف بـ"الولاء والبراء"، وهو مفهوم ديني يُلزم المسلم بالولاء المطلق لأهل الإيمان، والبراء التام من الكفار والمبتدعة وأهل الأهواء – حسب الفهم السلفي. هذا المفهوم، حين يُطبّق بشكل حرفي في السياق الاجتماعي، يؤدي إلى الانعزال الكامل عن الآخرين ممن لا يوافقونهم في العقيدة أو المذهب أو حتى في نمط الحياة.
وفي البيئة المصرية، حيث يتعايش المسلمون والمسيحيون، والمتدينون والعلمانيون، ساهم هذا المبدأ في إشاعة مناخ من الانقسام والتصنيف الديني داخل المجتمع. فوفقًا للخطاب السلفي، يُمنع التعامل الودي مع غير المسلمين، بل ويُحرَّم تهنئتهم بأعيادهم أو مشاركتهم في المناسبات الاجتماعية، ما يضعف العلاقات البينية ويعزز الغربة الاجتماعية بينهم وبين محيطهم.
كما يمتد هذا المبدأ إلى داخل الطيف الإسلامي نفسه، حيث يُصنّف كل من لا ينتمي إلى المدرسة السلفية بأنه على ضلالة، سواء كانوا من الأشاعرة أو الصوفية أو حتى من الإخوان المسلمين. وهو ما أدى إلى إنتاج مجتمعات صغيرة مغلقة، تتبنى لغة دينية إقصائية، وتشجع على العزلة عن المحيط العام، الأمر الذي ينعكس على العلاقات داخل الأسرة الواحدة وفي أماكن العمل والتعليم.
وقد أشار الباحث محمد أبو رمان في دراسته "السلفيون في مصر: بين الدعوة والسياسة"، الصادرة عن مؤسسة فريدريش إيبرت عام 2013، إلى أن السلفية تُنتج نمطًا من التدين يُعلي من الانضباط الظاهري ويضعف من روابط التعدد والتنوع داخل المجتمع، وهو ما يؤدي إلى انغلاق الأفراد داخل دوائر فكرية متشددة تقطعهم عن التيار العام وتضعف قدرتهم على التفاعل الاجتماعي.
رابعًا: التأثير في التعليم والثقافة
تمارس الدعوة السلفية تأثيرًا مباشرًا وخطيرًا على المجالين التعليمي والثقافي، من خلال نشر منظومة فكرية تقوم على رفض المناهج التعليمية الرسمية، وتبني خطابات تربوية موازية تروجها في المساجد والدروس الخاصة. تعتبر السلفية أن المناهج الحكومية مشبوهة، وأنها تروج لـ"العلمانية" و"البدع"، ما يستدعي من وجهة نظرهم إيجاد بديل تربوي ديني أكثر "نقاء".
يقوم هذا البديل التربوي على الحفظ والتلقين، مع التركيز على كتب التفسير والعقيدة من منظور ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب. ويُستبعد من هذه المناهج أي انفتاح على الفكر الفلسفي أو التراث الأدبي أو الأسئلة النقدية. بذلك، يتم تنشئة أجيال لا تمتلك أدوات التفكير النقدي، بل تنغمس في تقديس النصوص والرموز الدينية دون فهم للسياق أو التاريخ.
الخطورة تتجلى أكثر في سعي الدعوة السلفية إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات الثقافية والتعليمية، مثل الجامعات ووزارات الثقافة والتعليم، حيث يُتهم الأكاديميون والمثقفون بأنهم "أعداء الدين" أو "خدام الغرب"، ما يخلق فجوة خطيرة بين المجتمع والنخب الفكرية، ويعمق الشك في أي مشروع ثقافي حداثي أو إصلاحي.
كما تنتشر عبر المدارس والمساجد التابعة لهم كتيبات صغيرة ومنشورات رخيصة، تروج لمفاهيم مغلقة عن "الجاهلية الحديثة" و"العلمنة"، وتُصوّر المثقفين والمفكرين بوصفهم منحلّين أو زنادقة. ومع غياب الرقابة أو المحاسبة، تحولت هذه المواد إلى أدوات لبث الكراهية تجاه كل ما هو مغاير، مما ساهم في تراجع الذوق العام، وتقييد الحريات الثقافية، وإفقار الفضاء العام من التنوع.
خامسًا: العمل الخيري كأداة للهيمنة
لعب العمل الخيري دورًا محوريًا في استراتيجية الدعوة السلفية للانتشار والتمدد في الأوساط الشعبية، خصوصًا في المناطق الفقيرة والمهمشة. فقد أنشأت الجماعة شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمراكز الطبية ومنافذ توزيع السلع والملابس، وهو ما مكّنها من الوصول المباشر إلى شريحة واسعة من المجتمع المصري، خارج قنوات الدولة الرسمية. لكن هذا العمل الخيري لم يكن محايدًا أو إنسانيًا محضًا، بل ارتبط بأجندة دعوية واضحة تهدف إلى تغيير نمط التدين وسلوك الأفراد بما يتماشى مع الرؤية السلفية.
كانت المساعدات تُقدَّم في كثير من الأحيان ضمن شروط غير معلنة، تتمثل في حضور الدروس الدينية، أو ارتداء النساء للنقاب، أو التوقف عن مشاهدة التلفاز وسماع الموسيقى، بل وحتى الالتزام بعدم إرسال الأبناء إلى مدارس مختلطة. بذلك، تحوّل العمل الخيري إلى أداة ضغط اجتماعي تمارس من خلاله الدعوة السلفية نوعًا من الوصاية على حياة المستفيدين اليومية، وتُعيد تشكيلهم وفق تصوراتها المتشددة.
في السياق السياسي، استُخدم العمل الخيري كوسيلة لكسب الولاءات والضغط على الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية، حيث تم توظيف شبكة الجمعيات الخيرية لتوجيه أصوات الفقراء لصالح مرشحي الدعوة السلفية، كما حدث في انتخابات البرلمان بعد الثورة. هذا السلوك جعل من العمل الخيري وسيلة غير مباشرة للتأثير في الحياة العامة، دون الدخول في معترك سياسي مباشر.
وقد أشار الباحث هشام جعفر في مقاله "الدعوة السلفية والعمل الخيري: السيطرة الناعمة"، المنشور على موقع إضاءات في عام 2015، إلى أن "العمل الخيري السلفي هو مشروع لإعادة هندسة المجتمع من الأسفل، حيث تُقدّم المساعدات كطُعم دعوي، وتُستخدم لإعادة صياغة وعي الناس الديني، وترويضهم اجتماعيًا لصالح خطاب محافظ ومتزمت".
خاتمة:
أظهرت هذه الورقة أن خطورة الدعوة السلفية لا تقتصر على أبعادها العقائدية والدينية، بل تمتد إلى تشويه البنية الاجتماعية المصرية من الداخل. فقد أدّى تبنيها لنمط متشدد من التدين إلى خلق حالة من الانغلاق والعزلة داخل فئات واسعة من المجتمع، وتهميش القيم التعددية، وتشجيع السلوكيات الإقصائية التي تقوّض روح التعايش.
انعكس هذا النهج المحافظ والمتصلب في مواقفها من المرأة، والتعليم، والفنون، ما ساهم في تكوين ذهنية ترفض الاختلاف، وتُقدّم الطاعة العمياء على الحوار، والانضباط الشكلي على التفكير الحر. ومن خلال شبكة المساجد والجمعيات والمراكز غير الرسمية، استطاعت الدعوة السلفية التأثير في وعي قطاعات كبيرة من المواطنين، وفرض وصاية دينية واجتماعية على حياتهم اليومية.
وتنبع الخطورة الأكبر من تقاطعات هذا الفكر مع البنى التحتية للتطرف العنيف. فرغم أن الدعوة السلفية لا تتبنى العنف صراحة، إلا أن خطابها المتشدد والرافض للتعدد، والقائم على فقه الولاء والبراء والتصنيف المجتمعي، يخلق بيئة حاضنة للتطرف. وقد مثّل كثير من المنتمين لخط السلفية الدعوية، في وقت لاحق، خزانًا بشريًا للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، بعد أن انتقلوا من السلفية الدعوية إلى السلفية الجهادية.
لذلك، فإن التصدي لخطاب الدعوة السلفية لا ينبغي أن يكون فقط من منطلقات دينية أو سياسية، بل من زاوية اجتماعية وثقافية، تتبنّى مشروعًا وطنيًا بديلًا يُعلي من قيم التنوع، والمواطنة، والتفكير النقدي. وحده هذا المسار كفيل بتحصين المجتمع من الانغلاق والتطرف، وإعادة بناء المجال العام على أسس مدنية شاملة.
المراجع
1- عمرو الشوبكي، "الدعوة السلفية في مصر: النشأة والتطور والمسار السياسي"، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يوليو 2011، ص 7.
2- Human Rights Watch, "Egypt: Women's Rights Under Attack", 2012 Report, https://www.hrw.org/report/2012/05/29/egypt-womens-rights-under-attack
3- محمد أبو رمان، "السلفيون في مصر: بين الدعوة والسياسة"، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2013، ص 18.
4- هشام جعفر، "الدعوة السلفية والعمل الخيري: السيطرة الناعمة"، موقع إضاءات، 2015.