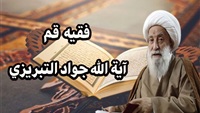فتاوى الغضب وأساطير العزلة: قراءة في خطاب داعش الأخير حول القانون الدولي
الأحد 20/أبريل/2025 - 03:23 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
لم تكن افتتاحية العدد 490 من صحيفة النبأ، الصادرة في 10 أبريل 2025 عن الجهاز الإعلامي لتنظيم داعش، مجرد مادة إخبارية أو تحليلية تناقش زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر. بل جاءت، كالعادة، متخمة بالحمولات الأيديولوجية التي يستثمرها التنظيم لتغليف خطابه بالعقيدة والاصطفاف الديني. فالحدث السياسي العابر يُستخرج من سياقه الواقعي ليُعاد توظيفه ضمن سردية "الصراع الأبدي" بين الإسلام و"الحضارة اليهودية النصرانية"، وهي التسمية التي يعتمدها التنظيم لتأطير العالم في ثنائية صلبة: إيمان مقابل كفر، ومسلم مقابل عدو وجودي.
في هذا الخطاب، لا يُقرأ أي تحرك دبلوماسي أو حدث دولي بمعناه السياسي الواقعي، بل يُعاد تأويله دينيًا لخدمة مشروع العداء الشامل. فتحية عسكرية من حرس الشرف المجري لنتنياهو تُصبح "دليلًا قطعيًا" على تواطؤ أوروبا المسيحية مع إسرائيل اليهودية ضد الإسلام، كما يصوره الخطاب الداعشي. لا مكان هنا لقراءة المصالح الدولية أو التوازنات الجيوسياسية، فكل الوقائع تُضغط في قوالب أيديولوجية جاهزة تُغذّي الخوف، وتعزز ثنائيات العداء، وتُلغي أي إمكانية للفهم أو الحوار أو التمايز داخل المعسكرات.
تكمن خطورة هذا النوع من الخطاب في قدرته على تقديم نفسه كتحليل "ناقد" للواقع السياسي، بينما هو في الحقيقة أداة لتوسيع دائرة الكراهية، وتحويل الغضب المشروع إلى شعور باليأس، ومن ثم دفع المتلقي نحو قبول العنف كخلاص وحيد. فكل المؤسسات الدولية، وكل الوسائل السياسية، وكل أدوات القانون، تُصوَّر على أنها فاشلة، خادعة، بل طاغوتية. والنتيجة: إقناع الجمهور المستهدف بأن الجهاد المسلح ليس فقط خيارًا، بل ضرورة دينية وسياسية لا بديل عنها.
في هذا المقال، سنعمل على تفكيك الافتتاحية من خلال خمسة محاور أساسية: أولها تحليل البنية الثنائية التي يقوم عليها الخطاب، وثانيها توظيف الوقائع السياسية لخدمة الأسطورة الأيديولوجية، وثالثها تفجير المفاهيم وتلغيم الوعي الديني، ورابعها تفكيك الرسائل المضمرة وآليات التحريض غير المباشر، وأخيرًا، تحليل الأثر الثقافي والفكري لهذا الخطاب في تعزيز التطرف داخل المجتمعات الإسلامية. وسنختتم المقال بدعوة إلى مواجهة الخطاب المتطرف ليس فقط بالرد عليه، بل ببناء خطاب بديل يعيد للدين مكانته كقوة للعدل لا للعنف.
خطاب ثنائيات متضخّمة:
يعتمد خطاب تنظيم داعش على بنية لغوية وفكرية تقوم على ثنائيات حادة، تصنع عالماً أخلاقياً بسيطاً ومقسّماً بصرامة: (الإسلام مقابل الكفر)، (المجاهدون مقابل العملاء)، (الشرع مقابل القانون الدولي)، (المؤمنون مقابل المنافقين). هذه البنية لا تعترف بالتدرج أو النسبية أو التعدد في المواقف، بل تقوم على تقسيم صارم لا يسمح بالحياد أو النقاش أو المراجعة. وبهذا، يصبح من يرفض الانضواء تحت رؤية التنظيم، أو يتبنى وجهة نظر مغايرة، أو حتى يناقشها، في خانة "العدو".
ما يميز هذه الثنائيات هو طابعها الحدي، إذ لا تتيح خيارات متعددة أو مساحة للاجتهاد أو المقاربة الوسطية. فهي ثنائيات إقصائية لا تحتمل الرمادي، تملي على المتلقي موقفًا واحدًا: إما أن ترفض القانون الدولي وترفض معه كل المنظومات "الحديثة"، أو تُعدّ من "الطواغيت" أو "أوليائهم". وهذا المنطق هو ما يسميه بعض الباحثين في تحليل الخطاب بـ"الانغلاق الإدراكي"، حيث يُغلق الفضاء الفكري أمام المتلقي ويُختزل العالم في ثنائية صارخة لا فكاك منها.
الغاية من هذه الثنائيات ليست فقط تبسيط الواقع أو تسهيل الفهم، بل هي وسيلة لبناء أيديولوجيا مغلقة تحاصر وعي المتلقي وتمنعه من رؤية الواقع خارج قوالب التنظيم. فحين يُصوّر القانون الدولي مثلاً كضد للشرع، تُصبح أي محاولة للاحتكام إليه نوعًا من الردة أو النفاق، حتى لو كان في مصلحة المسلمين. وهذه الخطورة لا تتعلق فقط بالطرح الديني، بل بكيفية اختطاف الدين وتطويعه لصالح خطاب الغلو والتكفير.
الثنائيات التي يعتمدها التنظيم ليست موجهة فقط ضد خصومه المباشرين من "الكفار" بحسب توصيفه، بل تطال كذلك خصومه في المجال الإسلامي، من مفكرين، وفقهاء، وجماعات إسلامية أخرى، بل وحتى الأنظمة والشعوب الإسلامية التي لا تتبنى خطابه. فكل من لا يقف في خندقه هو بالضرورة "منافق"، و"مرتد"، و"عميل"، و"موالي للطاغوت"، وهي توصيفات تحقيرية تُستخدم لنزع الشرعية الدينية والإنسانية عن المخالف، بما يبرر لاحقًا استهدافه.
واحدة من أبرز الملاحظات على افتتاحية النبأ أنها لا تهاجم القانون الدولي فقط على أساس فشله أو عجزه، بل تصفه صراحة بأنه "جاهلية وكفر"، وتضع محكمة الجنايات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الأممية، في خانة "الطاغوت العالمي". وهذا الاتهام يتجاوز مجرد النقد السياسي ليصل إلى التكفير المؤسس، وهو ما يمهّد لتبرير استهداف تلك المؤسسات أو من يتعاون معها، من أفراد أو دول أو منظمات، تحت بند "محاربة الكفر العالمي".
بهذا البناء الخطابي، يسعى تنظيم داعش إلى حشر أتباعه في معسكر إيماني مغلق، لا يعترف بالحوار أو التفاوض أو حتى المقاربة الفكرية مع الآخر. فمجرد قبول فكرة القانون الدولي، أو التماس العدل من مؤسساته، يُعدّ انحرافًا عقديًا. وهنا، لا يكون النقاش حول فعالية القانون أو محدودياته، بل حول إيمانه أو كفره. وبهذا، يتحول النقاش السياسي أو القانوني إلى معركة عقائدية، يفرض فيها التنظيم سلطته الفكرية والدينية على أتباعه، ويمنع عنهم أدوات التفكير النقدي والتفاعل المدني.
استخدام الوقائع لتغذية الأسطورة:
في خطاب داعش، لا تُعالج الوقائع السياسية بوصفها أحداثًا قابلة للتأويل المتعدد، بل تُنتزع من سياقها وتُعاد صياغتها لتخدم سردية التنظيم الكبرى. فعلى سبيل المثال، تُحوّل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، والاستقبال الرسمي الذي حظي به، إلى "دليل قاطع" على أن القانون الدولي ليس سوى أداة بيد "الصليبيين واليهود"، بحسب توصيف التنظيم. هنا، لا يُطرح الحدث للتحليل أو النقاش، بل يُوظّف كرمز لتأكيد فرضية أيديولوجية مسبقة، هي أن العالم متآمر على المسلمين، وأن كل مؤسسات النظام الدولي مشاركة في هذا التآمر.
بهذا التوظيف الانتقائي، يصبح الحدث السياسي وقودًا لأسطورة كبرى يتبناها التنظيم، مفادها أن المسلمين في حالة حصار عالمي لا مخرج منه إلا بالعنف. ويُقدَّم هذا العنف لا كخيار استراتيجي، بل كقدر إيماني، بوصفه السبيل الوحيد لمواجهة مؤامرة كونية. هذا النوع من التعميم يعفي أتباع التنظيم من التفكير في البدائل، أو فهم تعقيدات المشهد الدولي، أو إدراك وجود تباينات حقيقية داخل السياسات الغربية، وخصوصًا تجاه قضايا مثل فلسطين. فالأسطورة تحتاج إلى عالم مبسّط، صلب، أبيض وأسود، يُبرر اللجوء إلى الجهاد العنيف بوصفه خلاصًا روحيًا وواقعيًا.
اللافت أن الخطاب لا يتجاهل التعقيد الدولي عن جهل، بل يتعمد تغييبه كجزء من هندسة الخطاب. فلو أقرّ التنظيم بوجود انقسامات داخل المجتمعات الغربية، أو بتعدّد المواقف في المؤسسات الدولية، أو بتأثيرات السياسة الداخلية على العلاقات الخارجية، لأضعف بذلك سرديته المركزية. أي اعتراف بالتنوع والتباين يُفكك صورة "العدو المطلق"، ويحول دون بناء حالة الاستقطاب الوجداني بين "أمة التوحيد" و"معسكر الكفر"، التي يعتمد عليها التنظيم لتعبئة أتباعه.
في نهاية المطاف، يقوم هذا الاستخدام البراغماتي للوقائع على اختزال شديد للعالم المعاصر: عالمٌ تُمحى فيه السياسة، وتسقط فيه التحليلات، ويُختصر في مسرحية صراع كوني بين الإيمان والكفر. وهكذا، يُعاد تشكيل وعي المتلقي ليشعر بأنه يعيش فصول "المعركة الأخيرة"، ما يعزز قناعته بأن العنف الجهادي ليس فقط مشروعًا، بل حتميٌّ ومطلوب. وهذا ما يجعل الخطاب الداعشي جذّابًا للبعض، ليس لأنه يقدم تفسيرًا دقيقًا للعالم، بل لأنه يمنح إحساسًا زائفًا باليقين في عالم مضطرب.
تفجير المفاهيم وتلغيم الوعي:
في افتتاحيتها الأخيرة، لا تكتفي دعاية داعش بنقد القانون الدولي كآلية سياسية عاجزة عن إنصاف المظلومين، بل تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك: إدانته بوصفه "كفرًا بواحًا" يستوجب البراءة منه. هذا التحول من النقد إلى التكفير لا يقوم على مناقشة فقهية أو قانونية، بل على إعادة تصنيف المفاهيم المدنية ضمن قاموس عقائدي مغلق. فالقانون – الذي يُفترض أنه أداة تنظيم وضمان للحقوق – يُعاد تقديمه كـ"طاغوت" يناقض الإيمان، بحيث لا يعود الانخراط فيه أو حتى الاستفادة من نتائجه مجرد اجتهاد سياسي، بل انحراف ديني يُوجب الردة.
ما نراه هنا هو ما يسميه منظّرو تحليل الخطاب بـ"تفجير المفاهيم"؛ أي عملية نزع للمعنى المتعارف عليه من الكلمات وإعادة شحنها بدلالات عدوانية أو تكفيرية. في هذا الإطار، لا يُعاد تعريف المفهوم فقط، بل يُحوَّل إلى عبوة أيديولوجية قابلة للانفجار في وعي المتلقي. فالقانون الدولي، بدل أن يُفهم كنظام إجرائي نسبي قابل للتطور، يُعاد تشكيله كرمز صريح للشرك. وهكذا، ينقلب معنى العدالة إلى "خديعة"، والتحكيم إلى "شرك"، والسعي للمرافعة القانونية إلى "موالاة للطواغيت".
اللافت في هذا النوع من الخطاب أن عملية التفجير لا تتوقف عند المفاهيم، بل تمتد إلى إعادة تصنيف الأشخاص. فحتى الإسلاميون الذين يناشدون العدالة الدولية أو يتحركون ضمن فضائها يُجرَّدون من مشروعيتهم الدينية ويُصنَّفون كـ"منافقين" أو "مرتدين". هذه القسوة في التصنيف لا تنبع من اختلاف في الرؤية السياسية، بل من طبيعة خطاب يقوم على احتكار الحقيقة المطلقة، وتجريم كل من لا ينضوي تحت مظلته. إنّه خطاب يرفض التعدد داخل الصف الإسلامي نفسه، ويحوّل الخلاف إلى تخوين، والنقاش إلى إقصاء.
في نهاية المطاف، لا ينتج هذا الخطاب وعيًا نقديًا بقدر ما ينتج وعيًا مُلغّمًا، أي وعيًا يبدو متماسكًا ظاهريًا لكنه مبني على شبكة من المفاهيم المنزوعة من سياقاتها، والمحمّلة بدلالات أيديولوجية مغلقة. وهذا النوع من الوعي لا يقبل التفاوض أو المراجعة، بل يُؤسس لحالة من القطيعة الشاملة مع العالم، حيث تصبح كل المؤسسات كافرة، وكل القوانين شركًا، وكل الاجتهادات السياسية خيانة. وهنا تكمن خطورته الكبرى: أنه لا يدمر المعنى فحسب، بل يزرع في مكانه ألغامًا معرفية قابلة للانفجار في أي لحظة.
الرسائل المضمرة والتحريض غير المباشر:
تتبنّى افتتاحية داعش أسلوبًا يبدو للوهلة الأولى كتحليل سياسي، إذ تنتقد المؤسسات الدولية وتسلّط الضوء على تناقضات القانون الدولي ومواقف الدول الكبرى. غير أن هذا الغلاف التحليلي لا يُخفي الهدف الحقيقي للخطاب: التحريض النفسي والإيديولوجي على رفض أي مسار سلمي أو حل سياسي. فالنص لا يقدم قراءة لتجاوزات النظام العالمي من باب الإصلاح أو المراجعة، بل يستثمر هذه الثغرات لتبرير خيار العنف باعتباره السبيل الوحيد "المتاح"، وكأن التنظيم وحده يمتلك بوصلة النجاة.
من خلال هذا التوجيه غير المباشر، تُقدَّم الحرب بوصفها الخيار الوحيد الباقي أمام المسلمين، بل كخيار إيماني لا بديل عنه. "الجهاد المسلح" لا يُطرح هنا كأداة دفاعية أو ضمن سياق مقاومة مشروعة، بل كقدر لا مفر منه، وكفعل تعبّدي يُطهّر الذات والجماعة من "أدران" السياسة والتفاوض. بهذا، يتحوّل النص من مجرد تعليق على زيارة سياسية إلى دعوة ضمنية للالتحاق بالمشروع القتالي، تحت غطاء من التحليل والانفعال العاطفي.
في إطار هذا التوجيه النفسي، تُدمج أطراف متعددة – كالمجر، أمريكا، اليهود، وأنصار القانون الدولي – في بوتقة واحدة: "معسكر الكفر". لا مجال للتفريق بين الدول أو السياسات أو المواقف المتباينة، فالكل جزء من مؤامرة شاملة تستهدف الإسلام. هذه الرؤية التبسيطية تصنع عالمًا ثنائيًّا مغلقًا: إما أن تكون مع التنظيم، أو مع الأعداء. والهدف من هذا الدمج هو تعزيز الاستقطاب وتغذية "الذهنية الحصرية"، بحيث يُسقط المعنى الرمادي، وتُلغى التعقيدات، ويُهيمن اللونان الأبيض والأسود فقط.
ما ينتج عن هذا الخطاب هو بناء ما يُعرف بـ"ذهنية الحصار"، وهي حالة نفسية يشعر فيها الفرد بأنه محاصر من جميع الجهات، وأن العالم بأسره متآمر ضده، فلا يجد ملاذًا إلا في أحضان التنظيم. في هذه الحالة، يتحول الانتماء إلى الجماعة من قناعة فكرية إلى ضرورة وجودية. يختفي الأمل بالإصلاح أو التغيير السلمي، ويحلّ مكانه وعد خلاصي: الهجرة من "دار الكفر"، والانخراط في "مشروع الأمة" كما تراه داعش. وبهذا، لا يكتفي الخطاب بإقصاء الآخر، بل يُغلق أفق المستقبل، ويزرع القطيعة مع العالم.
أثر الخطاب في تنامي التطرف
لا يتوقف خطاب داعش عند حدود التحريض على "الآخر" الخارجي، بل يتوغّل أعمق في البنية الثقافية والفكرية للمجتمعات الإسلامية نفسها. فالهجوم على القانون الدولي لا يستهدف الغرب فحسب، بل يمتد ليشمل كل من يؤمن بإمكانية الإصلاح أو التغيير السلمي من داخل المنظومة. وبهذا، يتحوّل الخطاب إلى أداة لتفخيخ الوعي، حيث تُصوَّر كل محاولة للتفاعل مع أدوات العصر – كالقانون أو السياسة أو حقوق الإنسان – بوصفها خيانة للدين.
عندما يُشكَّك في فاعلية المؤسسات، ويُخوَّن دعاة العدالة، ويُطعن في نوايا الإسلاميين الإصلاحيين أنفسهم، تنشأ حالة من الشك العام والريبة، تفرغ الساحة من كل بدائل معقولة. في هذا الفراغ، لا يبقى أمام بعض الأفراد إلا التطرّف بوصفه "يقينًا جاهزًا"، يقدّم إجابات بسيطة على أسئلة معقدة، ويمنحهم شعورًا زائفًا بالقوة والانتماء. وهكذا، يغدو الخطاب أداة لاستقطاب العقول والقلوب نحو الراديكالية.
الخطاب لا يهاجم فقط الخصوم، بل يعمل على نزع الشرعية عن أي صوت وسطي أو إصلاحي داخل الحقل الإسلامي. فالداعية الذي يدعو إلى التدرّج، والمفكر الذي يناقش مفهوم الدولة، والناشط الذي يسعى لتغيير الواقع عبر القانون، كلهم يُقدَّمون كـ"منافقين"، أو "عملاء"، أو "مرتدين". هذه الإستراتيجية تُقصي العقلانية، وتغلق باب الاجتهاد، وتمنح الجماعة المتطرفة احتكارًا للحديث باسم الإسلام، في غياب أي منافسة فكرية حقيقية.
في المحصلة، فإن داعش تخوض معركة يتجاوز ميدانها ساحات القتال، إلى ما يمكن تسميته بـ"الحرب على الإدراك". التنظيم يسعى إلى بناء منظومة إدراكية بديلة، يرى من خلالها العالم كله كعدو، والحياة كلها كحالة حرب مستمرة، والدين كمجرد ردة فعل دموية على "مؤامرة كونية". وبهذا، لا يكون التطرف مجرد نتاج للعنف، بل نتيجة مباشرة لإعادة تشكيل العقول وفق منطق الكراهية والحصار، وقطع الطريق على أي أفق للمصالحة مع الذات أو مع العالم.
نحو تفكيك الخطاب لا فقط مواجهته
ليست خطورة افتتاحيات تنظيم داعش في مضمونها الظاهر فقط، بل في بنيتها العميقة التي تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح، وعلى ما تُخفيه أكثر مما تُفصح عنه. فبينما تقدم نفسها كتحليل سياسي أو ديني، فإنها تعمل بصمت على إنتاج خطاب كراهية مقنّع بلغة شرعية. إن المسألة ليست فقط ما يُقال، بل كيف يُقال، ولمَن يُقال، وفي أي سياق يُبث. هذه العناصر مجتمعة تجعل الخطاب أشبه بـ"سلاح ناعم" يراكم تأثيره في وعي الأفراد والجماعات بصمت وفعالية.
الخطاب الذي يبدو في ظاهره غيورًا على الدين ومناصرًا للمظلومين، ما هو في جوهره إلا تسويق لبنية عقلية مغلقة، ترى العالم وفق ثنائية "نحن ضد الجميع". وهذا النمط من الخطاب لا يُقدّم حلاً بقدر ما يُغذّي شعورًا دائمًا بالحصار، ويُلبس مشاعر الغضب والخذلان لباسًا دينيًا. وهنا تكمن الخطورة الأكبر: تحويل التديّن إلى ممر إجباري للعنف، بحيث لا تُفهم النصوص الدينية إلا بوصفها دعوة للقتال، ولا تُفهم المعاناة إلا بوصفها مبررًا للانتقام.
إن الاقتصار على تفنيد الأكاذيب أو كشف التناقضات لا يكفي لمواجهة هذا الخطاب. ما لم يُبنَ وعي بديل، فإن الفراغ سيبقى مهيّأ لعودة سرديات العنف. المطلوب ليس مجرد الرد، بل التأسيس لخطاب جديد يربط القيم الإسلامية العميقة – كالعدل، والرحمة، والكرامة – بالقيم الإنسانية المشتركة، ويعيد تقديم الإسلام بوصفه دين إصلاح لا انتقام، ودين بناء لا هدم. فالمعركة الحقيقية ليست ضد النصوص فقط، بل ضد أنماط الفهم التي أُفرغت من مقاصدها واستُعملت كذخيرة في معارك عبثية.
في النهاية، لا بد من استعادة الدين من براثن التنظيمات المتطرفة، عبر مشروع فكري وروحي يُعيد الاعتبار لفكرة الإصلاح، ويُحيي مفهوم النضال السلمي، ويؤمن بالمواطنة كجسر بين الإيمان والعمل العام. فالإسلام، في جوهره، لا يحتاج إلى قتال ليُثبت وجوده، بل إلى عدالة تُجسّده في حياة الناس. وتفكيك خطاب العنف يبدأ من هذه القناعة: أن الدين ليس هو المشكلة، بل ما صُنع باسمه، وما يُلقَّن للناس بوصفه "الخلاص"، وهو في حقيقته طريق للهلاك.