فهم الإرهاب المعاصر وخباياه (2- 2)
الأحد 28/مارس/2021 - 12:44 م
طباعة
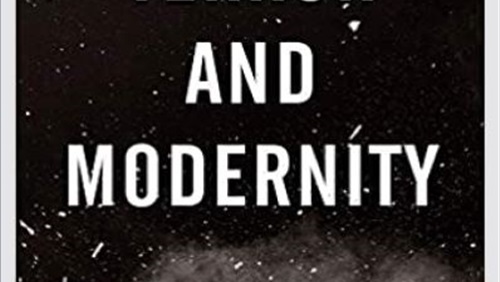 حسام الحداد
حسام الحداد
تقدم "دوناتيلا دي سيزار" أستاذةُ الفلسفة النظرية في جامعة "لا سابينزا" بإيطاليا، في كتابها "الإرهاب والحداثة" سرد مفصَّل للهجَمات الإرهابية التي ضربت مسرح باتاكلان بباريس في نوفمبر 2015 م، وأدَّت إلى مقتل 130 شخصًا وإصابة المئات. ومن هناك تسافر بنا بطريقة سلسة لتحلِّلَ الكثير من جوانب الإرهاب الجديد وما يتصل به، وهذا لا يعني طبعًا أن مفهوم الإرهاب أو أنواعه ظاهرةٌ جديدة. وتأخذنا المؤلِّفة إلى أيام فصيل الجيش الأحمر في ألمانيا، والكتائب الحمراء في إيطاليا في أواخر السبعينيات الميلادية؛ بل تمضي بنا إلى زمن أبعدَ، إلى القرن الثامن عشر عندما ظهرت كلمة "الإرهاب" أول مرة.
وقد افتتحت المؤلفةُ كتابها بالسؤال عن ظاهرة الإرهاب المؤلمة التي يذهب ضحيَّتها في الغالب أبرياءُ لا دخلَ لهم في الصراعات السياسية أو الفكرية بين الدول والجماعات. وتحلِّل قضيةَ قتل المدنيين في الهجَمات الإرهابية، التي غالبًا ما تستخدم كلمة (الإرهاب) للإشارة إليها، وينفِّذها على الأرجح أشخاصٌ يعيشون في
أحياء الغرب الفقيرة في فرنسا وبلجيكا وغيرها، ويشعر هؤلاء بأنهم مهمَلون ومشتَّتون، فيلجؤون إلى الانتقام بقتل الآخرين، وفي الوقت نفسه يواجهون موتهم المؤكَّد.
الإرهاب والعولمة
يرتبط الإرهابُ ارتباطًا وثيقًا بالعولمة التي تُعَدُّ القوةَ الدافعة له؛ فالإرهاب كالعولمة لا يعترفُ بالحدود والقوانين المحلِّية والأعراف الخاصَّة، ويسعى لإيجاد عالم موحَّد ومتناسق لا وجودَ للخلافات فيه، ولا فرقَ فيه بين الحرب والسلام، ولا بين العسكري والمدني، ولا بين حالة الطوارئ والحالة الطبيعية للعالم. ويحاول الإرهابُ توجيهَ العالم كلِّه نحو وجهة واحدة، وهي محاولةٌ لتسطيح ما هو
معقَّد، ورسم خطوط وهمية لتسمية عدوٍّ محدَّد ومحاربته، وهي أيضًا محاولةٌ لتغيير مسار التاريخ بالقوَّة. وهذا بحسَب الكاتبة غيرُ واقعي؛ لأنه يتعلقَّ بما وراء الهجَمات الإرهابية التي لا تحقِّق الكثيرَ على الأرض، ولا تقلب موازين القوى أو مسارَ التاريخ للدول العظمى.
وترى الكاتبةُ أن الإرهاب نتيجةٌ تابعة للحرب الباردة، عندما دعمَت الولايات المتحدة أعداء الاتحاد السوفيتي ودرَّبتهم وسلَّحتهم، ويمثِّل تدميرُ برجَي التجارة العالميين التوءَمَين عملين انتحاريين؛ انتحارَ الخاطفين المهاجمين، وانتحارَ أولئك الذين درَّبوهم. ومن هنا يبدو الإرهابُ أحدَ أعراض أمراض المناعة الذاتية التي تأتي مع الحداثة المعاصرة.
إن الإرهاب المعاصر بجميع أنواعه وفروعه، يزدهرُ وينتشر بالإشهار والفوضى الإعلامية؛ لأنه يخاطب الرأي العام، ويؤثر فيه تأثيرًا مباشرًا أو غيرَ مباشر. وقد وصل التحدِّي الرمزيُّ للإرهاب، الذي لم يكن من الممكن مواجهتهُ في الماضي القريب، إلى إمكانات غير مسبوقة بتوظيف العولمة، فلم يعُد ينُظَر إلى الإرهاب على أنه حدثٌ غير عادي على طريق التقدُّم الذي لا رجعةَ فيه. وأعمال الشرِّ التي كان يعُتقَد أنه يمكن هزيمتها، ازدادت مع النظام العالمي الجديد، وباتت مصرَّة على أن يكونَ لها حضورٌ دائم ومتغلغل. إنه الإرهابُ الذي يقول «لا » للعولمة العنيفة المتسلِّطة، ويعرِّض معظم أقطار العالم للخطر، وقد بدا هذا جليًّا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م.
لقد كانت تجرِبة الحادي عشر من سبتمبر جديدةً ومفزعة للأمريكيين، وهي أن الحرب والخراب كما يحلَّن بدول أخرى، بإمكانهما تدميرُ الرمز العالمي الأول للتجارة.
كُنْه الإرهاب
الإرهاب متعدِّد الوجهات والأساليب والطرق؛ لأنه ينشأ من نظام رمزيٍّ غير قابل للاختزال. إنه الشبحُ الذي يُبقي العالم في حالة تربُّص وخوف ويقظة. الإرهاب هو شكل الانتقامُ من احتكار السُّلطة، وهو انتقام باسم كل القوى التي أذلَّتها القوى العالميةُ الرأسمالية المتجبِّرة. إنه عَداءٌ جذري ينشأ داخل نظام الدولة نفسه، نتيجةً للتفكُّك الداخلي للسلطة. ولا شكَّ أن لهذه النظرة مزايا كثيرةً؛ لأنها تساعد جزئيًّا على تفكيك الإرهاب بتجنُّب خطابات الاستصغار والاحتقار، ما يحيِّد الإرهابَ على الأقلِّ أخلاقيًّا، ويقدِّمه أداةً لا تستحقُّ الثناء ولا الكراهية، وإنما يُنظر إليه بوصفه عملً واقعيًّا ناتجًا عن التاريخ والأحداث العالمية.
وهناك ثلاثةُ نماذجَ سائدةٌ في التفسير الحالي للإرهاب: الأول «صراعُ الحضارات» وفقًا للصيغة المشهورة لصمويل هنتنغتون. والثاني «الصراع الطبقي » أي أن ما يغذِّي العنفَ هو عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. والثالث «الحرب المقدَّسة » التي تُشَنُّ باسم الدِّين.
لم تبدأ المجازرُ مع الإرهاب الحديث، لكنَّها ظهرت بظهور الإنسان، وإذا كان العنفُ جزءًا من الإنسانية فلماذا يصدمُنا حدوثه أكثرَ مع الإرهاب الحديث، وأقلَّ مع إرهاب الدول الذي يخلِّف ملايين الضحايا ودمارًا أكثر وأوسع؟ حتى الساعة، لا يزال الإرهابُ العالمي يُفهَم على أنه إرهابٌ حاقد على الغرب وعلى قيم الإنسانية وشيمها، وأنه إرهابٌ أعمى مدفوع بعقيدة أصولية ظلامية حقودة تدمِّر الأخضر واليابس؛ ما يجعل أيَّ تفاهم أو تفاوض بين الإرهابيين وأعدائهم مستحيلً.
وتعود بنا الكاتبةُ إلى الماضي، فتذكِّرنا بحوادثَ إرهابية في نظرها، كالهجوم النوويِّ على هيروشيما وناكا زاكي، وتدمير المدينة الألمانية دريزدن على يد الحلفاء سنة 1945 ؛ إذ كان مركزُ المدينة بأكمله أشبهَ بغرفة احتراق قدَّمت نموذجًا جديدًا للإرهاب الحراري. وبهذا بدأت الدولُ في استخدام الطرق الإرهابية، ولا يتردَّد بعضها في نَعْت تشرشل بالإرهابي، حتى رئيسُ الوزراء البريطاني نفسه لم يكن يتردَّد في الاعتراف بذلك.
الإرهاب والتأسلم:
الخطوة الأولى نحو التطرف بحسَب الكاتبة، هي الولادةُ من جديد أو التوبةُ النصوح، وهذا ينطبق على الذين اعتنقوا الإسلام كما ينطبق على المسلمين الذين تحوَّلوا إلى مذهب جديد غير مذهب آبائهم. ويرى الإرهابي في التطرف شفاءً وتنقية وكفَّارة وتوبة وزهدًا في الدنيا والعالم الفاسد المنافق. وهو أيضًا طريق للخلاص والتعافي ونيل رضا الله والاستسلام لأوامره.
إن كلمة «التطرف » التي غزت العالمَ تشبه العبوةَ الناسفة؛ لاحتوائها على بذور الرعب والخوف. أما الإجراءاتُ الأمنية وأجهزة المخابرات، باتِّباع معاييرَ غير مسبوقة، فتحاول استباقَ الإرهاب وإيقافه قبل تنفيذ الهجوم. فالعديدُ من المفاهيم التي كانت مشتَّتةً في الماضي القريب، مثل التطرف، والأصولية، والتعصُّب، قد وجدت حاضنةً في الفضاء الأصولي، لهذا يصعُب تحديد العَلاقة بين الإرهاب والتطرف. فالبحثُ في التطرف مِفتاحٌ لفهم الإرهابي، وفهم الدوافع التي تدفعه للتضحية بحياته وحياة الآخرين؛ من أجل إيصال رسالة أو إبداء موقف. وميزةُ هذا البحث تتجلَّى في كشف الأشياء التي تجاهلها الإعلامُ أو تغاضى عن ذكرها.
وتشير الكاتبةُ إلى «التأسلم» وظهوره هو ردُّ فعل من المسلمين على الحداثة في القرن الثامن عشر، حين غزت قوَّاتُ نابليون الإسكندرية في يوليو 1798 م. فالحداثة، مثل العَلمانية والعَقلانية، جاءت بنيران المدافع، وخلَّفت وراءها أحزانًا وضحايا وتاريخًا أسود.
لكنها انتصرت، وحكم أصحابُها العالم بإستراتيجياتهم السياسية، وتقدُّمهم التقني، وتحكيمهم للعقل. لم يفُتِ الكاتبة، في حديثها عن الحاكمية وسلطان الله في الأرض، ذكرُ سيِّد قطب وهجومه على الحداثة بوصفها كفرًا وظلامية وجاهلية، وحثِّه على تحكيم شرع الله في الأرض بأيِّ ثمن، ولو بالعنف. فالسيادةُ المقدَّسة هي سيادة الله على الأرض، التي حاولت الحداثة العَلمانية التخلُّصَ منها.
ومن هنا ترى الكاتبةُ أن الإرهابيين ليسوا أصوليين ولا تقليديين؛ بل على العكس، هم فاعلون أساسيُّون في الصراع، صبورون ينتظرون علامات آخر الزمان، مقتنعون بامتلاكهم الحقيقةَ على الرغم من عدم فهم الآخرين رؤيتَهم. وترى أيضًا أن الإرهاب الحديث مثَلُه مَثَلُ الرأسمالية، كلاهما تخطَّيا سقفَ العقيدة الفكرية، وأصبحا دينَين وطريقين للحياة، غنيَّين بالمبادئ والتوجيهات. لكن بخلاف الرأسماليين، يواجه الإرهابيون الموتَ الذي يرَونه نصرًا في ذاته، وليس تضحيةً وضياعًا لحياتهم دون معنى. يحاولون هزيمةَ الواقع، وإحلالَ واقع جديد مكانه، حتى يحكمَ شرعُ الله في الأرض، ويحلَّ مكان الشرائع الوضعية الزائفة.
وتضيف الكاتبةُ أن فكرة الصِّدام بين التوجُّه العَلماني الإقصائي والتوجُّه الديني الحرفي التقليدي تؤدِّي إلى إحساس عميق بعدم الارتياح، يمكن أن يُعزى إلى عودة الدِّين المزعومة إلى المجال العام.
وبدلَ الحديث عن «صراع الحضارات » يجب أن نتحدَّثَ عن الصراعات في جميع أنحاء العالم داخل الحضارة الإنسانية نفسها، تُؤدِّي إلى نزاعات وحروب مصغَّرة. وتُؤكِّد الكاتبةُ أن المرء قد يكون أصوليًّا أو متطرفًا دون أن يكون إرهابيًّا، ولا يجمع بين هؤلاء إلا من يريد لومَ الإسلام والمسلمين كافةً ووصمَهم بالإرهاب. ومع أن هذا أداةٌ يستعملها كارهو الإسلام؛ لإنه قاطرةٌ نحو المسيحية واليهودية، ليصبحَ الصراع بين العَلمانية المستنيرة التقدُّمية والدِّين عمومًا.
لكن اليهودية والمسيحية تخلَّتا عن الحرفية والأصولية الدينية في الحكم، وأبرمَتا نوعًا من الاتفاق مع الدولة منذ العصور الأولى للحداثة. أما الإسلامُ فلم يبدأ إلا حديثًا في الدخول في «الميثاق العَلماني » الجديد للحُكم والتسيير.
وتمثِّل الكاتبة أيضًا بالثورة الإيرانية عام 1979 م، التي أحدثت قطيعةً نهائية مع الماضي؛ ليصبحَ الإسلام السياسي مؤثِّرًا في التاريخ المعاصر، تاركًا بصَماته الخاصَّة على اللاهوت السياسي. وهذا ما تجنَّبه اليسار الغربي الذي اعتمد على «لاهوت التحرير»، فلماذا لا يتكرَّر الشيءُ نفسه مع الإسلام السياسي المعاصر؟















