وثيقة: جهيمان والحاكمية.. قراءة في "رسالة الإمارة والبيعة والطاعة"
السبت 17/سبتمبر/2022 - 12:29 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
تتناول الوثيقة التي بين أيدينا الآن رؤية جهيمان العتيبي للإمارة والحكم وكيفية البيعة لولي الأمر والتي نشرت على الموقع الإلكتروني "منبر التوحيد والجهاد" وهي عبارة عن 26 صفحة إلكترونية، ويُكثر جهيمان فيها من الاستناد إلى الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية للتدليل على رؤيته في الخلافة، والتي تتطور فيما بعد إلى ظهور المهدي المنتظر، وتهتم الوثيقة والتي عنونها بـ "رسالة الإمارة والبيعة والطاعة وحمك تلبيس الحكام على طلبة العلم والعامة"- بتقديم تلك الرؤية والتي تشتمل على نقاط أساسية هي: مسائل الخلافة على منهاج النبوة، والملك الجبري، والبيعة الصحيحة والباطلة، والطاعة متى تجب ولمن تجب، ومسألة الخروج على الإمام وما جاء فيه، وما يعتقده في حكام المسلمين عامة، والمخرج من هذه الفتن.
ويسير الجهيمان الى حد كبير على خطى إمامه ابن تيمية وكذلك تأثره بشكري مصطفى وجماعته في مصر؛ مما أدى به في النهاية إلى الاصطدام بمؤسسة السلطة في السعودية وعلمائها حتى أستاذه ابن باز لم يسلم من هجوم جهيمان عليه لموالاته للسلطة السعودية، والجدير بالذكر هنا سذاجة الطرح الذي يقدمه جهيمان لمسألة الحاكمية رغم أن هذه القضية من أخطر القضايا التي تؤرق الدعاة والمصلحين. فقد تناولها الكثير من الفقهاء والأئمة بشكل أكثر علمية من تناول جهيمان لها؛ وهذا يرجع لمعلوماته القليلة، فليس عنده من هذه القضية إلا شذرات من العلم، وهذا ما يتضح في قرائتنا للوثيقة.
نقد الوثيقة:

يقول جهيمان في رسالته عن الإمارة: "واعلم أن غالب المنتسبين إلى الدين والزهد من بعد القرون المفضلة لا يهتمون بهذا الجانب..." يعني هنا الحاكمية ولا نستطيع فهم كلام جهيمان إلا إذا علمنا أنه يرى أن حكم المسلمين مر بأربع مراحل لا من حيث الواقع التاريخي أو الزمني فحسب، وإنما من حيث تحقق النص؛ ففي فصل الخلافة التي على منهاج النبوة والملك الجبري، أورد جهيمان حديث النعمان بن بشر والذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". ثم سكت.
هذا التسلسل الذي بنى عليه جهيمان فكره ومنهجه الحركي فهو لا يتناول الخلافة كموضوع قائم بذاته، وإنما يتناول الخلافة بشكل حتمي طبقا لهذا الحديث، بغض النظر عن التطورات السياسية والاجتماعية التي تطال الجماعة المسلمة وكذلك باقي الجماعات وعلاقاتهم بهذه الجماعة. فيقوم جهيمان بتطبيق هذا الحديث على أرض الواقع حتى يقول: "وإذا نظرت اليوم في تطبيق هذا الحديث على الواقع، رأيت أنا نعيش اليوم الملك الجبري، الذي ليس للمسلمين فيه هم الذين يختارون الخليفة وإنما هو الذي يفرض نفسه عليهم، ثم يبايعونه بيعة المجبرين عليها، ولا يترتب على عدم رضاهم بهذا الخليفة أنه ينعزل، كلا بل الأمر جبري، وأن حكام المسلمين اليوم لم يبايعوا الناس على ما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بالحق، حيثما كانوا ونصرة الدين، بل على نظام وقوانين ليس فيها من الشرع إلا ما وافق الهوى، وأما ما خالف فلا، والمقصود أنه ليس خلاف على منهاج النبوة". ومن خلال هذا النص يتضح لنا أن جهيمان يرفض بشكل قاطع ولا رجعة فيه المصطلحات الحديثة "كالديموقراطية مثلا" فهو لا يعترف سوى بالبيعة بشكلها على عهد الصحابة "بيعة أهل الحل والعقد" برغم أن الكثير من فقهاء الأمة المحدثين قاموا بمعالجة موضوع البيعة هذه، وأقروا نظم الحكم الحديثة وأنها لا تتعارض مع الإسلام في شيء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجده يتبنى آراء كل من سيد قطب والمودودي في مسألة الحاكمية وإن لم يصرح بذلك في تلك الوثيقة، فهو يرفض القوانين الوضعية؛ مما يؤدي في النهاية بإصدار أحكام بجاهلية المجتمع والحاكم، ونجد هذا أيضا متضمنا في وثيقته التي بين أيدينا، فهو يرفض العمل بالقانون الوضعي مدعيا أنه ليس بها من الشرع شيء.
الآخر في فكر جهيمان:
يمثل الآخر في فكر جهيمان عدة مستويات حسب القرب والبعد من منهج "السلفية المحتسبة" فإن كان يوالي بعض الجماعات بمقدار معين ويحابيهم كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ والدعوة أو أنصار السنة المحمدية رغم اختلافه معهم في أمور كثيرة تعد أمورا عقائدية، وكذلك بعض طلبة العلم إلا أنا نجده أكثر عنفا مع المخالف له في العقيدة مثل الآخر الشيعي والآخر المسيحي من غير مراعاة أن الأول يمثل له شريكا في الوطن نفسه، له حقوق المواطنة نفسها التي يتمتع بها وعليه الواجبات نفسها فيقول: "وامتازت دولتنا بقسط وافر من هذا التلبيس– منها ومن علمائها– والتي تسمي نفسها اليوم بـ "دولة التوحيد"، وإنما وحدت بين صفوف المسلمين والنصارى والمشركين، وأقرت كلا من دينه– كالروافض– وحاربت من خالف ذلك، وقاتلت من قاتل المشركين الذين يدعون عليا والحسين، وقد حاربت كذلك عبادة القبور والقباب وأرست قواعد عبادة الريال" وهنا يتناص مع ابن تيمية في رفضه للآخر المخالف معه عقائديا "مسيحيا كان أو غيره" ولكنه يتجاوز ابن تيمية بتكفيره للشيعة في المطلق دون أن يقدم أدلة شرعية على هذا التكفير؛ مما يوضح لنا في نهاية الأمر أن قدرات جهيمان المعرفية قليلة وليس لديه ما يؤهله لإصدار تلك الأحكام القاطعة. ولكنه في الوقت نفسه لا يترك مناسبة إلا وأشار فيها إلى رفضه للمسيحيين– النصارى– على حد قوله.
شروط الخليفة والخروج عليه:

يؤكد جهيمان في رسالته على ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الخليفة الذي يرجوه ويقدمه للمسلمين كافة وهي:
1- أن يكون مسلما.
2- أن يكون من قريش.
3- أن يكون مقيما للدين.
ويستند في تقديم هذه الشروط إلى مجموعة أحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم رواها البخاري ومسلم، وبغض النظر عن صحة تلك الأحاديث من عدمها فإن تلك الشروط التي يسوقها جهيمان لا يقبلها المسلمون في هذا العصر، فقد اختلف العلماء خصوصا حول الشرط الثاني وهو أن يكون الخليفة "قرشيا" والجدير بالذكر هنا أن جهيمان لم يتجاوز تلك الآراء التي سيقت عن الخلافة في القرن الثاني الهجري وشروط الخليفة، رغم أن هناك الكثير من الفقهاء والأئمة قاموا بتطوير هذه الشروط وتنقيحها في كل عصر حيث يكون الفقه موافقا لطبيعة العصر المعيش.
ومن هذه الشروط يصل جهيمان إلى عدم الاعتراف بحكام المسلمين ويدعو للخروج عليهم؛ لأسباب عدة، منها:
1- أن الحكام ليسوا من قريش.
2- أنهم لا يقيمون الدين، بل يهدمونه ويحاربون أهله. من وجهة نظره.
3- أنهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد ونصرة القلب وطوعه واختياره، بل بالجبر والقهر. على حد قوله.
وبهذا حسب رأي جهيمان تسقط بيعتهم وبالتالي تسقط طاعتهم؛ مما يدعو إلى الخروج عليهم ليس فقط بشكل سلمي بل بمحاربتهم.
وأما من يخرج على الإمام الشرعي حسب شروط جهيمان لشرعيته فهو عند "عاص، معتد، ظالم، يجب قتله وردعه عن ظلمه". ويتفق هذا مع معظم الجماعات التكفيرية المنتشرة في عالمنا العربي والإسلامي الآن فمن هو خارج عن الجماعة خارج بالتالي عن الملة، ليس هذا فقط بل من خرج عن الأمير وجب قتله.
نص الوثيقة:
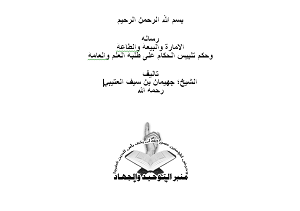
"بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة
الإمارة والبيعة والطاعة
وحكم تلبيس الحكام على طلبة العلم والعامة
تأليف
الشيخ؛ جهيمان بن سيف العتيبي
رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرشد عباده فقال: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب * وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار * كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي يقول: (... وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) [رواه ابن ماجه والحاكم، وهو صحيح].
فقد بين الله في هذه الآيات وصفين للخليفة، وهما؛ أنه يحكم بين الناس بالحق، والثانية؛ أنه لا يتبع هواه.
وبهذا تعرف؛ إن هذا واجب الخليفة الذي لابد أن يقوم به، فأما من نبذ الحكم بالكتاب والسنة وراءه ظهرياً واتبع هواه ولم يحكم في الناس بشرع الله؛ فقد ضل عن سبيل الله لأنه نسى موقفه بين يدي الله عز وجل حينما يحاسب، لذلك قال الله: {لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب}.
ثم تدبر الآيات؛ تجد كيف أنكر الله عز وجل على من لا يفرقون بين من يسعى لإقامة دين الله ونصرته والإيمان والعمل الصالح، وبين من يريد إقامة سلطانه ويسعى في الأرض فساداً، لا شك إن أولئك هم المتقون، والآخرون هم الفجار.
وإذا تأملت الحديث، ونظرت في الواقع؛ رأيت أنه قد حصل العمل والنتيجة، فحينما لم يحكم هؤلاء الحكام بكتاب الله ولم يتحروا فيما انزل الله؛ وقع البأس فيما بين المسلمين، فكثرت الفرقة والاختلاف وأصبح بعضهم يسعى لإبطال ما عند الآخر وتفرقوا شيعاً وأحزابا، والله قد نهاهم عن ذلك، ولكن هذا كله من ثمرة تعطيل الحكم بكتاب الله وتحري ما أنزل الله.
واليك الآن؛ بيان ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلافة التي على منهاج النبوة، والملك الجبري، والبيعة الصحيحة والباطلة، والطاعة متى تجب ولمن تجب، ومسألة الخروج على الإمام وما جاء فيه، وما نعتقده في حكام المسلمين عامة، والمخرج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي نعيش فيها اليوم.
فأقول وبالله التوفيق، ونستمد منه العون لأن يوفقنا في هذه المسألة لقول الحق الذي لإيراد به إلا وجهه، وان يسلمنا من الاستنصار للأنفس أو الخوف من غيره الذي يمنعنا أن نقول بالحق الذي قد ضاع بسبب إسناد الأمر إلى غير أهله، وهذا هو أصل إضاعة الأمانة وقد كنت أبتعد عن الكلام في الحكم ومسائل التكفير، أما الآن فقد أجبرت لدفع التهمة عني وعن اخواني، ولبيان الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أعلم؛ أن مسألة الإمارة والخلافة والولاية على تنوع أسمائها مكانتها عظيمة، ولا تجتمع صفوف المسلمين وتقوم بما لها وما عليها من الحقوق إلا بذلك، ألا وهي القيادة التي تجمع كلمتهم، وتنقسم القيادة إلى قسمين؛
قسم؛ يقود بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا مال أُقيم بالكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا مال غيره أقامه بالكتاب والسنة، فهذا لا خلاف في وجوب طاعته.
والقسم الآخر؛ لا يقود الناس بكتاب الله ولا يبايعهم على نصرة دين الله، وإنما يقول ولا يفعل ولا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته، وكثيراً ما يكون في الملك الجبري، فهذا لا بيعة له ولا طاعة، حتى لو حكم له بالإسلام - كما يأتي البيان فيما بعد إن شاء الله تعالى -
وقال الله تعالى: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين}، فجعل الله العاقبة والدار الآخرة للمتقين الذين لا يقصدون العلو والفساد وإنما يسعون لإعلاء كلمة الله وتمكين دين الله في الأرض ليكون ظاهراً على الدين كله ولو كره المشركون، وكانوا وسطاً بين فريقين:
الأول؛ يريد السلطان والعلو في الأرض ولا يقيم الدين، مثل فرعون ومن تشبه به.
والفريق الآخر؛ يريد الدين بلا سلطان، فيكون دين مسكنة ومذلة تحت الذين يريدون العلو والفساد، فهؤلاء لا يسعون لإقامة الجهاد، ولا يحبون ذكره؛ لما في قلوبهم من الذلة، وهذه شعبة من شعب النصرانية، وصفة من صفات النصارى أهل الرهبانية والصوامع.
أما الذي رضيه الله لنا وأمرنا به؛ فهو نصر دينه حتى يكون ظاهراً على الدين كله، قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}، وقال: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من يعد خوفهم آمنا * يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون * لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير}.
فالطائفة المنصورة التي على حق؛ هي التي سلمت من هاتين الطائفتين - أهل العلو والفساد، وأهل الذلة والمسكنة -
قال ابن تيمية رحمه الله: (وهاتان السبيلان الفاسدتان؛ سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأولى الضالون؛ وهم النصارى، والثانية المغضوب عليهم؛ وهم اليهود، وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) [الفتاوى: ج28/ص348].
وقد تقدم لك في الآيات قول الله: {ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا}، فدل على أنهم قبل التمكين كانوا في خوف ومخافة، ولذا ترى أهل الذلة والمسكنة - الذين سلك مسلكهم كثير من الدعاة اليوم - يريدون الدعوة إلى الحق تسير بلا أذى، وهذا باطل، وأشد من ذلك أن يروا أن في هذا حرجا ومشقة، فخالفوا قول الله: {وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}، فأمرنا بالجهاد والمجاهدة، وأخبر أنه رفع عنا الحرج، فكان الحرج كل الحرج في ترك الجهاد وعدم إقامة الدين.
وأعلم؛ أن غالب المنتسبين إلى الدين والزهد من بعد القرون المفضلة لا يهتمون بهذا الجانب، الذي هو قيام السلطان مع الدين، إلا أن يكون ذلك بالدعاء للظلمة بالصلاح، لأنهم ليس لهم استعداد لأن يقيموا الدين من الجانبين - ألا وهو جانب المجاهدة بالحجة من الكتاب والسنة وبيان سبيل المجرمين والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى، وجانب القسوة التي تحملهم على أقامة الجهاد ونصرة دين الله وإقامة دولة الإسلام - بل تجد كثيراً من هؤلاء يميلون إلى تكميل أحد هذين الجانبين دون الآخر، فيعيشون بمنزلة الأيتام الذين كلما مات لهم ولي بحثوا لهم عن ولي آخر!
وهذا هو السبب الذي صرف الكثير من الناس الذين يحبون العزة ويكرهون الذل عن الدين، لما رأوا رجال الدين في هذه الذلة التي توارثوها، والسلطة والقوة في أيدي غيرهم، أما لما كانت القوة في أيدي أهل الدين الحقيقيين - وهم الأمراء العلماء - دخل في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان على عهده، وفتح من البلاد أكثر مما فتح في عهده.
فلما تغيرت الأحوال ووسد الأمر إلى غير أهله وصار الدين تعبداً ومسكناً؛ وجد من يريد العلو في الأرض على الناس سبيلاً لتنفيذ مقصده، وخلا له المجال، ولم يجد من يبين للناس باطله ليحذروه.
ومن عجز عن دفع الباطل بلسانه فلن يستطيع دفعه بالسيف.
وأخذ صنف من المتدينة بشعبة من شعب النصرانية، ألا وهي الرهبانية، فتجدهم عباداً بالمساجد ينفق عليهم وتبنى لهم الرباطات، حتى أن بعضهم يدخلها وهو شاب ويموت فيها وقد شاخ.
والصنف الثاني؛ عاش تحت أيدي من مضى ذكرهم، يبايعونهم ويسكتون عن باطلهم، وربما أخذوا شيئاً من دنياهم وبنوا بها رباطاً أو مسجداً، حتى يقال؛ "بنى على نفقة الشيخ فلان"، فنقول لهذا الشيخ: من أين اكتسبت هذا المال؟! هل هو من الفتوحات وإخراج الكفار من جزيرة العرب أم بالعكس بإدخال الكفار مع المسلمين ورفع أعلامهم في جزيرة العرب وقتال من يريد أن يطهر جزيرة العرب من المشركين، ويريد منع الكفار من الدخول، وبتسميتك له "خارجي" أو من "أهل البغي" وبسكوتك عن شيء من الحق اذا خالف سياسة من تعيش تحت أيديهم وتدعو لهم على المنابر؟! ولكن إنما يتقبل الله من المتقين.
وهذا الصنف الأخير؛ فيه شبه من أحبار اليهود الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
فهذا الصنفان هما سبب هدم دين الإسلام وصرف الناس عنه.
وقد لحق بهذين الصنفين المتقدمين من يسمى في عصرنا هذا "المطاوعة" و"المرشدون"، فترى "المطوع" يسير خافضاً رأسه عن مساوئهم، ويتظاهر أن خفضه رأسه من الدين والورع! وهو في الحقيقة من الذل والمسكنة! لأنه لم يفهم منزلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها أخرجت لتغير المنكر لا لتغض الطرف عن المنكر، وهؤلاء اتخذوا من أهل المنكر بمنزلة الوالد، فهم يخفضون لهم جناح الذل من المسكنة، وتجد المنافقين يثنون عليهم ويسمعونهم الثناء، ويقولون: "فلان دينه زين"، لأنه لا ينكر المنكر!
وأما "المرشدون"؛ فيتكلمون في العبادات كالصلاة والصوم والحج، وأما الأصل - وهي ملة إبراهيم عليه السلام ومقاطعة أهل الباطل والتبري منهم وإنكار المنكر - فإنهم لا يتطرقون إليه، لأنه يبين مخازيهم ومخازي من يعيشون تحت أيديهم، وإن اخطأ من لا سلطة في يده؛ شنعوا عليه! وأما القضاة ومشايخ المحاكم؛ فلا داعي للتطرق إليهم لأنهم قد لحقوا بالسلاطين - وقد بسطت هذا الموضوع أكثر في مختصر "رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ورسالة "رفع الالتباس"، بالأدلة فراجعه -
الموقف الحق مع الحكام خاصة والناس عامة:
ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (... وعلى أن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم).
فمن هذا يجب على المسلم أن يقول كلمة الحق لا يرده عن قولها رغبة أو رهبة.
وأعلم أن الناس في معاملتهم للحكام والملوك خاصة؛ كثيرا ما يسكتون عما عندهم من الباطل - رهبة وخوفاً منهم - فصاروا يخافون لوم اللائم في القول بالحق وإنكار المنكر، وهذا ضلال مبين وقع فيه الكثير.
وقابلتهم طائفة؛ ابغضوا الحكام، فاشتعلوا بمساوائهم وحملهم ذلك على عدم الاعتراف لهم بالحق إذا أحسنوا.
أما هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به، فهو كما قال: (... واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء) - وسيأتي هذا الحديث بكامله إن شاء الله -
وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعلمون}.
وإنما يقع في عدم العدل من مال إلى بغض أو خوف أو محبة ونحو ذلك من هوى النفس، فهذا ليس سوياً في مشية على الصراط المستقيم، وإنما ينجو من كان سوياً في نفسه ليس مائلاً إلى هوى، ثم كان يسير على طريق هدى ونور، قال الله تعالى: {أفمن يمشي مكباً على وجه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم}، والمكب على وجهه هو الجاهل الأعمى الذي لا يبحث ولا يتبصر، والسوي هو الذي قد استوى فلا ميل عنده إلى شدة حب أو شدة بغض أو شدة خوف، فليس لنفسه نصيب، إنما مريد للحق، والذي على صراط مستقيم هو الذي على علم وبينة، فإذا أجتمع الاستواء من النفس والطريق عدل ومستقيم ورآه الإنسان؛ فانه ينجو بإذن الله.
والطريق المستقيم؛ هو الكتاب والسنة، ومن أخذ بهما ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
لذلك قال: (تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) [رواه مالك والحاكم، وهو حديث حسن].
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: (ثلاث منجيات، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية) [رواه الطبراني في الأوسط، وهو حسن].
فلا بد من أن يعدل الإنسان في حكمه في رضاه وغضبه، وإلا فسيميل به الهوى عن الصراط المستقيم، ولذلك رأيت هاتين الفرقتين، كيف أضل تلك الخوف والرجاء من الحكام، وأضل الأخرى البغض والكراهية.
وقد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، فقال: (فهذا قسم كثر في دول الملوك إذ هو واقع فيهم وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم، أعني أهل زمانهم، وبسببه نشأت الفتن بين الأمة، فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوا من الأمور المنهي عنها فذموهم وأبغضوهم، وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم، ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات، والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات) [الفتاوى: ج35/ص30].
وأعلم أن بعض أصحاب المداهنات مع الملوك والحكام يحتجون بحديث مسلم، حينما سأل رجل فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ قال: (اسمعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ماحملتوا)، وحديث: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها)، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: (أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم).
فلا ينكرون على الحكام، ويحتجون بهذا.
وليس لهم في هذا حجة، فإن هذا الحديث - وما في معناه - في مسألة حقوق النفس - كاستئثار الحكام بالغنيمة أو الفيء ونحو ذلك - أما الدين؛ فليس من حقوق النفس التي يصبر على الأثرة فيها، ولذلك ترى في الحديث أنهم سألوا قالوا: (يمنعونا حقنا)، فأما إذا كان الحق لله؛ فلا إذ الواجب الإنكار على من لا يقيم شرع الله عز وجل.
فصل
الخلافة التي على منهاج النبوة والملك الجبري
- الحديث الأول:
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة)، ثم سكت [رواه أحمد، وهو حسن].
- الحديث الثاني:
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم)، وفي رواية: (وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلا تروا كفراً بواحاً عندكم من الله في برهان).
- الحديث الثالث:
وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أُمر عليكم عبداً مجدع يقودكم بكتاب الله؛ فاسمعوا له وأطيعوا) [رواه مسلم].
- الحديث الرابع:
قال اسعد بن زرارة عند بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: (رويداً يا أهل يثرب! إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فأما أنتم تصبرون على ذلك؛ فخذوه وأجركم على الله، وأما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة؛ فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله) [رواه أحمد والبيهقي، وهو صحيح].
تبين من هذه الأحاديث؛ أن هناك خلافة على منهاج النبوة وملكاً عاضاً وملكاً جبرياً، وأن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة على منهاج النبوة، وبعدها يكون الملك العاض ثم الملك الجبري، ثم تعود الخلافة التي على منهاج النبوة.
والخلافة التي على منهاج النبوة؛ هي التي تكون البيعة فيها ما تبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتجد في الحديث الثاني والرابع أمرين هامين يغفل عنهما الكثير من الناس اليوم، وهما:
أولاً: أنهم بايعوه على أن يقولوا بالحق أينما كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم.
ثانياً: أن بيعتهم كانت لنصرة دين الله والجهاد عليه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وبلا شك أن هذا يستلزم قتل خيارهم ومفارقة الناس وعض السيوف.
وإذا نظرت اليوم في تطبيق هذا على الواقع؛ رأيت أنا نعيش اليوم في الملك الجبري، الذي ليس المسلمون فيه هم الذين يختارون الخليفة وإنما هو الذي يفرض نفسه عليهم، ثم يبايعونه بيعة مجبورين عليها، ولا يترتب على عدم رضاهم بهذا الخليفة أنه ينعزل، كلا بل الأمر جبري، وأن حكام المسلمين اليوم لم يبايعوا الناس على ما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بالحق حيثما كانوا ونصرة الدين، بل على نظام وقوانين ليس فيها من الشرع إلا ما وافق الهوى، وأما ما خالف فلا، والمقصود أنه ليس خلافة على منهاج النبوة.
وهذه لفتة عابرة إلى أن هذا الملك ليس على منهاج النبوة.
وأما وجوه بطلان بيعتهم التي يترتب عليها عدم وجوب طاعتهم؛ فتاتيك إن شاء الله قريباً، مع انه لا يلزم من بطلانها تكفيرهم، بل هم مسلمون بيعتهم باطلة شرعاً بالأدلة من الكتاب والسنة، وأن ثبت على أحد منهم الكفر؛ حُكم عليه أنه كافر، وإلا فالأصل فيمن يظهر الإسلام؛ أنه مسلم حتى يعمل ما يوجب ردته عن الإسلام.
فصل
في شروط الخليفة والإمام الذي تجب بيعته وطاعته
إعلم أن من يكون خليفة على المسلمين وإماماً لهم، يُشترط فيه شروط:
الأول: أن يكون مسلماً، والدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، أي من المسلمين.
الثاني: أن يكون من قريش.
الثالث: أن يكون مقيماً للدين.
ودليل هذين الشرطين؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأمراء من قريش ما أقاموا الدين).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجه ما أقاموا الدين) [رواه البخاري].
وقوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان) [متفق عليه].
وما يدل على اشتراط إقامة الدين؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا) [رواه مسلم].
فجعل شرط السمع والطاعة أن يقودنا بكتاب الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين؛ لم يبق فيهم.
- وأعلم أنه يشكل على بعض الناس في اشتراط القرشي حديث: (وإن تأمر عليكم عبد حبشي)!
والجواب:
أن لفظة "تأمر"؛ غير موجودة في الأصول، بل جميع ألفاظ الحديث بلفظ: "وإن أُمر"، "وإن اُستعمل"... ونحو ذلك، أي إذا كان مؤمراً من قريش، أما الخليفة والإمام فلابد أن يكون قرشياً.
وعلى هذا لا يجوز عقد البيعة لمن لم تتوفر فيه هذا الشروط.
وبهذه الشروط تتم البيعة الشرعية، وقد تقدم لك ما بايع عليه الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي البيعة التي جاء الوعيد الشديد على من لم يفعلها.
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعه؛ مات ميتة جاهلية) [رواه مسلم].
وأمر آخر في البيعة لا بد منه؛ وهو أن تتم من المبايع بصفقة اليد وثمرة القلب، أي بطوع واختيار.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر) [رواه مسلم].
واليوم إنما يحكم المسلمين الملك الجبري، الذي ليس مبنياً على البيعة، وقد خالف شرع الله في عدة أمور منها:
1) أن الحكام فيه ليسوا من قريش.
2) أنهم لا يقيمون الدين، بل يهدمونه ويحاربون أهله.
3) أنهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد ونصرة القلب وطوعه واختياره، بل بالجبر والقهر.
وبهذا تعرف عدم وجوب بيعتهم وطاعتهم.
وأما طاعتهم في غير المعصية؛ فجائز، ولا دليل على أنها تحرم في غير المعصية، لأن الأمر جبري، وليس محرماً شرعاً، مع أن الأولى - والذي دل عليه الشرع -؛ هو اعتزالهم، لأن وجودهم هلاك للدين وهدم للحق وإحياء للبدعة وإطفاء للسنة، وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتزال حينما ذكر غلمة من قريش يهلكون الناس.
فقال صلى الله عليه وسلم: (هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش)، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (لو أن الناس اعتزلوهم) [رواه البخاري ومسلم].
واعلم أنه قد جاء في الشرع؛ أنه لا يكون على المسلمين إلا خليفة واحد، فإن بويع لآخر؛ قتل الآخر.
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) [رواه مسلم].
وأما اليوم؛ فالمسلمون غير مجتمعين على أمام واحد، بل كل دولة عليها وآلي، ولا تستطيع أن تحكم لهم بغير الإسلام حتى يفعل الواحد منهم ما يرتد به عن دينه فيحكم له بالكفر، أما من لم يظهر فيه ذلك؛ فيحكم له بالإسلام كما يحكم للمنافقين بالإسلام مع إنهم في الدرك الأسفل من النار، وما اشبه هؤلاء الحكام بالمنافقين، فتراهم - مع إظهارهم الإسلام - يوالون الكفار والمشركين، ولكن طائفة وآلت وصالحت اليهود، وطائفة وآلت الشيوعية، وطائفه وآلت وصالحت النصارى وآوت المشركين من الشيعة والروافض.
فكل من هذه الدول الإسلامية؛ له نصيب من إظهار الإسلام وله نصيب من موالاة الكفار، وإنما اختلفوا في اتجاهاتهم، وكلهم متفقون على محاربة الحق وأهله إذا خالف سياستهم وسياسة من يوالونهم من أعداء الإسلام، وتستطيع في كل واحدة من هذه الدول أن تدعو إلى جانب من الحق لا تستطيع أن تدعوا إليه في الأخرى.
وإنما يعيش المسلمون تحت حكام جبريين، لا يقيمون فيهم الدين.
أما من خرج من الطاعة؛ فأنت تعلم أن الطاعة لا تجب إلا لمن يقودنا بكتاب الله، أما من يقود المسلمين بالأنظمة المختلفة والقوانين ولا يأخذ من الدين إلا ما وافق هواه، فهذا لا سمع له ولا طاعة، وقد عرفت بطلان بيعته فيما تقدم.
والوعيد على من خرج من الطاعة؛ هو على من دخل في الطاعة ثم خرج منها، فأما من لم يبايع ولم تجب عليه طاعة أصلا؛ فهذا لم يخرج من الطاعة.
تنبيه:
أعلم أنه قد ضل كثير من الناس بأسباب الجهل في اعتقادهم؛ أن من يخرج على الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون يحكم عليه بأنه "خارجي"، وإن كان معه طائفة بأنهم "خوارج"!
وهذا خطأ واضح، فإن الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويُخرجون من الإسلام أهل المعاصي، ويتشددون في الدين بغير ما أنزل الله، وقد اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الذين إذا فعل الرجل معصية؛ حكموا عليه بأنه كافر مخلد في النار، ومذهبهم معروف - نبرأ إلى الله منه ومن أهله -
وأما الذي يخرج على إمام المسلمين ويقاتله؛ فهو عاص، معتد، ظالم، يجب قتله وردعه عن ظلمه.
وإنما نبهنا على هذا؛ لأن كثيراً من الناس يحكم على هذا بحكم الخوارج، مع الفرق الكبير بين مذهب الخوارج وبين من يخرج من طاعة الأمام، فمذهب الخوارج؛ كفر، والخروج على الإمام ومنازعته؛ ظلم يجب ردع صاحبه عنه وقتله، والخارج من طاعة الإمام الشرعي؛ عليه وعيد شديد بأن ميتته جاهلية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا.
واعلم أن هذا الخطأ له اصل قد اخطأ فيه بعض فقهاء المذاهب من قبل، كما ذكر ابن تيمية وبين خطاهم أيضاً في حكمهم على من لا يبايع الإمام أو يخرج من طاعته بأنهم بغاة ويحكمون عليه بحكم الخوارج، مع أن الذي جاء في السنة في حق من ينازع إمام المسلمين؛ الخلافة، أنه يقتل، وأما من لم يبايع أو خرج من الطاعة؛ فإنما عليه وعيد شديد - كما تقدم - وليس من دليل على قتله وقتاله.
وإليك كلام أبن تيمية قال رحمه الله: (... وهذا يعني الحكم على من خرج عن الطاعة بحكم الخوارج، تجده في الأصل من رأى بعض فقهاء الكوفة واتباعهم، ثم الشافعي وأصحابه ثم كثير من أصحاب أحمد؛ الذين صنفوا في باب قتال أهل البغي نسجوا على منوال أولئك؛ تجدهم هكذا، فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن، وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب، والمصنفون في الأحكام؛ يذكرون قتال أهل البغي والخوارج جميعاً، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع، وهو حديث موضوع - أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم - وكذلك في ما أظن؛ كتب مالك وأصحابه ليس فيها باب قتال البغاة، وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء، وهذا هو الأصل الثابت بالكتاب والسنة، وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة - يعني الخوارج - فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة أمام معين - يعني الذي لا يبايع، أو يبايع ويخرج عن الطاعة - فليس في النصوص أمر بذلك) [الفتاوى: ج4/ص450] اهـ.
فصل
في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكام المضلين والسر الذي في آخر الزمان
والمخرج من ذلك
- الحديث الأول:
عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قال: قلت: يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم)، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم وفيه دخن): قلت: وما دخنه، قال: (قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر)، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها)، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) [متفق عليه].
- الحديث الثاني:
عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون هدنه على دخن، ثم تكون دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في خليفة فألزمه، وإن نهك جسمك واخذ مالك، وان لم تره فاضرب في الأرض، ولو أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة) [رواه أحمد وابو داود، وهو حديث حسن].
- الحديث الثالث:
عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعدد ستاً بين يدى الساعة؛ موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم إستفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا تدع بيتاً من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنى عشر ألف) [رواه البخاري].
- الحديث الرابع:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: (هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء؛ دخنها من تحت قدمي رجل يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أؤليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء؛ لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمه، فإذا قيل إنقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسى كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلك؛ فانتظروا الدجال من يومه أو من غده) [رواه ابو داود، وهو حديث صحيح].
- الحديث الخامس:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عنكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم؛ فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل) [رواه الحاكم والطبراني، وهو صحيح].
- الحديث السادس:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ويحدثون البدع)، قلت: فكيف اصنع؟ قال: (تسألني يا أبن أم عبد كيف تصنع؟! لا طاعة لمن عصى الله) [رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح]، وفي لفظ عند أحمد وابن ماجه: (سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها).
- الحديث السابع:
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم؛ فلا يكونن عريفاً، ولا شرطياً ولا جابياً ولا خازناً) [رواه ابن ماجه، وسنده صحيح].
- الحديث الثامن:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فكان من خطبته أن قال: (ألا أني اوشكت أن أدعى فأجيب، فيليكم عمال من بعدي يقولون ما يعلمون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهراً، ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعملون، ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وشد على اعضادهم؛ فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسئ) [رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في "الزهد الكبير"، وهو حديث صحيح].
- الحديث التاسع:
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويتعبدون بأمره، ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن، فمن جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) [رواه مسلم].
- الحديث العاشر:
عن معاوية رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتهافتون في النار، يتبع بعضهم بعضاً) [رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" وأبو يعلى، وهو حديث صحيح].
أعلم يا أخي؛ أن هذه الأحاديث الصحيحة يزداد بها المؤمن بصيرة بالواقع الذي يعيش فيه في هذا الزمان، إذ فيها بيان صفة أمراء السوء، وتحديد الموقف الذي يجب أن نتخذه معهم ومع الناس الذين في زمنهم ما يثبت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في اخباره بالمغيبات التي نراها اليوم أمام أعيننا، وقد ذكرنا الحديث الثالث والرابع في "رسالة الفتن" - الموجودة في "السبع الرسائل" - ويتضح المعنى بالأحاديث التي ذكرناها هناك، والتي يطول بنا ذكرها هنا، والمقصود انك تجد هناك في الحديث [9 و14، ص 16 – 17].
وإليك نصها:
1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلى بينكم وبين اخواننا، فيقاتلونهم، فيهزم ثلثهم لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً، فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان؛ أن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم - عليه أفضل الصلاة والسلام – فأمهم، فإذا رآه عدو الله؛ ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لا نذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته) [رواه مسلم].
2) عن يسير بن جابر، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري ألا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة! قال: فقعد وكان متكئاً، فقال: (إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه)، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: (عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام)، قلت: الروم تعني؟ قال: (نعم، ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفئ هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع؛ نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتتلون مقتلة - أما قال: لم يرى مثلها - حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاً، فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك، إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ؛ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم والوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ) [رواه مسلم].
فتجد في هذين الحديثين؛ أن خروج الدجال يكون قبله غدر الروم والقتال، وهنا في الحديث الثالث - حديث عوف بن مالك - تجد فيه ذكر غدر بنى الأصفر - وهم الروم، أي النصارى - وأن قبل هذا الغدر؛ الهدنة.
وفي الحديث الرابع - حديث ابن عمر -؛ تجد فيه ذكر الدجال وقرب خروجه بعد "فتنة الدهيماء"، التي تكون بعد اصطلاح الناس على رجل، وهذا الاصطلاح المراد به الهدنة التي تكون قبل الغدر والدجال - كما بينا في "رسالة الفتن" –
و "فتنة الدهيماء"؛ هي التي يصبح فيها الرجل مؤمناً ويمسى كافراً، وهي التي لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمه، وهي التي تكون بعد اصطلاح الناس مؤمنهم وكافرهم على هذا الرجل - الذي هو الملك عبد العزيز - كما يتبين لك من الحديث، وراجع "رسالة الفتن" يتضح لك الأمر أكثر، وبعد هذا الاصطلاح وهذه الهدنة التي فيها دخن - أي التي ليست صافية من الشر - تكون دعاة الضلالة، كما يتبين لك من حديث حذيفة الثاني: (تكون هدنة على دخن، ثم تكون دعاة الضلالة)، ودعاة الضلالة هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها، والذين تجدهم في الحديث الأول.
وقد ذكر قبلهم في الحديث الثاني؛ "الدخن"، الذي ذكره أيضاً قبلهم في الحديث الأول، حيث قال: (نعم، وفيه دخن)، قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر).
فإنك تجد هذا الوصف منطبقاً على الناس اليوم، فكم من الجماعات وكم من الدعاة الذين يدعون الناس ويهدون، ولكن بغير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنته، بل الذي ينصر ويحيي السنة منهم قليل، وتعرف منهم أموراً وتنكر منهم أخرى.
وهذه الصفه فيهم واضحه من حين استقر حكم الملك عبد العزيز في الجزيرة، حيث تجد الناس على جهل كبير بالسنة، وتجدهم يهدون ويدعون إلى الدين ولكن بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف منهم أموراً وتنكر منهم أخرى، وهذا فيهم واضح جلي لمن عرف الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الذي يعتمدون عليه في هداية الناس ودعوتهم وفي تغيير المنكر والأمر بالمعروف يميل إلى الشدة والتنفير والغلظة، ويستحسنون هذا مجرد استحسان، وإلا فليسوا فيه على سنة ثابتة، ولذلك تراهم حينما ساروا على غير سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ما كانوا عليه، بل عاد أمرهم في آخره إلى التراخي والمداهنة والسكوت عن المنكر حتى خلا المجال للشر وأهله.
هذا، وأما الحكم والملك الذي في وقت هذا الخير الذي فيه دخن وبه كانت الهدنة التي على دخن؛ فدخنه واضح أيضاً مع موالاة الكفار والمشركين، ومع هذا ترفع راية التوحيد ويُقتل من أهل التوحيد من طالبوا بمواصلة الجهاد في سبيل الله! ولكن ضعفاء البصائر - لقلة علمهم - يرون الخير من قيام دولة الإسلام ورفع راية التوحيد، ولا يرون دخنه من تعطيل الجهاد وموالاة النصارى للمصالح الدنيوية.
وبهذا تفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (غير الدجال اخوف على أمتي، الأئمة المضلون) [رواه أحمد، وهو صحيح].
فوالله للدجال أهون علينا منهم، فإن الدجال ظاهر أمره، أما هؤلاء فملتبس أمرهم على كثير من الناس بأسباب من يعيش تحت أيديهم من مشايخ المداهنة والمعاش والرواتب والمراتب، وبأسباب من يدعو إلى الله على جهل وضلال، فيهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بغير سنته.
وبعد هذا كله؛ فهل تجب طاعة هؤلاء الأئمة المضلين الذين هم أخطر من الدجال، وتجب مبايعتهم؟! نعوذ بالله من الجهل والهوى.
وإذا تبين لك هذا كله، ونظرت في الأحاديث الباقي؛ة عرفت كيف تنطبق عليهم، وماذا يجب علينا تجاههم.
ففي الحديث الخامس؛ ترى كيف يعرفوننا ما ننكر وينكرون علينا ما نعرف، والموقف معهم: (لا طاعة لمن عصى الله).
وكذلك في الحديث السادس؛ وصف ينطبق على كثير من أمراء هذا الزمان، ومن انطبق عليه فالموقف هو نفس الموقف؛ (لا طاعة لمن عصى الله).
وفي الحديث السابع؛ تزداد بصيرة لانطباقه على كثير منهم؛ (يقربون شرار الناس)، و (يؤخرون الصلاة عن مواقيتها)، والموقف؛ تحريم العمل عندهم عريفاً - أي أميراً - أو شرطياً أو جابياً أو خازناً.
والحديث الثامن؛ هو الذي يجلي لك حقيقة أمرهم، وهو أنهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، فأقوالهم وأعمالهم مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهلهم بالسنة وعدم تعلمهم لدين الله تعالى، ثم أخبر فقال: (فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم؛ فأولئك قد هلكوا وأهلكوا)، وهذا يدل على الوعيد الشديد على من شد على أعضادهم ووازرهم وناصحهم.
وإن كان بعض أهل الأهواء أو غيرهم من الجهال يجادلون ويقولون؛ نحن لا نشد على أعضادهم! فنقول لهم: هل قمتم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء، فالشهادة ظاهرة وليست مختفية في القلب، فهل يوماً من الأيام قلت؛ أيها الموظف للرئيس أو الأمير أو الوزير أو الملك أنت مسيء في هذا العمل المخالف للشرع؟ وهل نهيتم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يعمل شرطياً أو أميراً أو جابياً أو خازناً عند أمير يقرب شرار الناس ويؤخر الصلاة عن مواقيتها أم لا؟ وهل عملتم بما جاء في الحديث التاسع؛ عن المجاهدة باليد واللسان والقلب؟
الواقع؛ انكم بخلاف هذا كله، لا سيما من كان من أهل العلم، فبأسباب معصيته في الشد على أعضادهم اغتر به من يقتدي به من عامة المسلمين، وإلا فوالله لو أن المرشدين كما زعموا في دار الأفتاء والحرس والجيش وغير ذلك؛ بينوا تحريم هذه الأعمال عند أولئك الأمراء، لتبصر الكثير من محبي الخير ولعرفوا دينهم وأرضوا ربهم، ولكن والله لو فعلوا؛ ما تركهم هؤلاء الأمراء - الذين لم يستقيموا لا في العلم ولا في العمل - ما تركوهم ليلة واحدة وهم تحت أيديهم في أحسن المساكن وأفخم المراكب، ولكن الله المستعان.
وبهذا ترى صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (فأولئك قد هلكوا واهلكوا).
وقد رأينا حينما ننصحهم؛ انهم يحتجون علينا بالشيخ عبد العزيز بن باز وأمثاله، فنقول؛ المعروف عن الشيخ - حفظه الله وعافاه - أن انكاره غالباً إنما هو جواب عن السؤال إذا سئل، أما أن يبادر إلى إنكار المنكر - مع انه ركن من أركان الدولة - فذاك لو أنهم أبقوا مكانته عالماً يعلم الناس الخير، لكن إنما هو الآن موظف إداري، ويخدعونه بـ "أبونا" و "والدنا" و "شيخنا" وغير ذلك من إطراءات المنافقين، وإنما يأخذون منه ومن علمه ما وافق أهواءهم، فإذا خالفهم بالحق لم يتحرجوا في مخالفته ورد الحق، وهو يعلم ذلك جيداً، نسأل الله أن يزيدنا وإياه بصيرة.
ونحن نعلم أنهم إنما جعلوا في مثل هذه المنزلة؛ الشيخ ابن باز وأمثاله ممن يثق الناس بدينهم وعلمهم، اختاروهم من غير المبصرين لئلا يروا كثيراً من المنكرات، وإذا لاقوهم تدهنوا بالطيب وقبلوا جباههم وداهنوا معهم ونافقوا حتى يزيلوا ما في أنفسهم إن كان قد وصل إليهم شيء من أخبارهم السيئة، ولكن هذه من مداخل الشيطان التي يدخل بها على من يقتدي الناس به من علماء المسلمين؛ ليضلوا ويُضلوا.
وإن كان هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تستصعبه ويكبر على النفوس الدنيوية التي تعلقت بالوظائف الحكومية ورأت أنها مصدر الرزق الوحيد، مع أنهم لا يعيشون فيها إلا على حساب الدين بالمداهنة وعدم إنكار المنكر من جلسائهم ورؤسائهم والقوانين والمواد والأنظمة التي يسيرون عليها، وإذا بينت للواحد منهم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: "{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}"، فإذا قلت له: (طيب، أطع الله والرسول، هذا أمر الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وهذه الآية التي تستدل بها يقول الله فيها: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}، ولم يقل ردوه إلى أولى الأمر).
إذا بينت له هذا قال لك: "الذنب على الدولة"، فإذا قلت له: (كلا، فجنود فرعون هلكوا مع فرعون، كما قال الله: {فنبذناه وجنوده في اليم}، وقال: {يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود})، إذا أجبته بهذا وقطعت حجته؛ ظهر لك الخافي منه - وهو ضعف الإيمان وضعف الخوف من الله عز وجل - فيقول: "كلامك صحيح، ولكن هذا النظام، وايش نسوي، ما نقدر نخالف النظام)، ولكن يخاف من مخالفة النظام، فإلى الله المشتكى؛ كيف يخاف من مخالفة النظام ولا يخاف من مخالفة أمر الله عز وجل؟! قال الله تعالى: {أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه أن كنتم مؤمنين}.
والحديث التاسع؛ فيه وصف ينطبق على الناس والحكام في هذا الزمان، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (ثم تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون)، فهذا وصف أهل هذا الزمان إلا من هداه الله، ممن يأخذون بالسنة ويتقيدون بالأمر، كما هو وصف حواري وأصحاب الأنبياء.
والموقف الذي يحب اتخاذه معهم؛ هو مجاهدتهم على تغيير هذين المنكرين العظيمين - وهما القول بلا فعل، والفعل على غير أمر وسنة - مجاهدة باليد واللسان والقلب، كما جاء في حديث تغيير المنكر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) [رواه مسلم]، وفي هذا الحديث قال: (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).
والواقع الذي لا ينكر؛ انك إذا سألت الواحد من هؤلاء الناس ما دليلك على هذا الفعل؟ وهل عندك عليه أمر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ احتج عليك بالحجج المختلفة، مثل: "كل الناس على هذا"، أو "هكذا يفعل الشيخ فلان"، وأكبر حجته أن يقول: "الشيخ افتاني بهذا".
وخلاصة حججه هذه كلها على اختلافها؛ أن يبرر موقفه، حيث فعل بلا أمر، والقول بلا فعل؛ يتجلى لك في كثير من الأمور، ومن أهمها قول الكثير من الناس؛ نحن نغير المنكر، ونحن نتبع السنة، ونحن لا نرد الحق، ونحن لا نطيع الحكومة في معصية الله، وغير ذلك، فإذا نظرت إلى حقيقة أقوالهم؛ وجدتهم يقولون ما لا يفعلون.
وفي الحديث الأخير؛ ترى كيف ينطبق هذا الوصف على كثير من الأمراء، وهو انهم يقولون ويتكلمون بالباطل، ولا يستطيع أحد أن يرد عليهم لخوفهم وهيبتهم والرهبة منهم، فأولئك يتهافتون في النار، جزاء وفاقا، نسأل الله العافيه.
كما نخاف على من يعمل في الشرطة اليوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر الزمان شرطة، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله) [رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح].
هذا، ولكي تزداد بصيرة بالواقع الذي تعيش فيه تأمل في هذين الحديثين، وهما:
1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وأن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها، وسيصيب أخرها بلا وأمور تنكرونها، وتجئ الفتنة فيرقق بعضها بعضاً، وتجئ الفتنة فيقول المؤمن؛ هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجئ الفتنة، فيقول المؤمن؛ هذه، هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليات إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر) [رواه مسلم].
2) عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا) [رواه مسلم].
وقارنهما بما جاء في الحديث الرابع الذي تقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمه، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فسطاطين؛ فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده) [رواه أبو داود وهو حديث صحيح].
فإذا تأملت وجدت قوله: (سيصيب أخرها بلاء وأمور تنكرونها)، كقوله: (فتنا كقطع الليل المظلم)، كقوله: (فتنة الدهيماء)، لأن الدهيماء فيها معنى الظلمة وعدم الوضوح كظلام الليل، وهذه الفتن هي البلاء والأمور التي تنكر، ثم فصلها فقال: (تجئ فتنة فيرقق بعضها بعضا)، أي يُبسط بعضها بعضا، كل ما جاءت الفتنة الأعظم قالوا: "التي قبلها أبسط منها وأرق منها"، وهذا المعنى موجود في قوله: (فإذا قيل انقضت؛ تمادت)، أي انها تتمادى كلما رجى الناس انها تنقضي؛ تزيد، فيرقق ويبسط أخرها أولها، ولا ينقضي هم أولها حتى تزيد، وهذا هو الذي يجعل المؤمن يخاف أن يفتن في دينه فإذا جاءت الفتنة ووردت قال؛ "هذا مهلكتي"، فإذا انكشفت وجاءت التي بعدها قال: (هذه، هذه).
ثم قوله: (لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمه)، يشهد له قوله: (فيقول المؤمن؛ هذه مهلكتي)، أي أنها لا تترك أحداً إلا لطمته، إذ حتى المؤمن أصابه من وهجها وفتنتها حتى خاف الهلاك.
ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة؛ أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، خوفاً أن يكفر، لأنه وصف هذه الحالة في الحديث الآخر؛ بانه يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، وفي الحديث الآخر؛ بأن الفتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، ثم ذكر أن نهايتها انقسام الناس إلى فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، مما يدل على أن هذه الفتن إنما ينقسم الناس فيها إلى النفاق - الذي هو كفر في الحقيقة وإسلام في الظاهر - وهذا كما نرى الناس واقعين في مقدماته اليوم، فالذي يترك دينه منهم ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً؛ إنما يلجأ إلى النفاق ليعيش به بين الناس الذين يجد النفاق له فيهم مجالاً، لكثرة الفتن التي أحاطت بهم، حتى لا يميز الكثير منهم بين الطيب والخبيث، كما نرى الكثير من أعداء الحق يعيشون بين المسلمين اليوم بالنفاق الذي يرضي به جميع من حوله، وبان لك أن سبب هذا هو الدنيا فيبيع المؤمن دينه بعرض من الدنيا، وهذا الذي يخشاه المؤمن من انفتاح الدنيا اليوم وغرق الناس فيها.
حتى تجد الكثير منهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال، أمن حلال أم حرام؟) [رواه البخاري].
وأوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتي إليك، لأن الدنيا قد وصلت بهم إلى أن يترك المرء دينه من أجلها، ولكثرة التلبيس في هذه الفتن فمن عرف طريق حق فليُرشد إليه، فإنها كقطع الليل المظلم.
ثم عليك يا أخي بالوصايا التي في الحديثين الماضيين، ألا وهي:
1) المبادرة بالأعمال.
2) لزوم الإيمان بالله واليوم الآخر حتى تأتيك المنية.
3) أن يأتي المؤمن إلى الناس الذي يجب أن يأتوا إليه.
4) الحذر من الدنيا وفتنتها.
5) طاعة الإمام الذي يعطيه صفقة يده وثمرة قلبه.
6) قتل من ينازعه.
واذا تأملت؛ وجدت أكثر مداخل الشيطان على الناس في هذا الزمان هو في التفريط في هذه الوصايا، فيشغلهم عن المبادرة بالأعمال بالتسويف، وكذلك قل أن تجد من الناس من يأتي إليهم الذي يحب أن يُؤتى إليه، حتى ممن يدعون إلى الحق والخير؛ تجد بعضهم يحاول إبطال ما عند الآخر والتحذير منه - إلا من سلم من الجهل ومن هوى النفس وقليل ما هم - وتجد كيف أكب الناس على الدنيا حتى ألهتهم عن كثير من أوامر الله عز وجل، بل باعوا دينهم وإيمانهم بعرض من الدنيا، حتى ذهب ضحيتها وضحية الفتن المظلمة أفواج وفئام من الناس إلى الكفر بين عشية وضحاها، بأسباب الأئمة المضلين الذين يقتحمون بهذه الأفواج في مهاوي الكفر بين صباح ومساء، بعد أن كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
الخلاصة مما تقدم ومجمل ما نعتقده في حكام المسلمين:
وبعد هذا كله، والذي نعتقده في حكام المسلمين اليوم، والذي يظهر من الأدلة المتقدمة؛ أن هؤلاء الحكام ينطبق على كثير منهم ما ذكره ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي في الفصل قبل هذا، وأنهم ليس لهم على المسلمين بيعة ولا يجب عليهم لهم طاعة، ومع ذلك لا يلزم من هذا كله تكفيرهم، بل من أظهر منهم الإسلام حكمنا له به، حتى تثبت عنه فنحكم عليه بالكفر، مع اعتقادنا أن بقائهم اليوم؛ هدم لدين الله عز وجل ولو كانوا يدعون الإسلام، نسأل الله أن يريحنا منهم أجمعين.
أقول هذا، مع شدة بغضنا لمن شد على أعضادهم من أهل العلم خاصة، ونعتقد أنهم سبب الشر للحاكم والمحكوم، لأنها لا تجتمع ولا تتفق طائفة حق وطائفة باطل يسيرون صفاً واحداً، ولا يعمل أحدهما على إزالة الأخرى إلا بوجود من يجمع بينهما، وذلك بمداهنة من فوقه والتلبيس على من تحته، فإن أراد شخص أن ينصح المحكوم قالوا: "ما أنت بأعلم من الشيخ فلان [صاحب] المنصب الفلاني"، وأن أراد أن ينصح الحاكم قالوا: "عندنا من هو أعلم منك"، وعلى هذا استقام حكم أكثر الدول.
وامتازت دولتنا بقسط وافر من هذا التلبيس - منها ومن علمائها - والتي تسمي نفسها اليوم بـ "دولة التوحيد"، وإنما وحدت بين صفوف المسلمين والنصارى والمشركين، وأقرت كلا على دينه - كالروافض - وحاربت من خالف ذلك، وقاتلت من قاتل المشركين الذين يدعون عليا والحسين، وقد حاربت كذلك عبادة القبور والقباب وأرست قواعد عبادة الريال.
وقد جاء في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمصية، تعس عبد الخميلة، أن أعطى رضى، وأن لم يعط سخط...) [رواه البخاري].
وبسبب عبادة المال يكفر الرجل بعد إيمانه، كما تقدم لك في حديث: (يبيع دينه بعرض من الدنيا).
ولم تستطع هذه الدولة أن تفعل ما تفعله من التلبيس والتدليس إلا لأن رعيتهم ومن هم في قبضة أيديهم كأرنب دفعت عليها [الكلاب] لأصطيادها وقتلها، ومن كانت هذه صفته فهو يستحق ما يناله، ولذلك تجد المغرورين من هذه الرعية؛ رؤساء في الدنيا، أتباعاً في الدين لكل ناعق.
وتجد حكمهم وسلطانهم؛ قائماً على ثلاث قواعد من حيث معاملة أهل العلم والدين.
- إن وافقتهم وسكت عن باطلهم؛ قربوك واتخذوك حجة على من خالفهم.
- وان سكت عنهم؛ سكتوا عنك، وربما زاروك وأرسلوا لك الهدايا، وذكروا في حقك هذا الحديث: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) [رواه البخاري]، وهي كلمة حق أريد بها سكوت عن باطل.
- وإن خالفتهم؛ قتلوك بشبهة يسكتون بها الأرنب، فيقولون؛ "هو خارجي"، مع أن أرنبهم لا تعرف معنى "الخارجي".
وأقرب مثال وأوضحه؛ مؤسس دولتهم الملك عبد العزيز والمشايخ الذين كانوا معه في سلطانه، وهم ما بين موافق له ومعزز له بما يشاء، وآخر ساكت عن باطله، وآخر التبس عليه الأمر، فقد دعا "الأخوان" رحمهم الله الذين هاجروا في القرى المختلفة هجرة لله عز وجل، دعاهم إلى بيعته على الكتاب والسنة، فكانوا يجاهدون ويفتحون البلاد، ويرسلون له بما للإمام من الغنائم والخمس والفيء ونحو ذلك، على أنه إمام المسلمين، ثم لما استقر سلطانه وحصل مقصوده؛ وآلى النصارى، ومنع مواصلة الجهاد في سبيل الله خارج الجزيرة، فلما خرجوا لقتال المشركين في العراق الذين يدعون علياً وفاطمة والحسن مع الله؛ لقبهم هو ومشايخ الجهل الذين معه، لقبوهم باسم يكرهه أهل الإسلام، وهو "الخوارج".
وقد تقدم لك أن هذه التسميه لا أصل لها في الشرع في اطلاقها على الذي يخرج على الإمام، مع أن الأخوان رحمهم الله لم يخرجوا عليه ولم يخلعوا يداً من طاعة، وإنما لم يطيعوه حينما نهاهم عن الجهاد.
وهذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [متفق عليه].
وقوله: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) [رواه أحمد، وهو حديث صحيح].
فتبين لك ضلالهم في حكمهم على من خالفهم انه خارجي، ولكنهم يلبسون على عوام المسلمين الذين لا يتبصرون في دينهم، ويجدون من مشايخ الضلال من يعطيهم الفتاوى بلا تورع ولا تقوى، وليس لنا مراد في الخوض في الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا.
ولكن لأمرين:
- الأمر الأول:
دفع الشبهة عن أخواننا الذين جاهدوا في سبيل الله وكانوا صادقين مع الله، ثم مع ذلك تلبسهم هذه الدولة وعلماء السوء؛ لباس الخوارج المارقين مع دين الإسلام، حتى إنك لتجد اليوم من أهل الخير الملتبس عليه أمرهم من لا يترحم عليهم - سبحانك هذا بهتان عظيم - وإنما هم رحمهم الله - كما أشرنا لك إلى طرف من أخبارهم - ولكن إن أردت المزيد من أخبارهم والتثبت في ذلك؛ فستجد اليوم من هو على قيد الحياة من إخوانهم الذين جاهدوا معهم، ويعرفون حقيقتهم، حتى لا تغتر بثناء الحكام على أنفسهم وتشنيعهم على من خالفهم، ولا غرابة في ذلك من أهل مُلك يريدون تثبيت ملكهم، وإنما الغرابة ممن يدعى الصلاح والخير ثم يتهم المؤمنين بما هم منه أبرياء.
وبعدما لقبهم بـ "الخوارج"، حمل إخوانهم الذين لم يخرجوا معهم عن قتالهم، فخرج بهم على طريقهم وبدأهم بالقتال، فلما التقوا في ساحة القتال؛ حمل كل من الفريقين على الآخر وكل منهم ينتخي ويقول: (صبي التوحيد، وأنا اخو من طاع الله)، فيالها من مصيبة دامية، وقبل ذلك أرسل للشريف حسين بكتاب يقول فيه: (حسين يا خوي، أنت في نحورهم وأنا في ظهورهم).
فلما قتلهم وشتتهم واستقر سلطانه الجبري؛ والى النصارى وعطل الجهاد في سبيل الله، وانفتح من الشر أبواب مغلقة، ثم واصل السير على نهجه أبناؤه من بعده، حتى وصلت بلاد المسلمين إلى ما وصلت إليه اليوم من الشر والفساد، فنقول الآن؛ أين الحكم بالكتاب والسنة الذي أدعوا الحكم به أول ملكهم ويدعيه كل من تجددت له بيعة منهم؟! أم أن الأمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمه في الفصل قبل هذا؟
وإن طالت بك حياة؛ لتجدن الولد يشابه أباه ويشعلون الحروب بين المسلمين ويُسيرون بعضهم على بعض.
- الأمر الثاني:
حملنا على الكلام في تاريخ هذه الدولة مع أهل الحق الصادقين وتلقيبهم بالخوارج تلبيساً على العوام الجهال؛ أنه لا يزال إلى اليوم من هو على هذه الضلالة من مشايخ الجهل والضلال، ويعتقدون أن "الأخوان" الماضيين؛ خوارج ويسمون، من يدعو إلى الحق الذي جاء في الكتاب والسنة اليوم؛ خوارج، ويُفتنون بقتله، ولو شئنا لذكرنا أسماء هؤلاء المشايخ، ولكن عسى الله أن يبصرنا وإياهم في الحق الثابت بالكتاب والسنة، وإلا وجب علينا التحذير منهم وذكر أسمائهم ليحذرهم المسلمون.
أعود فأقول: هذه القواعد الثلاث هي التي يتخذونها مع أهل العلم والدين - وهي أن توافقهم، أو تسكت عنهم، أو يقتلونك -
وهذه هي الأسباب التي حملتني على ألا أواجههم وأبين لهم الحق، لأني عرفت ما عندهم في من خالفهم، وأنهم لا يحبون الناصحين بل يقتلونهم، وأنا لا أريد قربهم ولا أريد السكوت عنهم وعن الحق، فلم يبق إلا الثالثة.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في الصحيحين -: (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين).
فنحن نعرف ما فعلوا فيمن قبلنا ممن خالفهم من أهل الحق، فقد قتلوهم بالشبه المتقدمة.
ولنا في إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة فإنه لما القوه في النار ونجاه الله منها لم يعد إليهم مرة ثانية لأنه علم ما عندهم، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما عزم الكفار على قتله - كما في حديث سراقة في البخاري - لم ينتظر حتى يفعل به مثل ما فعل بإبراهيم فيُلقى في النار، وقد ذكر الله في القرآن أنه أرسل رسولاً ثالثاً مع الأثنين لتعزيزهما وتصديقهما، فلما قتلوا الرجل الذي أسلم؛ أرسل الله عليهم صيحة فأهلكهم، كما في سورة يس، قال تعالى: {واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث...}، إلى قوله: {وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين * إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون}.
فهذا هو الذي شرعه الله لنا - كما ترى في هذه الأدلة - فافهم ولا تنخدع بحملة الفقه وبمن ياخذ بجانب واحد من الكتاب والسنة ويقول هذا من الجبن والخوف والذل، مع انك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار لما عزموا على قتله، ولكن المصيبة هي الجهل بالسنة.
ولا تنخدع بعناوين الكتب العصرية، كقولهم: "كيف تدعو؟!"، وكان الأولى أن يقول: "كيف نعيش"!، وقد ذكرت الرد عليه في "التعليق على الحسنة والسيئة"، فنحن قد علمنا الله كيف ندعو، وهو أن ندعو على بصيرة - وهي العمل بكل ما جاء في الكتاب والسنة - بخلاف من يبحث في الكتاب والسنة عن حجة تفسح له المجال للعيش بين أهل الباطل والسكوت عن باطلهم، ويدندن بهذه الحجج على أتباعه ويسميها بـ "الحكمة".
وإنما الحكمة؛ العمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، قال الله تعالى: {ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة}، وقال تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن أتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين}.
ولذلك فالسلامة مع هؤلاء الحكام الذين يقولون بغير علم، ويعملون بغير بصيرة؛ هو الابتعاد عنهم، وإذا سُئل عن شيء من الدين أجاب بالقول الصحيح، ولا يعينهم على الباطل أو يسكت عنه فيشد على أعضادهم، كمن يخادعون الله ويخدعون أنفسهم، ويقولون: {لكم دينكم ولي دين}، فإن هذا في حق الكفار الذين أمرك الله أن تُبدي العداوة لهم وتبشرهم بالنار وتناديهم باسم "الكفار"، كما أمر الله نبيه في أول هذه السورة، فقال: {قل يا أيها الكافرون}.
أما هؤلاء الذين تعمل عندهم؛ فهم يظهرون الإسلام، وقد أمرك الله مفارقتهم بعملك، كما في الحديث: (وزايلوهم بأعمالكم)، أي فارقوهم، لا أن تكون أعمالكم واحدة وأعمالهم واحده، اذ أنهم لا بد أن يخضعوا كل عمل - ولو كان عمل خير - لمنهجهم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: (يطفئون السنة) و (يعملون بالبدعة).
وهذا مشاهد اليوم لمن رزقه الله البصيرة، فتجدهم يُظهرون الدين في ثوب المذلة والمهانة والاستهزاء والبدع، كما ترى في وزارة الحج والأوقاف ودار الأفتاء وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الأعلام بجميع وسائلها ونحو ذلك.
فهذا هو المنهج الحق؛ وهو بيان الحق وإنكار المنكر، وعدم الشد على أعضادهم، فإنهم على أقل الأحوال لا يبالون بنصح ولا ناصح.
فخير من ينكر عليهم اليوم هو الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ولكنه مستمر في الإنكار وهم مستمرون في المنكر، وهكذا فهم يقلبون السفينة في الموج لتغرق، وهو متعلق فيها ينادي بالنجاة، والسفينة لا تزداد إلا اضطراباً، فعسى الله ينجينا وإياه قبل أن تغرق السفينة، وإلا فما نرى لأصحابها همة في النجاة بها لأنهم يزيدون كل يوم تعمقاً بها في غياهب الأمواج وعازمون على الغرق، نسأل الله العافية.
مع أن مخالطة الناس لا بد فيها من إنكار المنكر، فإن سكت وأنت تستطيع أن تنكر بلسانك؛ فسكوتك منكر لا يجوز لك، وهذا يستلزم منك عدم حضور المنكر لئلا تراه وتسكت عنه فتقع في منكر وهو السكوت، ومن هنا تعرف أن من لا يُنكر؛ لا يجوز له حضور المنكر، بل يجب عليه مفارقته لئلا يقع بنفسه في المنكر.
كل هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان) [رواه مسلم].
ومن المعلوم أنه لن يلجئك إلى القلب إلا أمر لا يطاق معه الكلام، كالاستضعاف، ومع الاستضعاف لا يجوز لك البقاء عند المنكر فتظلم نفسك بالسكوت عنه، إلا أن كنت لا تستطيع المفارقة، لأن الله لم يعذر من المستضعفين إلا من لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، قال الله تعالى: {إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً}.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يأتي على الناس زمان؛ خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن) [رواه البخاري].
وأعلم أن هذا القول هو الذي كنت أقول به من قبل، ويعكسه بعض من الناس، فيقول؛ هو يحرم الوظائف، فعفا الله عنا وعنهم، ونرجوا أن تكون عاقبتنا وإياهم؛ عاقبة ليوسف واخوته، فإن الشيطان نزغ بينهم فكان منهم من قال؛ اقتلوه، ومنهم من قال؛ اطرحوه في الجب، وكذلك قالوا، فمنهم من قال في شأني وشأن "الأخوان"؛ اقتلوهم فإنهم خوارج وأن لمن قتلهم أجرا عند الله تعالى! ومنهم من قال؛ اسجنوهم فإنهم متمردون! وغير ذلك مما هو معلوم.
فهذه نزغات الشيطان بين المؤمنين، كما قال تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً}، فنعوذ بالله من نزغاته.
وأما مسألة التكفير؛ فهي مسألة خطيرة، وأكثر من يخوض فيها ممن لاحظ له من العلم والتجرد إلا القليل، فهو يجعل الحكام الذين يظهرون الإسلام كفرعون والدجال، والآخرون على النقيض من ذلك تماماً، فهم يجعلون هؤلاء الحكام كابي بكر وعمر رضي الله عنهما في وجوب بيعتهم وطاعتهم، وقد تبين لك انه لا يلزم من بطلان البيعة وعدم وجوب الطاعة؛ تكفيرهم، وهم يظهرون الإسلام، فعسى أن يكون قد تبين لك الحق مما قدمناه.
واعلم أن هذه الاختلافات قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، ويبقى حثالة من الناس قد مزجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، وكانوا هكذا) - وشبك بين أصابعه – قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتُقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم).
ففي هذا الحديث؛ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف، وبين لنا المخرج؛ وهو أن أخذ ما نعرف وندع ما ننكر، وكيف ذلك؟ لا بد من أن نزن الأمور بميزان الشرع، بخلاف منهاج الذين لا يحرصون على الدليل في ما يأتون وما يذرون وما يعرفون وما ينكرون، ثم تقبل على أمر خاصة نفسك؛ فتقيمها، ثم تشتغل بأمر الخاصة - أي الأفراد الذين تستطيع أن تقيمهم معك - وتدع أمر العامة، فانما هم في ملك جبري يلبسون الأمور ويظهرون الإسلام ويرفعون رايته، وهم في الداخل يهدمونه ويحاربون أهله، فلا قدرة لك على قتالهم ولا في يدك شيء من الأمور تتصرف فيه كيف نشاء، بل أدنى أعمالهم لا بد أن تسير فيه على ما يرضيهم، لا يطلقون لك التصرف في شيء البتة.
وبهذا تعرف بطلان قول من يقول: نأخذ المناصب لنخدم بها الإسلام ونصلح الناس، ويغالون في ذلك، فيقول بعضهم لبعض أخواننا حينما ترك الدراسة والوظيفة: (هذا من التولي يوم الزحف)! فإلي الله المشتكي إذا كانت هذه مقالة من ينتسب إلى العلم والصلاح، وإنما هذا من فرط الجهل وضعف البصيرة وقلة العلم:
فيا محنة الإسلام من كل جاهل ويا قلة الأنصار من كل عالم
ولكن الكثير من الناس عكس الأمر، فاشتغل بأمر العامة، وهو في خاصة نفسه لا يبني عبادته على علم ثابت صحيح بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا من تلبيس إبليس.
حيث تجد هذا الرجل نفسه في أمر العامة يقضي جميع أوقاته، فيقول؛ هؤلاء فعلوا واحدثوا، وفي المكان الفلاني فساد، وفي المجلة الفلانية مقال كذا، وفي وزارة كذا أمر بكذا ونهى عن كذا، ويشتغل بتعداد المنكرات التي تنشرها الحكومة، ثم أحياناً يقول؛ هؤلاء كفار، وإن كان يعمل عندهم قال؛ لا هم مسلمون ويريدون الصلاح ولكن الفساد من المسيءولين، ويجب على الحكومة أن تفعل كذا، ولا بد أن يكون كذا و ... و ... و ... وهلم جرا من ضياع الأوقات والتلاوم.
مع أنه يدري أن القوم عازمون على ما هم عليه، وأنهم يمكنون باطلهم بالسيف ولو كان المخالف لهم أقرب قريب، ولكنه يشغله الشيطان هكذا.
وفي نفس الوقت تجده في أحواله مقصراً قصوراً كبيراً، فلا يتعلم دينه، العلم الثابت الصحيح، وبيته مليء بالصور، لا يطمسها، ويخالط الناس، لا ينكر المنكر إذا رآه، والقران مقصر فيه، لا يتلوه، وإن تلاه لا يتدبره ولا يتفقه فيه، ولو فعل هذا وأشتغل به وترك أمر العامة لكان خيراً له، بل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلامه وحي يوحى من عند رب العالمين الذي يعلم بنا وبهذا الزمان؛ (تأخذون ماتعرفون)، و (تدعون ما تنكرون)، و (تقبلون على أمر خاصتكم)، و (تذرون أمر عامتكم).
وقد يستشكل بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس في عنقه بيعه)!
والجواب: أن هذا فيما إذا بايع المسلمون كلهم إماماً، فمن فارق جماعتهم ولم يبايع؛ مات ميتة جاهلية، أما إذا لم يكن لهم إمام؛ فلا ينطبق هذا الوعيد.
يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد حذيفة عند عدم وجود الجماعة والإمام؛ بأن يعتزل، فهل ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد حذيفة إلى أن يموت ميتة جاهلية؟! كلا.
وبهذا تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبايعة إمام قبل أن يقوم بالدعوة والبيان، وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع الأنصار إلا بعد أن صدع بالحق وبين.
وقد يشكل على بعض الناس حديث: (سيكون من بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس)، قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله أن أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع).
والجواب:
أن هذا الحديث قد رواه مسلم، ولكن فيه انقطاع، لأنه من رواية أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي عن حذيفة، وهو لم يسمع من حذيفة، فحديثه عنه مرسل.
قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" [ج10/ص296]: (وأرسل عن حذيفة وأبي ذر وغيرهما).
ورقم الحديث في صحيح مسلم: 1476.
قال محمد فؤاد عبد الباقي في التعليق: (لم يسمع من حذيفة - قاله الدارقطني -).
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": (أنه مرسل، وأن المتن صحيح لوروده من الطريق الأولى).
قلت أن هذه الزيادة: (سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين... الخ)؛ ضعيفة لأنها ليس لها ما يعضدها ويشهد لها ويقويها، وهي طرف من حديث طويل، فأول الحديث رواه البخاري من طريق صحيح، وهذه الزيادة في آخره لم تأت من طريق صحيح، وإنما من هذه الطريق التي فيها انقطاع، فهي ضعيفة.
وبهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لأنه غير صحيح.
وأعلم إننا كنا نعتقد صحته، فأستدللنا به في الرسالة الصغيرة "نصيحة الاخوان إلى المسلمين والحكام"، لأننا وجدناه رواه مسلم، وبنينا على ذلك وجوب طاعتهم على من بايعهم، ولكن اليوم حينما تبين لنا ضعفه بالبرهان؛ وجب علينا الرجوع إلى الحق، لأن الحق أحق إن يتبع.
ونحن نعلم أن أهل الشبه وأهل الأهواء؛ سيقولون: هؤلاء يصححون الأحاديث ويضعونها على ما يوافق هواهم!
فنقول: أننا والله نعلم أن لنا بين يدي الله عز وجل موقفاً يسألنا فيه عن أعمالنا، ويحاسبنا عليها، ولكن نسأل الله أن كان لنا هوى أو مقصدنا لغير وجهه الكريم؛ أن يخزينا ويبين باطلنا على رؤوس الأشهاد وأن يفسد مساعينا ولا يسددها، وإن كنا على الحق متبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نبتغي بذلك وجهه؛ أن يزيد أهل الحق بنا ثقة ومحبة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وقد يستدل بعض الناس على طاعة هؤلاء الحكام بحديث: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم)، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآءه يأتي شيئاً من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة).
والجواب:
أن هذا الحديث رواه مسلم أيضاً، وقد ذكرناه في الرسالة الصغيرة "نصيحة الاخوان"، وفي سنده مسلم بن قرظة، وفيه كلام من حيث هل هو ثقة أم لا.
وعلى فرض صحته، فليس لهؤلاء الحكام فيه حجة، لأنه يقول: (أئمتكم)، يعني أئمة المسلمين، فهؤلاء الحكام ليسوا أئمة، لأن إمامتهم للمسلمين باطلة ومنكر يجب إنكاره - كما تقدم ذلك بالأدلة - لأنهم ليسوا من قريش ولا يقيمون الدين ولم يجتمع عليهم المسلمون، وإنما أصحاب ملك سخروا المسلمين لمصالحهم، بل جعلوا الدين وسيلة لتحقيق مصالحهم الدنيوية، فعطلوا الجهاد، ووالوا النصارى، وجلبوا على المسلمين كل شر وفساد.
ونسأل الله أن يريح المسلمين منهم، ويجعل لهم من لدنه ولياً، ويجعل لهم من لدنه نصيراً.
والحمد لله رب العالمين"
















